تُعَدّ الدراسات الإسلامية اليوم مجالًا معرفيًا بالغ الأهمية، لكنه يعاني من تحديات منهجية ومعرفية تحول دون اندماجه الفعلي في الحقول الفكرية الحديثة. فمنذ نشأته، ارتبط هذا المجال بالتفسير الفقهي واللاهوتي للنصوص الدينية، متجهًا إلى حفظها وتأويلها ضمن منظومة تأصيلية تقليدية. لكن مع تحولات العصر الحديث وظهور مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية، وجد هذا الحقل نفسه أمام ضرورة إعادة النظر في مناهجه وآلياته حتى يواكب المتغيرات الفكرية والمعرفية العالمية. هذه الإشكالات دفعت العديد من المفكرين إلى دراسة واقع الدراسات الإسلامية ونقد المسارات التي اتخذتها، ومن بين هؤلاء المفكر الكبير رضوان السيد، الذي قدّم تحليلًا نقديًا مهمًا لطبيعة الأزمات التي تعاني منها هذه الدراسات، سواء داخل الجامعات الإسلامية أو في الأوساط الأكاديمية الغربية.
يرى السيد أن أزمة الدراسات الإسلامية تتجلى في ثلاث إشكالات رئيسة تحدّ من تطورها وتمنعها من مواكبة التحولات الفكرية الكبرى. الإشكالية الأولى تتعلق بضعف التخصص والإتقان، حيث يشير إلى أن الباحثين العرب والمسلمين في الجامعات الغربية لم يتمكنوا بعد من تحقيق مستوى عالٍ من التميز العلمي يمكّنهم من إعادة صياغة الدراسات الإسلامية ضمن أطر معرفية حديثة. ويرجع ذلك إلى سيطرة أنماط بحثية تقليدية تحدّ من قدرة الباحثين على تجاوز المناهج الكلاسيكية وإنتاج معرفة نقدية مستقلة. الإشكالية الثانية تتعلق بالمرجعية الغربية في العلوم الإنسانية، إذ أصبحت الدراسات الإسلامية في الجامعات الغربية خاضعة لمقاربات أنثروبولوجية وسوسيولوجية تتعامل مع الإسلام بوصفه ظاهرة اجتماعية مشروطة بسياقاتها التاريخية، مما يحول دون تقديم رؤية متكاملة للإسلام كمنظومة فكرية ومعرفية. أما في الجامعات الإسلامية، فالمشكلة تكمن في هيمنة الخطاب العقائدي الدفاعي، الذي يجعل هذه الدراسات أسيرة مقاربات تبريرية تُضعف من قدرتها على التفاعل النقدي مع التطورات الفكرية المعاصرة. الإشكالية الثالثة تتعلق بالوعي بالتطورات الدينية والحضارية للإسلام، حيث تحتاج هذه الدراسات إلى تجاوز الثنائية التقليدية بين التأصيل الدوغمائي والتفكيك الاستشراقي، والانتقال إلى مشروع تأويلي أوسع يستوعب تحولات الفكر الإنساني.
غير أن هذه الإشكالات المنهجية لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى أزمة أكثر عمقًا تتعلق بمنهج البحث نفسه. إن واحدة من أبرز المشكلات التي تعاني منها الدراسات الإسلامية اليوم هي غياب الجهود الاستقصائية الشاملة، حيث تفتقر غالبية الأبحاث إلى استقراء كلي للتراث الإسلامي، مما يؤدي إلى استخلاص نتائج جزئية لا تعكس حقيقة هذا الحقل بكامل أبعاده. وقد أشار نصر عارف إلى هذه الإشكالية في دراسته للتراث السياسي الإسلامي، حيث بيّن أن معظم الدراسات الحديثة لم تتجاوز نسبة 15% من المصادر المتاحة، مما يعني أن الأحكام الصادرة عنها تظل قاصرة عن تقديم رؤية متكاملة. فإذا كان هذا هو حال البحث في مجال الفكر السياسي الإسلامي، فإنه ينطبق أيضًا على الدراسات الإسلامية بشكل عام، حيث لا يزال التعميم قبل الاستقراء يمثل عائقًا رئيسًا أمام بناء معرفة رصينة تستند إلى تحليل شامل للمصادر والنصوص المؤسسة.
أمام هذه التحديات، يصبح من الضروري إعادة هيكلة الدراسات الإسلامية بحيث لا تبقى محصورة في العلوم الشرعية فقط، بل تمتد إلى مجالات أوسع تشمل الفكر والفلسفة والاجتماع والاقتصاد، مما يمكنها من تقديم رؤية أكثر شمولًا تتفاعل مع النقاشات الفكرية العالمية. إن مستقبل هذا المجال مرهون بقدرته على تجاوز القطيعة بين العلوم الإسلامية والعلوم الإنسانية، بحيث لا يُنظر إلى الإسلام فقط من خلال عدسة الفقه والتفسير، بل أيضًا بوصفه إطارًا حضاريًا قادرًا على تقديم رؤية متجددة حول قضايا الإنسان والمجتمع. كما ينبغي إعادة النظر في المناهج التدريسية، بحيث لا تبقى الدراسات الإسلامية أسيرة المقاربات التقليدية، بل تنفتح على مناهج بحثية جديدة تسهم في تطوير أدوات التحليل والتأويل، وتمنح هذا المجال القدرة على مواجهة التحديات المعرفية الراهنة.
إضافة إلى ذلك، ينبغي أن تخرج الدراسات الإسلامية من أزمتها الداخلية وتنفتح على القضايا الحية التي تواجه المسلمين في العصر الحديث. فبدلًا من أن تقتصر على إعادة إنتاج الخطاب الفقهي أو اللاهوتي، ينبغي أن تتجه إلى تحليل الظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية التي تؤثر في العالم الإسلامي، مع استشراف الحلول الممكنة لهذه التحديات. إن تجديد الدراسات الإسلامية لا ينبغي أن يكون مجرد مشروع أكاديمي معزول، بل يجب أن يكون جزءًا من إعادة التفكير في دور الإسلام في السياق العالمي، وفي كيفية تفاعله مع قيم الحداثة والتحولات الكبرى في الفكر الإنساني.
إذا لم تتحرر الدراسات الإسلامية من ثنائية التأصيل الجامد والتأويل الخارجي المسقط، فستظل عاجزة عن تقديم معرفة تتجاوز المقولات المسبقة عن الإسلام، سواء تلك التي تنتجها المؤسسات الدينية التقليدية، أو تلك التي تكرسها الجامعات الغربية من منظور استشراقي حديث. المطلوب اليوم ليس إعادة إنتاج خطاب دفاعي يبرر وجود الإسلام، ولا خطابًا نقديًا مفصولًا عن بنيته الفكرية، بل مقاربة علمية تعيد قراءة الإسلام في ضوء تحولات العصر. التحدي لا يكمن فقط في فهم الإسلام، بل في بناء خطاب معرفي قادر على تقديم رؤية تستوعب التعقيدات الفكرية والواقعية، وتسهم في تطوير الحقول المعرفية بحيث لا تبقى الدراسات الإسلامية هامشية في سياق المعرفة العالمية، بل تصبح فاعلًا فيها يساهم في إنتاج معرفة تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي اليوم.






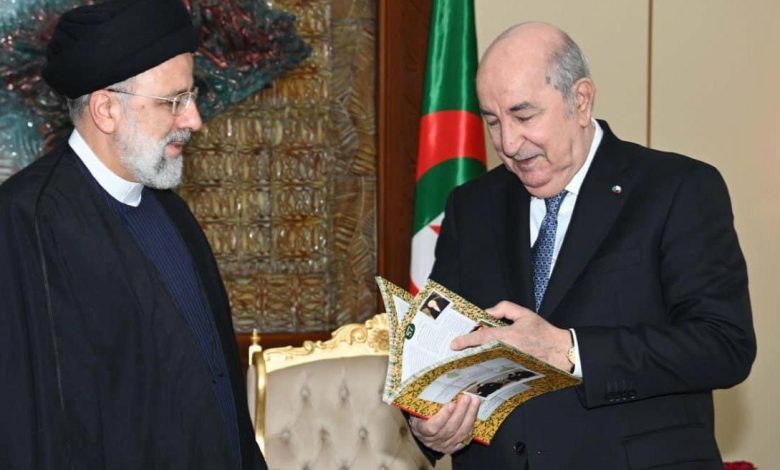







تعليقات الزوار ( 0 )