الذي يبحث عن الحقيقة في صناديق تجار الأوبئة لا يمكنُ أن يجد إلاّ الوهم، والذي يبحث عنها عند المثقفين القابعين في سراديبهم فلن يجد إلاّ الفراغ، والذي يبحث عنها في شوارع المدينة وأماكنها العمومية فلن يجد إلاّ الموت؛ تجار الأوبئة والكوارث والمهالك الاجتماعية موسميون لهم قنواتهم الخاصة في زراعة الرعب والخوف والوسواس القهري في نفوس الناس، فلا يجد هؤلاء طريقاً من أجل حماية أنفسهم في أوقات الأزمات (الصحية) غير مزيد من تشجيع تفاهة النهم والتبضع وكأن هذه العملية -في إغراء شديد للشهوات- لها أهلها من المتربحين والمضاربين والخاسر الأكبر هو الفقير الذي لا يجد قوت يومه، وفئات كثيرة تعيش على ما تربحه بشكل يومي، واليوم الذي لا تشتغل فيه فهذا اليوم عندها يوم صيام، أو بلغة أخرى يفهما جيداً تجار الأوبئة ‘يوم جوع’.
أما المثقفون فإني لم أكن أنتظر منهم أية محاولة في محاربة الوباء، ليس لأنهم يفتقدون بشكل كليّ إلى الآليات أو لنقل الأدوات التي سيحاربون بها عدواً خفياً مثل فيروس كورونا المستجد فقط، لأننا في الحرب نكون في مسيس الحاجة إلى الأدوات والأسلحة الكافية للدفاع عن النفس، بل لأن المثقفين منذ زمن بعيد شيّعت جنازتهم الكبيرة، فأصبح كل مثقف إلاّ ويلهث وراء اللاشيء، وينتظر من الحظ والظروف أن تملأ جيوبه بالفراغ. إنها الثقافة عندما تتحول إلى سلعة تُعرض على الحفلات والمحافل والأعراس والجنائز حتى تربح جائزة هنا أو جائزة هناك، وكلها فتات وإلهاء عن المطلوب والحقيقي في واقع عربي ودولي مرير يعاني من المرض والمجاعة والفقر.
وحتى أكون منصفاً فبعض من بقي من هؤلاء المثقفين ( التجار ) راسخاً على رسالته النبيلة ( الثقافية ) يعمل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي – فهي إمكاناته الوحيدة اليوم في زمن كورونا- جندياً مجنداً يحارب بكلماته الجهلوت والغباء، ورغم ذلك فهو لم يؤثر إلاّ نسبة قليلة جداً أمام ما يمكنُ أن يقدمه الأطباء ورجالات الأمن ونساؤه.
إنه لأمر مُؤسف هنا أننا نعيد سؤال الثقافة برمتها إلى الواجهة، وكيف نستطيع أن نفصل بين ثقافة ماضوية تريد أن تشدنا إلى الوراء من خلال إغراق الوطن بأطنان من الأبحاث والمراكز والمعاهد الأيديولوجية التي لا علاقة لها بكل ما هو علمي، وبين مراكز أبحاث علمية تساهم في تنمية الوطن والتصدي لما يهدد صحته العقلية والبدنية والنفسية!
هل يصح لنا أن نتحدث اليوم عن شيء من صحوة ضمير المسؤول تجاه تلك الأدمغة التي هاجرت؟ إذا كان الأمر كذلك فما الذي ستفعله الدولة تجاه هؤلاء، وكيف يمكنُ أن نعيد لمراكز الأبحاث العلمية جدتها وألقها المعرفي، أقول العلمية وليس لمراكز العلم الزائف؟
إنّ الفراغ الذي يتركه المثقف للحمقى والمجانين الذين يستولون على وسائل التواصل الاجتماعي، وأنانيته الفاشلة في حماية مصالحه الذاتية، ولامبالاته تجاه ما يعيشه المجتمع من مآسي، ومكابرة المسؤول على أدمغة بلاده وطاقاتها، كل هذه الأسباب ستجعل الساحة مناسبة جداً لانتشار ظواهر جرثومية تسمم عقول المواطنين وتفرخ لنا البلاغة والتطرف والانتحار.
لعل المثقف يرى في هذه الظاهرة الوبائية العالمية في كونها لا تسمو إلى عقله الناقد وهو الآن صاحب المهمات الصعبة في تفكيك الحداثة وخطاباتها، مع العلم أنّ هذا الوباء والثقافة التي سيفرزها كافية بأن تضرب في عمق اليقينيات الحداثية وما بعدها، بل إنها هي الباراديغم الجديد عينه. وهذه مسألة في فلسفة العلم نتركها لمناسبة أخرى.
يمكن أن تكون جائحة فيروس كورونا الذي تمرّ منه بلادنا والعالم أجمع أزمة صحية أخرى توقظ ضميرنا الجمعي نحو التضامن؛ فالذي أبانت عنه الأطر الصحية والأمن بكل مكوناته وأسرة التعليم بكل أسلاكها البيداغوجية التي تعملُ بشرف وسهر وتعب في هذه الأيام الحالكة رغم ما تكادُ تواجهه من عدم التقدير لا يمكنُ إلاّ أن ندعمه ونثمنه ونعترف به بوصفنا شعباً لا يتوفر على تلك القدرات السوبرمانية لمواجهة الجائحة.






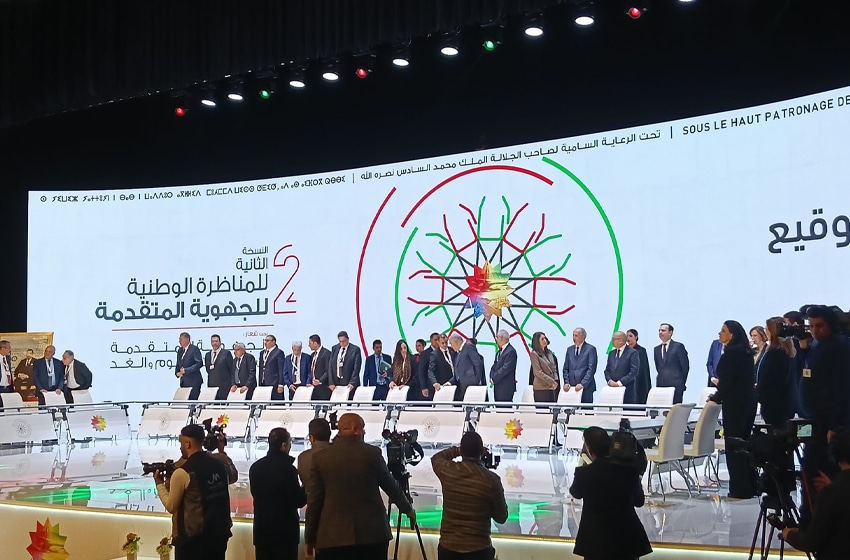








تعليقات الزوار ( 0 )