يركز الخطاب السياسي – الإعلامي الرسمي بقوة هذه الأيام على هذه الفكرة المركزية الأساسية، التي نجدها وراء الكثير من المواقف والقرارات المتخذة. الجزائر تملك أعداء كُثراً، يكرهونها ويتآمرون عليها، في الخارج والداخل.
فكرة يحاول الخطاب السياسي الرسمي وهو يعيش حالة تكلس رهيبة، إقناع المواطنين بها، وتحويلها إلى قناعة مشتركة لدى الجزائريين، الذين يفترض أن يعبروا عن هذا الخوف في كلامهم وسلوكهم الفردي والجماعي. خطاب يساوي بين الجزائر ونظامها السياسي ورجالها في الكثير من الأحيان، فالذي يختلف مع رجال السلطة ولا يوافق على مواقفهم السياسية، هو في حقيقة أمره يكره الجزائر ولا يحب لها خيرا.
حاولت أكثر من مرة إيجاد تفسير لهذا الشعور الذي زاد منسوبه هذه الأيام لدى هذه البيروقراطية السياسية الرسمية، وهي تروج لهذا الخطاب، بعد أن استفحلت مشاكل التسيير اليومي لديها، وزاد تخبطها السياسي، كما بينته حالة التعامل مع فاجعة حرائق الغابات، فلم أعثر على الشيء الكثير، فهل هو التاريخ السياسي للمؤسسات والنخب السياسية، التي استمدت شرعيتها من حرب التحرير- انتصرت فيها ولم تنهزم عكس ما يوحي به خوفها – في مواجهة الاستعمار، لتقوم لاحقا بتسويق ما تكرّس لديها على شكل قناعات إلى الأجيال الجديدة التي لم تعش هذه المرحلة. نخب اقتصرت على جانب العداء والمواجهة، لم توسع نظرتها إلى أشكال التضامن والدعم التي وجدتها الجزائر، من قبل الكثير من الحكومات والشعوب، بما فيها جزء مهم من الشعب الفرنسي نفسه. أم أن الأمر يتعلق بالحاضر ولا دخل للتاريخ في تفسيره، يتعلق بخصائص البيروقراطية الحاكمة وضعف شرعيتها وسوء تدبيرها، بل وفسادها، تلجأ إلى هذا الشحن كوسيلة تسيير يومي، تريد من خلاله ترويض الجزائري حتى يتحول إلى إنسان خائف ومرعوب، من كل محيطه، في الخارج والداخل، يخاف من نفسه ومن جاره ومن الذي يشتغل معه ويعيش جنبه، في مجتمع لم يهضم بعد انتقال أغلبية سكانه إلى العيش في المدن، بالتحولات السيكو- سوسيولوجية التي يفترضها. خوف المطلوب منه ألا يترك للجزائري إلا ما تيسر من علاقات اجتماعية بسيطة للاحتماء بها، كتلك الحاضرة في القرية والجهة والعرش والقبيلة، لمن ما زال لديه هذا الشعور حاضرا. علاقات يراد أن يعود إليها الجزائري حتى وهو يسكن المدينة من أجيال.
باختصار خطاب يريد تسيير الجزائري بالتركيز على نقاط ضعفه الكثيرة – كالانتماء الإثني والجهوي – وليس نقاط قوته الأكثر، كما عبّر عنها في تضامنه الرائع مع مواطنيه في تيزي وزو بمناسبة هذه الكارثة، ليتحول كل شعور وانتماء أوسع من هذه العلاقات القاعدية البسيطة إلى أمر مشكوك فيه، بل إلى تهمة قد يعرض من يقوم بها إلى الحرق والذبح، كما حصل مع الشاب الفنان الطيب جمال بن إسماعين، الذي ذهب للتضامن مع أبناء منطقة القبائل، وهي تعيش كارثة الحرائق، فوجد نفسه في هذه الظرف الاستثنائي، الذي زاد فيها منسوب الغضب والخوف من الآخر، إلى ضحية قتلته الحشود الهائجة، بعد أن تحول هذا الخوف والشك في الآخر، إلى سلوك جماعي قاتل.
خطاب الخوف من الآخر هذا الذي تنتجه وتعيد إنتاجه، بيروقراطية إدارية وسياسية، محدودة الخيال، ضعيفة التأهيل، سيطرت عليها القراءة الأمنية الفجة، وصلت إلى مراكز السلطة في ظروف غير شفافة، ومن دون سند شعبي، لم تمنعها من فرض سيطرتها الكلية على وسائل الإعلام للترويج لخطابها هذا الذي تستعمل المال العام لبثه والتبشير به، هي التي لم تتخلص نهائيا كجيل من أجواء الحرب الباردة وثقافة الانغلاق والحزب الواحد الذي تريد تكريسه كأسلوب تسيير يومي، في المجال السياسي وحتى الاقتصادي، رغم ادعاءات الإصلاح، التعددية والانفتاح المعطل، ما جعلها تدخل في صراعات يومية من كل نوع، مع محيطها القانوني داخل البلد وخارجه على المستوى الدولي، يمكن أن تصل بسرعة إلى مرحلة التفكير في غلق نوافذ الوسائط الاجتماعية الدولية على غرار فيسبوك وغيرها، بحجة أنها تأتينا من دولة لا تحب لنا الخير. خطوة يمكن ان يوصي بها بعض وجوه هذه البيروقراطية المغلقة، بنت الفكر السياسي الدولتي، القريب من النموذج السوفييتي الذي تعود إليه للاستلهام منه، كلما ضغط عليها الواقع. حتى من دون توفر الشروط – مال واقتصاد قوي وقدرة على تحمل الضغوط الدولية – كتلك التي تملكها بعض الأنظمة المغلقة سياسيا، على غرار الصين وإيران وروسيا.. فكرة يمكن أن تورط النظام السياسي أكثر على المستوى الدولي، وتزيد في عزلته على أرض الواقع هذه المرة. مهّد لها منذ شهور بغلق قنوات تلفزيونية دولية فرنسية وعربية، لم تنجح في التكيف مع الضغوط السياسية التي قبلت بها أخرى، إلى حين ربما.
حرائق الغابات وأزمة وباء كورونا، بما عرفته من اختفاء لمادة الأوكسجين والماء الشروب وقبلها أزمة السيولة المالية، إلخ يمكن أن تقدم لنا درساً حياً لمعرفة كيف يشتغل خطاب التخويف هذا، وهو يقوم بإنكار للواقع، ففي الوقت الذي تنتشر فيه الحرائق على طول الساحل المتوسطي الشمالي والجنوبي – تركيا – اليونان – تونس – ليبيا وغيرها، يركز الخطاب الرسمي الجزائري على الحرائق التي يمكن ان تكون بفعل فاعل، ليتكلم عن اعتقالات في أكثر من ولاية واحدة وهو يشير للدور الذي يمكن ان تلعبه قوى سياسية معارضة، من دون أن يترك الفرصة للعدالة في البت في الأمر، وتقديم المتهمين أمام العدالة والرأي العام للتعرف عن دوافعهم، من وراء هذا الفعل الشنيع.
خطاب لا يتورع كل مرة عن توريط نفسه بالتركيز على ما يعتقد أنه حلول آنية، كفيلة بإخراجه من أزمته، لينسى الملف كله بعد أيام، حين ظهور أزمات أخرى. لا يجيب على أسئلة منطقية وبسيطة على سبيل، كيف لمعارضة محدودة الانتشار ومن دون سند شعبي فعلي، أن تحرق الغابات على طول ولايات الساحل على أكثر من 1200 كلم؟ أم ان الأمر متعلق فقط بالزيادة في منسوب التهويل والتخويف كوسيلة تسيير للشأن السياسي العام، كما كان الحال مع الحراك الشعبي، الذي تبين لاحقا – من خلال ملفات العدالة وما تداولته الصحافة – أن نقاشاته وصراعاته وشعاراته، كانت مخترقة من قبل مؤسسات الدولة العميقة التي عملت المستحيل لإيقاف المسيرات، وكسر شوكة هذه الهبة الشعبية السلمية الرائعة، حتى إن استدعى الأمر تهديد النسيج الوطني الاجتماعي والثقافي للجزائريين، انطلاقا من منطلق بسيط، إنقاذ النظام ورجاله أولى وأهم من إنقاذ البلد والدولة الوطنية.

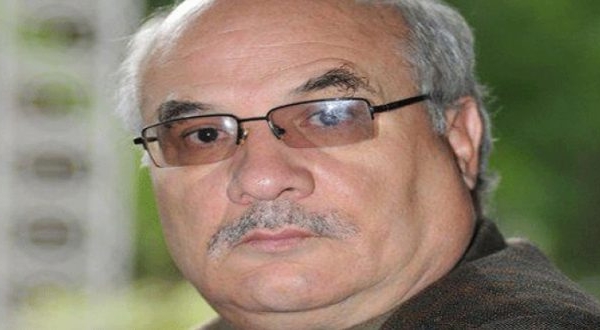













تعليقات الزوار ( 0 )