قراءة في كتاب Le Maroc au présent
B. Dupret, Z. Rhani, A. Boutaleb, J.- Noel. Ferrié(Dir). « Le Maroc au présent, d’une époque à l’autre, une société en mutation » .Edition Fondation Abdul – aziz Al Saoud et Centre Jacques Berque, Collection Dialogue des deux rives. 2015.
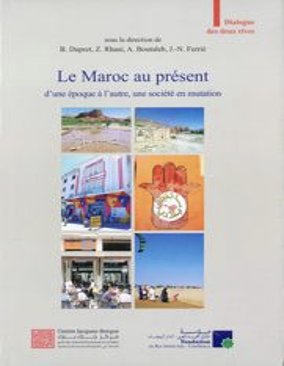
المغرب في الوقت الحاضر، من حقبة إلى أخرى، مجتمع في تحول
يدرس المؤلف الجماعي، المغرب في الوقت الحاضر، من حقبة إلى أخرى، مجتمع في تحول Le Maroc au présent, d’une époque à l’autre, une société en mutation، مجمل التحولات التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين، موظفا منهج تقريب الصورة من الوضعيات المصغرة، حيث تقديم نصوص اعتمدت دراسات ميدانية، وبشكل أقل على الأطر النظرية مقارنة مع تقديم عدد وافر من الرؤى المتقاطعة حول السيرورات الاجتماعية، في شتى تعبيراتها المتنوعة. وهو ما أتاحته مساهمات ثلة من الباحثين، في العلوم الإنسانية والاجتماعية عبر تعدد مقارباتهم ، وانطلاقا من ملاحظات الميدان. وهي نصوص من المرجع أن تُنوع وجهات النظر والمنظورات حول المجتمع.
يريد الكتاب، عبر تبني هذه المقاربة الفوتوغرافية، التنويع، قدر المستطاع، في زوايا “الالتقاط” من أجل توضيح دينامية اجتماعية وأنثروبولوجية حول تيمات عامة تمت معالجتها في هذا الكتاب. وهذه العملية الوضعية والسردية، بحسب عبارات الكتاب، لا تعتزم إعطاء معنى لكل شيء، أن تقول ما هو المغرب وإلى أين يسير، بقدر ما تهدف، بشكل أساسي، إلى إعطاء رؤية لصور مختلفة وحتى متناقضة من المغرب. بحسب الكتاب، يعد الأسلوب الإثنوغرافي الذي يريد إعطاءه لهذه الالتقاطات من الواقع، مناسبا من أجل تقييم دولة في تطور ثابت، أحيانا متسارع ومتضارب، وأيضا من أجل فتح البحث حول آفاق جديدة. سيما وأنه اُعطيت الكثير من حرية التصرف للكُتاب، حيث لا توجيهات، نظرية أو معيارية مسبقة، مما يشكل فائدة وغنى كبيرين لمختلف النصوص.
يتكون الكتاب من ثمانية أجزاء، مقدمة عبر فصل أو فصلين طويلين، وهي كلها تأليفات حول هذه التيمات العامة:
أولا، الفضاءات، المدن، والإقليم،
ثانيا، الديناميات والعلاقات الاجتماعية،
ثالثا، العلاقات الاجتماعية والنوع،
رابعا، الثقافات واللغات،
خامسا، السياسة والعلاقات الدولية،
سادسا، التنوع وتناقضات الديني،
سابعا، القانون والمعيار،
ثامنا، الاتجاهات الاقتصادية والممارسات ذات الصلة بالعمل.
وتتمثل مرجعيات التحليل، كما حددها مؤلفو الكتاب، في التقليد مقابل الحداثة، والقانون مقابل المعايير الاجتماعية، إلى جانب دحض فكرة الإفراط في تحديد الاجتماعي عبر السياسي. ويبدو أن الكتاب قد أعطى أهمية بالغة لعلاقة الحداثة بالمعيار في رصد تحولات مغرب اليوم، مما قد يجعل منه براديغما أو بنية تحدد تحولات مغرب اليوم التي توجد في كفة الحداثة والمعيار لدولة في تطور تابث. سأحاول، بالنظر لغنى الكتاب بالنصوص العديدة، أن أكتفي في هذه القراءة بتقديم أهم ما تضمنته مقدمته.
مجتمع مركب ومغرب يتحرك
اعتمادا على مرجعيات التحليل التي حددها الكتاب، تنطلق مقدمته من تصور، وبحسب التأريخ الرسمي، يعتبر أن المغرب سيواصل رحلته تجاه الحداثة دون الاضطرار إلى التخلي عن التقليد. وما يعزز من هذا التصور هو وجود ملكية تعددية متصلة بالرسول محمد (ص)، وفي نفس الوقت حداثية. فمن الممكن وصف المغرب كدولة غير قادرة على الدخول إلى الحداثة بينما لم تعد مطلقا تقليدية. ستكون في نفس الوقت متحركة وجامدة، مجرورة في اتجاه وفي آخر، دينامية ومحافظة. وتبدو صيغة السوسيولوجي المغربي الكبير بول باسكون Paul Pacson، التي من خلالها يكون المغرب مجتمعا مركبا جد مبررة، عبر تراكم الماضي الذي من خلاله لا يمكن التخلص، وعبر التعاقب، من التحديث، والذي يفشل بدوره في التخلي عن هذا التراكم السابق. كذلك، خلال مرحلة ما بعد الاستقلال، سيقوم المغرب بتحديث الدولة، عبر إقامة نظام دستوري تمثيلي تقنيا، تتزعمه المؤسسة الملكية. كما تعتبر مقدمة الكتاب أن المغرب يتحرك، إذ ترى في هذا السياق، إفراطا في تحديد الاجتماعي عبر السياسي، الذي يتجاهل الأثر الحاسم للممارسات السوسيوسياسية الاعتيادية المتعلقة بالتحول الاجتماعي والسيرورات الحاسمة. على الخلاف من هذه الفكرة الكسولة والعقيمة التي تريد أن ترى في المخزن وامتداداته الاجتماعية البنية التي تفسر كل شيء، هدف الكتاب هو إزالة الطابع السياسي عن هذه الرؤية حول المغرب، عبر إعطاء السياسة مكانتها الصحيحة ضمن باقي حقول التفاعل الإنساني عبر عدم تحجيمها في ممارسة السلطة.
كذلك، تعتبر مقدمة الكتاب، وعوض تخيل مغرب منحبس في التناقض تقليد- حداثة التي توصله إلى حالة من الشيزوفرينيا، يعرض المغرب في الوقت الحاضر عدة أوجه من هذا التوتر عبر تبيان أنه ليس محددا مسبقا ولا يعاني منه الناس. إنه بالأحرى صياغة توفيقية وتجريبية لمسارات سوسيولوجية ولقصص شخصية متعددة، تعتمد أساسا على سياقات اجتماعية وملاحظة، ليس فقط على مستوى الأجهزة المؤسساتية، السياسية، الدينية، الترابية، أو القانونية، ولكن أيضا، على مستوى الممارسات اليومية للجميع.
دولة في تطور تابث
في الوقت الذي تعتبر فيه مقدمة الكتاب أن المغرب يتحرك وأن هناك أثر للتحولات المجتمعية على الدولة، تقدم زاوية أخرى لتحليل مغرب اليوم، عبر اعتبار أن الدولة هي في تطور تابث. في هذا الجانب، تعرض مقدمة الكتاب بعض المراحل الكبرى في التاريخ المعاصر للمملكة، معتبرة أن الانتقال بين الملكين، الحسن الثاني ومحمد السادس، يمثل في الواقع، تحولا كبيرا في تاريخ الدولة، على كافة المستويات. وقد أثبتت التحولات التي عرفها المغرب، أنها حاسمة في نزع فتيل المخاطر. ففي أول خطاب له للعرش، أكد الملك، مجددا انخراط المغرب في إقامة دولة القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز التعددية السياسية والليبرالية الاقتصادية، إضافة إلى تطبيق الجهوية. ولم تكن تتميز مسألة الانتقال فقط بتدابير وتحولات النظام السياسي، ولكن أيضا بتشكيلات جديدة للاجتماعي، حيث يعبر الانتقال في معناه الواسع، في علاقته مع اللغة، مع الدين، مع الثقافة، مع الشباب، مع الأجانب، مع وضعية النساء.
فيما يتعلق بوضعية التسعينات، فهي تشكل منعطفا، سيما بعد تحرير الإعلام، في سياق الانتقالات الديمقراطية في أمريكا اللاتينية، وفي أوروبا الغربية، وبعض اختراقات حقوق الإنسان، التعذيب، الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري. وستتخلى الدولة على نظام الاستثناء الذي اشتد طوال الصراعات العنيفة التي طبعت الحياة السياسية بعد الاستقلال، خصوصا أحداث الريف سنة 1958- 1959، الانقلابات العسكرية الفاشلة لسنة 1971 و1972.
في الميدان الاقتصادي، تعبر التطورات على الانتقال أكثر مما تعبر عن التحولات الهيكلية. فخلال العقد الأخير، عرفت الدولة تسارع وتضاعف برامج التنمية، وتعميما لطريقة المشروع الكبير، ومجهود متواصل للتنوع الاقتصادي بعد سنوات من التقلبات الكبرى، وحتى غير المنتظمة للنمو، وذلك بفضل الاستقلالية في الموارد الطبيعية المتمثلة في الفوسفاط، حيث البلد هو ثالث منتج وأول مصدر عالميا. وبفضل الحصة الكبيرة للقطاع الفلاحي، المعتمد على مياه الأمطار، فقد دخل الاقتصاد المغربي في نهاية سنوات الثمانينات، في التقويم الهيكلي، على غرار باقي بلدان المنطقة. وإذا كان في أواخر سنوات 2000، لا يمكن إنكار الانتعاش، فإنه مدين بدرجة أقل إلى سياسات التقشف المفروضة من طرف المنظمات الدولية- حيث تزايد الاستهلاك الأسري المدعم عبر سياسة مالية توسعية ابتداءا من سنة 2006.
ويتحدد تنوع الاقتصاد بشكل أساسي عبر قطاع ثالث متنام، متمثل في السياحة ، النقل ووسائل الاتصالات. كذلك المؤشرات الماكرواقتصادية هي في ارتفاع. ولكن، الاكتفائية لا تحجب الهشاشات المستمرة ونقاط الضعف المتكررة. حيث تزايد اللامساواة الاجتماعية والاختلالات المقلقة لسوق العمل. ورغم تقلص الفقر، فقد بقيت اللامساواة راكدة، كما لا زالت جيوب الضعف قائمة. وتكتسي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي بدأت سنة 2005، من طرف ملك المغرب أهمية كبيرة، ورغم ذلك، لم تغير الأشياء جذريا.
وفي المجال الديني، تلاحظ مقدمة الكتاب، بشكل تناقضي، أن أشكال جديدة للتدين قد تم إعادة تفعيلها، سواء لتقوية شرعية السلطة الملكية أو للتصدي لنفوذ جزء من الإسلام السياسي الذي يعتبر بمثابة معارض للإسلام”الشعبي” والصوفي. إذ تهدف السياسة الدينية الجديدة منذ بداية سنوات 2000، إلى إعادة هيكلة الحقل الديني، فهي تهدف، من جهة، إلى تقوية وحدة عقائدية ثلاثية معتمدة على المذهب المالكي، المذهب الأشعري وصوفية مركبة، ومن جهة أخرى، إلى مواجهة تأثير المذاهب السياسية- الدينية المنافسة، خصوصا الشيعية، الوهابية ومختلف مكونات ما يسمى “الإسلام السياسي”.
في هذا السياق المتعلق بإعادة الهيكلة، فقد احتلت الصوفية بمختلف أشكالها، خصوصا الزوايا، مكانة مركزية. فبالإضافة إلى التعيين الملحوظ سنة 2002، لصوفي، مثل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، المنتمي إلى الزاوية البودشيشية، فقد أعادت النسخة الأولى من الملتقيات العالمية الصوفية، سنة 2004، والملتقى الثاني، سنة 2009، الذي تم عقده في ضريح سيدي شيكر، تأكيد الدور المركزي الذي ينبغي أن تلعبه المعتقدات والممارسات الصوفية في إعادة هيكلة الحقل الديني، حيث ذكرت الرسالة الملكية الموجهة إلى المحاضرين والمشاركين، بالدور الحاسم الذي لعبته، وينبغي أن تلعبه الصوفية في تاريخ الدولة. حيث الممارسات والمعتقدات الصوفية هي كذلك، مدعوة لتحرير”العقول من الأهواء من المهام التي لا داعي لها من السلطة” وتقوية المرتكزات الثقافية الشرعية السياسية- الدينية للملكية.
تعتبر مقدمة الكتاب في هذا الجانب، أنه، في المجمل، هذا التعاون بهدف نزع الطابع السياسي عن الإسلام، يجعل من الصوفية، نفسها، كذلك، شكلا آخر من الإسلام السياسي. ومثل هذا التناقض تم التعبير عنه، بشكل واضح، خلال الأحداث التي هزت العالم العربي. حيث تمت ملاحظة تعبئة غير مسبوقة للقوات الدينية “اللاسياسة”، إضافة إلى أعضاء من السلفية المستكينة، وتنظيمات صوفية مثل البودشيشية، والتي احتلت بقوة الفضاء العمومي والإعلامي لمعارضة المظاهرات المنظمة من طرف حركة 20 فبراير وتأييد الإصلاح الدستوري الذي رفعته الملكية.
التوفيق بين الحداثة والمعيار
بحسب مقدمة الكتاب، تبرز قضية النساء، عبر إصدار مدونة جديدة للأسرة، مسألة التوفيق بين الحداثة والمعيار. حيث تلاحظ المقدمة، طفرة واعدة، فيما يخص قضية النساء، سيما مع إصدار، قانون جديد للأسرة(المدونة) سنة 2004. حيث تمت مناقشة قصة إعدادها والنضالات التي ولدتها، تحليل تبنيها والنتائج العملية أو غيابها في المعيش اليومي للرجال والنساء، في مختلف مساهمات هذا الكتاب، والهدف من ذلك، والذي ينبغي رؤيته عبر الجدل الساخن حول المدونة الجديدة للأسرة، هو الجدل حول التعريف ذاته لما تكون، في السياق المغربي، حداثة مقبولة. فطوال عملية القيام بالإصلاح، كان الهم الأكبر هو التوفيق بين الحداثة والمعيار. يتعلق الأمر بإصدار تشريعات لمجتمع يتحرك مع بقائه وفيا بشكل كلي للإسلام. وفي هذا السياق تتساءل مقدمة الكتاب عن التوتر الذي يوجد بين المعيار القانوني والمعيار الاجتماعي(الدين كما هو مفهوم). بعبارة أخرى: إلى أي حد يمكن لقانون أن يغير المعايير الاجتماعية، سيما عبر التأكيد أن المعايير التي تجد مرجعيتها في الإسلام لم يتم مسها؟
تعتبر مقدمة الكتاب أن القانون، كيفما كان تباينه مع الواقع الاجتماعي، يقدم غطاءا قانونيا لخرق المعايير الاجتماعية، وتبقى هذه الخروقات في البداية محدودة، ولكن يمكنها خلخلة نظام الأشياء بشكل تدريجي، والقانون نفسه، كي تصبح مكتسبات اجتماعية وثقافية. تضيف مقدمة الكتاب أن الوضعية الاجتماعية للنساء عرفت منذ بداية سنوات التسعينات، تطورا مهما، سيما في المناطق الحضرية، حيث الوصول المتزايد للنساء إلى الجامعة ولسوق العمل، إضافة إلى ذلك، الارتفاع الملحوظ لسن الزواج، إلى جانب التحولات التي عرفها اختيار الشريك الذي تأثر بنفس هذه التحولات. كذلك، فباعتبار مشكل العطالة وغلاء العيش، فقد اكتسبت ظاهرة المرأة الحاملة لدبلوم والمرأة التي تشتغل نفس الأهمية في سوق الحياة الزوجية الذي انتهى عبر منافسة بعض المعايير التي لا تحدد لوحدها بشكل حصري اختيار الزوجة، مثل السن، العذرية، الأصل الاجتماعي، المهارات الجيدة لتدبير المنزل. وقد أثر هذا التطور على السواء على علاقات السلطة بين النساء والرجال، وعلى العلاقة بين الخاص والعام.
تلاحظ مقدمة الكتاب أن هذه التحولات بطيئة وجزئية، ولكنها تجر إلى تحولات متوالية تتعلق بالعائلة، وبشكل أكثر اتساعا بالمعيار الاجتماعي. إذ تشكل، إضافة إلى ذلك، القاعدة لمطالب أخرى مع الازدياد التدريجي لحرية الحياة الخاصة، مثل الحرية الفردية التي لم تؤد إلا إلى تعبئات جد ضعيفة.
تعتبر مقدمة الكتاب أن الحركة النسائية، لعبت طوال عملية إعداد مدونة الأسرة ورغم أخطائها، دورا مهما نسبيا لمساءلة العلاقة مع المعيار الديني. فعبر إدراجها لهذه المطالبات في إطار المرجعية الإسلامية، فقد اقترحت قراءات جديدة لعلاقات النوع التي تبرر وتشرعن المساواة بين الجنسين عبر النص. حيث محاولتها هي تقليص المعيار الإسلامي إلى معيار ثقافي وظرفي، عبر الرفع كليا من تأويلها الخاص للنص إلى معيار أكثر كونية لأنه يضمن المساواة. تضيف مقدمة الكتاب أنها تنتقد ليس فقط وضعية المرأة في الإسلام، ولكن أيضا، بطريقة معينة، الإسلام نفسه، على الأقل كمرجعية. لتستدرك المقدمة أنه لا تزال هذه التحولات تعتمد على عمق التغيير في العلاقة، الفردية، الفكرية والمؤسساتية، مع المعيار الديني.
خلاصة
يمكننا أن نستنتج، عبر هذه القراءة المختزلة لمقدمة الكتاب، أن المغرب حتما يتحرك على المستوى الاجتماعي، سيما عبر التحول على مستويين، مستوى سياسي، حيث لم تعد الدولة هي البنية التي تفسر كل شيء بقدر ما أن هناك أثر حاسم للتحولات الاجتماعية، والمستوى الثاني، اجتماعي، يتمثل في مسألة الحداثة التي تمس المجتمع، ويمكن اعتبار أنها تعبر عن التوفيق مع المعيار الديني أكثر من كونه صراع.
لكن، يمكن اعتبار أن التحولات لا تؤدي إلى أي مكان محدد، باعتبار أن مغرب اليوم لا زال قابلا للتوصيف عبر صيغة بول باسكون مجتمع مركب، مما يضمن التوازن الذي يؤدي إلى التوافق أكثر من الصراع الذي يؤدي إلى بروز رؤية واضحة للجدل الذي يؤطر مغرب اليوم والمتمثل في العلاقة بين الحداثة والمعيار. وهو ما يجعل من تحولات المغرب، ورغم ما اعتبرته مقدمة الكتاب أنه مجتمع يتحرك، فإنه يمكن اعتبار أن هذه التحولات التي يعرفها المجتمع، وعلى غرار التحولات التي تعرفها الدولة، هي تحولات في إطار ثابت. يمكن اعتبار أن هذه الملاحظة تنطبق أيضا، على باقي التحولات في شموليتها حيث ما يميزها في العمق هو الجمود. مما يجعلنا نصف مغرب اليوم اعتمادا على مقدمة الكتاب، كمجتمع للتوافق والتوازن، في ظل دولة تتطور في الجمود.

*باحثة في العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس















تعليقات الزوار ( 0 )