(1)
يجعل الاعتقاد الخطير السائد اليوم بأن التطرّف والعنف ورفض الآخر جزء من العقيدة الاسلامية أحد أكبر منابع التوتر والحرب الباردة، والساخنة أحيانا، في العالم المعاصر. وتشكل مواجهة هذا التطرّف محور الحياة السياسية والثقافية لحكومات الدول العربية، وبعض الإسلامية، وتحتل موقعا متميزا في الأيديولوجية السياسية التعبوية، وفي الخطط الإستراتيجية للدول المركزية في الغرب والشرق، كما تشير إليه “الحرب الدولية على الإرهاب” التي هي الحرب الوحيدة العالمية المعلنة والمشروعة اليوم. وينجم عن هذا الاعتقاد ما يشبه التهمة الخفية بأن كل مسلم يحمل في عقيدته جرثوم التطرّف والنزوع إلى العنف. والإسلام عموما هو المتهم، والمسلمون ضحايا عقيدة مقدسة فاسدة من الأصل، وعليهم إصلاحها أو تحمّل المسؤولية عن التهم الموجهة إليهم، وعلى رجال دين المسلمين ومفكريهم أن ينكبّوا على إعادة تفسير النصوص الدينية لتطهيرها من لوثة العنف والتطرّف، إذا أرادوا أن يستعيدوا ثقة الآخرين، ويوقفوا تيار الكراهية ونزعة العزل والإقصاء المتفاقمة التي تهدّدهم، بوضعهم خارج سقف القانون، حيثما كانوا، في بلدانهم نفسها، وفي بلدان إقامتهم وهجرتهم التي أصبحت أحد أوطانهم الرئيسية أيضا.
بصرف النظر عن صحته أو خطئه، يخدم هذا الاعتقاد، والخطاب الذي يروّجه، أطرافا عديدة. أولها حكومات الدول المركزية التي تهيمن على المنظومة الدولية، وتتحكم بأجندتها السياسية الرئيسية. فهي تستخدم الخطر الاسلامي لهدفين هامين: إيجاد خطر جديد عالمي، يعوّض الخطر الشيوعي الذي وحد العالم الليبرالي عقودا طويلة، ويكون، من النوع ذاته تقريبا، عولميا، كريها، وعدوانيا وشاملا، وغامضا لا يمكن الإحاطة بملامحه جميعا، ما يبرّر أيضا الاستمرار في تعظيم النفقات العسكرية والاستثمار في التقنية القتالية من كل الأنواع، أي في شرعنة اقتصاد الحرب الذي أصبح جزءا أكثر من مهم من الاستثمار “الرأسمالي” العالمي، ويعمّق التحالف مع النظم الاستبدادية الفاسدة، ويسوّغ التدخلات العسكرية المتزايدة في بلدان الجنوب الفقيرة التي تشكل اليوم محيطا هائجا يغلي بالتوترات والنزاعات الأهلية ومشاريع الهجرة الجماعية نحو المراكز العالمية.
ولا يقل الهدف الثاني أهمية عن الأول، وهو استخدام الخوف أو التخويف من الإسلام لاستنهاض المشاعر والكليشيهات القومية والإثنية المنحلة، وتوحيد الكتلة الرئيسية من السكان، على حساب التمييز ضد الطبقات البائسة الجديدة التي تحتل معظم الأرياف المحيطة بالمدن العامرة في الدول الصناعية، والتي تكاد تتحوّل إلى مناطق سكن العمال المهاجرين والباطلين عن العمل والبروليتاريا الرثّة المتعدّدة الاصول والقوميات. وأعتقد أن الدور الرئيس للإسلاموفوبيا هو اليوم إعادة الإنتاج المستمرة لهؤلاء السكان الملونين، كأجانب ودخلاء ومختلفين ومتطفلين على المجتمعات البيضاء، أي مواطنين من الدرجة الثانية. ومن ثم قلب الإيديولوجية التقليدية اليسارية رأسا على عقب، حتى تصبح “البروليتاريا الجديدة” هي التي تستغل المجتمعات البيضاء المتقدّمة، وتنتزع منها فرص عملها، وليس العكس.
ويخدم الإسلام المعدّل جينيا ليصبح مصدر خطر داهم ودائم، ثانيا، النظم الديكتاتورية، فهي تضخم من مخاطر انفلات عدوانيته، وإذا اضطرت إلى المشاركة في إنتاجها، لتبرّر سياسات القمع الشامل وإغلاق المجال السياسي والقضاء بجميع الوسائل غير القانونية وشبه القانونية على معارضيها، وأحيانا للتغطية على عمليات الإبادة الجماعية، كما يحصل اليوم للأقلية الإيغورية في الصين الشعبية، وكما حصل في مناطق سورية عديدة أيضا خلال هذا العقد المنقضي.
ويخدم الإسلام “دين السياسة المسلحة” والتضحية والجهاد، ثالثا، النخب الاجتماعية المتمرّدة أو النازعة إلى التمرّد على سلطات جائرة وقاهرة ومحمية خارجيا بما يقدّمه لها من زاد إيديولوجي ومصدر شرعية مضادّة، تحظى بالصدقية، بمقدار ما تضمر بالفعل لغة العنف وإمكانية إنتاجه واستخدامه، وأعني بها بالطبع النخب الإسلاموية.
وهذا ما يفسّر ظاهرة تفاقم نفوذ القوى المعارضة الإسلاموية على حساب القوى الديمقراطية المدنية في ظل النظم الديكتاتورية العربية. إذ يبدو الديمقراطيون المدنيون نمرا من ورق أمام نظم طاغية، ومستعدّة لارتكاب كل المجازر، يصعب الرهان عليهم في أي مشروع تغيير، مقابل قوى إسلامية توحي بالمقدرة على مواجهة العنف وإنتاجه أيضا بصورة أقوى، والاستعداد للموت ومواجهة الاستبداد الوحشي بسلاحه، أي بالعنف ذاته. بمعنى آخر، ليس التمسّك بالشعائر الدينية وضمان الحياة الآخرة هي التي تجذب الشباب الضائع من دون أمل أو مستقبل إلى الحركات الاسلامية، ولكن بالعكس تماما، مفهومها للعنف وعلاقتها به، من أي مصدر جاء. وليست آيات الجهاد هي التي تدفع المضطهدين والمهمشين والمعزولين إلى اللجوء إلى العنف في صراعهم الدموي، وإنما العكس هو الصحيح أيضا. إن ضراوة الصراع وفرض لغة العنف على المعركة الدائرة من عقود ضد السلطة الفاسدة، ومن أجل التغيير، هو الذي يولد الحاجة لخطاب العنف، ويعيد إحياء معاني الشهادة واستعادة الذاكرة الجهادية القديمة التي ارتبطت بعصر الفتوح والانتصارات التاريخية. باختصار، لا تستطيع المعارضات الجديدة أن تقنع أحدا بقدرتها على مواجهة العنف، ما لم تتبنى عقيدةً توحي بإمكانية استخدام العنف، وتضمره في مواجهة عنف السلطة وجبروتها وإصرارها على تأبيد حكمها، مهما كان الثمن.
وهذا ما يجعل “الإسلام السياسي” المزخر بعنف مضمر أيضا يبدو نمرا بأسنان حديدية، ومن ثم ضمانة للتقدّم في مواجهة الديكتاتورية الدموية، بالنسبة لجمهورٍ واسع يشعر بالحرمان والقهر والاضطهاد في أكثر البلدان العربية والإسلامية التي افتقرت لأي نوعٍ من الممارسة السياسية وأي جهد، أهلي أو رسمي، لنشر ثقافة مدينة حقيقية. الطريق الوحيدة لربح المنافسة مع الحركات الإسلامية على قيادة الجمهور الناقم والمتحفز للعمل والانتفاض وانتزاع تأييده في هذه المواجهة الدموية التي فرضتها النظم السياسية القائمة، كانت تمرّ بأحد مسارين: مسار حروب الغوار التي طورتها الحركات اليسارية في أميركا اللاتينية وآسيا، ورعتها فكريا الفلسفة الماركسية والشيوعية. وهذا يفترض أن ينزل المثقفون العلمانيون، كما فعل أسلافهم من اليساريين، مثل غيغارا وكاسترو، وقبلهم لينين وماوتسي تونغ، إلى الميدان، ويحملوا السلاح لقيادة شعوبهم. وهو ما أصبح مستحيلا وفارغا من المعنى والصدقية، بعد انهيار التجارب السوفييتية والشيوعية عموما، وانحسار القيمة التحرّرية لهذه العقائد اليسارية، أو تلقي دعما حقيقيا وقويا من قوى خارجية تدعم خيار الديمقراطية والدولة المدنية وتقلب التوازنات لصالح النخب التحديثية العلمانية. وكلاهما بديا بعيدي المنال.
ويشكل الإسلام المزخر سياسيا وعسكريا، رابعا، أي المستعد للدخول في الحرب المفروضة من السلطات القائمة، بعد تدمير السياسة وتذويبها في الحرب، ذريعة لدى بعض الأقليات للانشقاق عن الجماعة القومية الخاضعة، والإنكفاء على سياسة قديمة ما قبل وطنية، هي الإنعزال، وعدم الإنخراط والسير ما أمكن بمحاذاة الجدار أو أكثر من ذلك بالنسبة لبعض الأقليات القومية، الانفصال، على أمل الخروج من حلقة التهميش أو الاضطهاد المعمّم، أو الاستعصاء السياسي، والبحث عن مخارج محتملة خارج الصراع بين النظم المتوحشة والمعارضة الإسلامية الإقصائية.
وأخيرا، يوفر “الإسلام السياسي” المتنامي في صفوف الجمهور المروّع والباحث عن مجاهدين وأبطال ومتبرّعين بأرواحهم دفاعا عنه وسيلة سهلة للنخب المثقفة المدنية، التي تنظر لنفسها بوصفها الوريث الطبيعي والوحيد الممكن لنظام القمع، لكنها تفتقر، في الوقت نفسه، لأي قوة مادية ذاتية، أو دعم خارجي قوي، يمكنانها من مقارعته والتأثير فيه، لحفظ ماء الوجه، وإمكانية متاحة لإنقاذ كبريائها المثلوم، ورمي المسؤولية في فشل انتفاضات التغيير الشعبية على منافسيها وشركائها معا في المعركة الشاقة لإسقاط نظامٍ يمدّ جذوره عميقا في خراب المجتمعات المحلية والتحالفات الدولية شبه الاستعمارية، فالواقع، بصرف النظر عن أوهامها الكبيرة عن نفسها، لا تمثل النخب المدنية المنشغلة فعلا بالهم العام سوى مجموعات محدودة ومعزولة من المثقفين، لا تزن كثيرا في ميزان القوة العسكرية والاستراتيجية العاملة في ساحات المواجهة التي تتخذ أكثر فأكثر، كما أظهرته تجربة الثورات العربية لهذا العقد، طابعا عالميا، وتشارك فيها دول على درجةٍ كبيرةٍ من النفوذ والقوة والتصميم، ومن الصعب عليها موضوعيا أن تشكّل، في مثل هذا الوضع، قوة تغيير ناجعة وفعالة في إطار صراع يكتب بالدم.
(2)
والمقصود من ذلك كله أن المعتقد الإسلامي، مهما كان تأويلنا غاياته، أو جوهره، أكان عقيدة غزو وفتح وبناء امبراطورية أم دين تعبّد وتهجد وتهذيب للنفس وتدريب على الأخوة والتكافل والتضامن بين أفراد الجماعة الواحدة والإنسانية، وهو في الواقع كلاهما، ليس هو الذي فرض لغة العنف هذه على صراع اجتماعي وسياسي، كان من المفروض، حسب ثقافة العصر الذي نعيش فيه، أن يجري كما توقع الجميع، بوسائل غير التي كانت مستخدمةً في القرون الوسطى، أو على الأقل أن لا يصل فيه العنف إلى مستوى ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية واستخدام أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة الكيميائية في بعض الحالات. العكس هو الصحيح. ما فجّر مخزون العنف في تراث الإسلام الديني والدنيوي هو اللغة الدموية التي فرضها الخصم الممسك بالسلطة وحلفاؤه على الصراع، ليس الآن فحسب بل منذ عقود، وسدّهم بذلك أبواب الرحمة والأمل، وأي مخرج ممكن سوى الصعود إلى أقصى ما يمكن من العنف، فقاعدة الحرب التي يفرضها دائما القوي والأقوى هي التي استدعت تسييس الإسلام والتركيز على منابع الغضب والنقمة والكراهية فيه، وشحن السياسة الجديدة التي ولدت منه أو أضيفت إليه بعنف أهلي فائض وغير مسبوق.
لا يعني هذا أبدا أن النصوص الأصلية المعترف بشرعيتها في الإسلام لا تتضمن أفكارا واعتقادات تدفع إلى التطرّّف والقتال والحرب، فلا يوجد دين ولا أي عقيدة اجتماعية، بما فيها العقائد العلمانية الحديثة الليبرالية، والشيوعية، خالية من منابع القوة والعنف. وليس مستغربا، إذن، أن تكون هناك توجهات عدوانية في نصوص الأديان المقدّسة التي أصبحت، في الغالب أيضا، مرجعية سياسية لدول او سلطات سياسية امبرطورية، تقوم على القوة والشوكة، وبالتالي العنف حتما. والحرب التي هي العنف المنظم والمقطر جزء من السياسة والحياة السياسية الداخلية والدولية في عالم قائم على التنافس على الموارد والمواقع والنفوذ. ولا يمكن لديانةٍ عالميةٍ تماهت لحقبة مع سلطة دولة، وأصبحت ديانة امبرطورية، أن تخلو من النصوص التي تمجّد الكفاح والدفاع عن العقيدة والجماعة والأمة والمذهب. ولا تستبعد معتقداتنا الحديثة فكرة العنف والصراع والكفاح من قاموسها السياسي. ما تقوم عليه عقيدتنا السياسية الحديثة أن سيادة الدولة، وبالتالي سيادة الأمة التي تمثلها، تفترض الاستعداد الدائم للحرب والجرأة على خوضها. وهذا ما يفسّر المكانة الكبيرة التي تحتلها الإستراتيجية والحرب وتطوير السلاح أداة العنف باضطراد وتضخيم الميزانيات الدفاعية في إدارتنا السياسية واقتصادنا وثقافتنا حياتنا العامة أيضا، بما في ذلك ثقافة التجنيد الإجباري. ولم تتردّد حركات الإستعمار القديم والجديد والراهن عن رعاية العنف وتمجيده أحيانا، ضد الآخر، العدو، جنبا إلى جانب مع الاعتقاد بالسلام والرحمة وحب الآخر والتمسّك بالقيم الإنسانية والتشجيع على الأعمال الخيرية والمساعدات الإنسانية داخل الجماعة الدينية الواحدة، مسلمة كانت أم مسيحية أم يهودية أم ليبرالية أم علمانية.
ومع ذلك، لا يوجد شك في أن الاعتقاد الإسلامي السائد اليوم في معظم المجتمعات الإسلامية، والعربية منها بشكل خاص، ينزع إلى التركيز على الجانب العنفي في العقيدة، وإلى القبول السهل بالعنف والتسامح معه ومع ممارسيه أحيانا كثيرة، سواء في العلاقات بين المسلمين أنفسهم أو وبينهم ومن يختلف معهم أو يقف في وجه تطلعاتهم. وكذلك أن اللجوء المفرط، الفردي والجماعي، إلى العنف يشكل اليوم أحد سمات سلوك المسلمين أو تيارات ومذاهب وتنظيمات إسلامية كثيرة عاملة في الحقل السياسي، المحلي والعالمي. وربما لم يستسلم المسلمون عامة للاعتقاد بفضيلة القوة وأولوية الرهان عليها في تحقيق الأهداف السياسية في أي حقبةٍ سابقةٍ من تاريخهم، كما هو حالهم اليوم للأسف. وللأمانة، يشاركهم في ذلك جميع الذين خسروا رهاناتهم ومستقبلهم بسبب ضعفهم وتسلط أصحاب القوة الغاشمة عليهم، سواء كانت قوة الاستبداد والديكتاتورية الدموية أو قوة التدخلات العسكرية الفتاكة والرهيبة التي تحصد، منذ عقود، شبابهم وتدمر مدنهم وقراهم الفقيرة.
كما لا يعني ما ذكرت أن الاعتقاد الإسلامي، أو النسخة الحديثة الأكثر انتشارا منه، والتي عمل عليها مصلحون كثر في جميع مناطق العالم الإسلامي، الهندي والايراني والعربي والتركي والأفريقي والآسيوي، من دون توقف منذ أكثر من قرن ونصف، لا يمر بأزمة عميقة. بالتأكيد لا. فلم يكن الاسلام اعتقادا مفتتا، ومن دون مرجعية ثابتة وواضحة للمسلم، أو الذي يريد أن يعتنق الإسلام، كما هو عليه اليوم، حتى أصبح فيه من الصعب على المسلم العادي أن يميز الصحيح من الخاطئ والأصيل من المزوّر، لكثرة ما ظهر من تأويلاتٍ وتفاسير متضاربة، همشّت النص الأول نفسه، وشوشت عليه، كما لم يحصل في أي حقبة سابقة، حتى ليكاد كل مسلم أن يصوغ إسلامه، حسب رغبته ومصالحه. وبينما كان يكفي للاعتراف باسلام الفرد قبل عدة عقود لفظ الشهادة، أي تأكيد الإيمان بالله الواحد وبرسالة نبيه محمد، أصبح أي اختلاف في النظر في أبسط جزئيات الحياة اليومية، التي ليس لها علاقة أصلا بالإيمان، كافية للتكفير وإخراج المسلم من دينه.
كل هذا صحيح، لكن الاعتراف به لا يقدّم لنا أي مساعدة في فهم ما يجري، إن لم نسع إلى وضع هذه المعاينات في سياقها، وفهم شروط حياة المجتمعات وقلقها واضطراب ميزانها، وتضارب حوافز الأفراد العميقة وتشوش وعيهم وإدراكهم. ولا نستطيع أن نفهم الطلب المتزايد على خطاب العنف، بما في ذلك البحث عن مبرّراته في عصور خالية، من دون أن نفكر في الأوضاع التي تجعل من امتلاك العنف ومراكمته أولويةً، للحفاظ على البقاء في مجتمعات تقوم فيها السلطة، وبالتالي المكانة والموقع والموارد المعيشية، وربما حياة الأفراد، على العنف والقدرة على الأذى والدمار.
ما يعني أننا لا يمكن أن نفهم ما تتمتع به اليوم قيم التطرّف من جاذبية، إن لم نبحث عن جذورها في تطرّف الواقع المعيشي نفسه. وبالمثل، لن نفهم “أزمة الإسلام” وما يعيشه من تفتت وتشتت في فكره وسلوك أتباعه، من دون معرفة الإجتياح السياسي لمرجعياته الدينية في كل بقاع العالم، وبشكل خاص في مناطقه الرئيسية في المشرق والعالم العربي وآسيا وأفريقيا وأوروبا ما بعد الاستعمارية. وسوف ندرك بسرعة أن الإسلام المستباح، فكرا وقيما وأخلاقا، أي عقيدة، هو جزء من الاستباحة التي تعيشها المجتمعات العربية وعديد من المجتمعات الإسلامية الأخرى، بسبب انهيار نظمها الاجتماعية، وخيانة نخبها السياسية والثقافية، وتغوّل الدول والسلطات القائمة على عموم مصالح الناس، وتدمير شروط حياتهم الطبيعية. سنجد حتما أن خطاب الحرب الذي يفسر صعود الإسلام السياسي ويغذيه ويصنعه ليس سوى الإنعكاس المباشر والحتمي للحرب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والأخلاقية، وأحيانا للحروب الأهلية الكامنة والمشتعلة التي يعيشها المسلم أو أكثر المسلمين العاديين، في مجتمعاتهم وخارجها، منذ عقود، وتطغى على وجودهم وتسلبهم إيمانهم وإنسانيتهم.
(3)
لكن، على الرغم من كل ما قيل، لا ينبغي أن يُفهم من هذا أن استفحال العنف في حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الدولية أمر لا مردّ له، وأنه لا خيار لنا سوى القبول به والتعامل معه أمرا واقعا أبدا. ما يهدف إليه هذا التحليل هو:
أولا، أن لا نفكر كما لو أن كل مسلم يحمل في حمضه النووي بذور العنف والإجرام والإستعداد الدائم، بسبب معتقده الديني، للعداء للأجنبي وكراهية المختلف وقتله. وهذا ما يوحي به اليوم الخلط السريع بين الإسلام والجرائم التي يرتكبها مسلمون، سواء نسبوها إلى اعتقادهم الديني أم لا للأسف.
وثانيا أن من الممكن للفرد المسلم، متدينا كان أم لا، مقيما في بلده الأصلي أم في بلد مضيف، مندمجا ثقافيا أو قليل الاندماج، متعلما أو غير متعلم، أن يرتكب مخالفات للقانون، ويقوم بجرائم، ويعيث فسادا في المجتمع الذي يعيش فيه، كما يمكن أن يفعل أي فرد آخر غير مسلم، جانح أو قليل الاندماج الاجتماعي، أو غير راض عن القانون القائم، من دون أن يكون لذلك، بالضرورة، علاقة بجوهر الدين الذي ينتمي إليه، تماما كما أن الملحد يمكن أن يرتكب جريمة من دون أن يكون سببها عدم إيمانه بإله. ما يعني أنه يحق للمسلم أيضا أن يعامل كإنسان، يمكن أن يخطئ ويضعف ويشذ ويفسد وينحرف أو أن يكون مريضا نفسيا أو مختلا عقليا، أي أن يعترف له بشرطه الإنساني قبل شرطه الديني، وبصرف النظر عن انتمائه القومي والمذهبي، فالأميركيون البيض الذين قضوا على شعوب أميركا الهندية، والألمان الذين مارسوا الإبادة الجماعية ضد اليهود وجماعات أخرى، ودعاة الاستعمار العسكري والاستيطاني الذين استعبدوا أصحاب البلاد الأصليين، وكثيرون ممن ينكرون المساواة ويمارسون التمييز العنصري في البلدان الديمقراطية الليبرالية إلى اليوم، لا يصدرون في أعمالهم عن اعتقاداتهم المسيحية أو الليبرالية أو الثقافة الغربية، وانما يستخدمونها جميعا للتغطية على سقوطهم في سديم الوحشية الطبيعية العمياء والغرائزية البدائية التي تتحكّم بالصراع في عالم الحيوان المفتقر للعقل ومعنى الخطأ والصواب. والمطلوب محاكمة المجرم نفسه، لا دينه، ولا السلاح الذي يستخدمه، مادّيا كان أم معنويا، حتى لا نقدّم مزيدا من المسلمين المتمسّكين بدينهم وهويتهم وأخلاقياتهم وشعائرهم الطبيعية هدية لأصحاب النوايا الشريرة أو المشاريع السياسية والاستراتيجية الخاصة. أما إصلاح الأفكار والمعتقدات الخاطئة فسبيله النقد والتمحيص والتدقيق والتربية الإنسانية الصحيحة.
وثالثا وأخيرا، أن لا نضيع الهدف، ونتجه مباشرة إلى وضع أصابعنا على المفاصل التي تمكننا من معالجة مصدر السقطات والانزلاقات والتشوهات، لمعالجتها والقضاء عليها. لأنه من دون ذلك لن نتقدّم خطوة في أي اتجاه، ولن يدفع بنا المبالغة في العنف وتوسيع دائرة الإتهام الجماعي، إلا إلى مزيد من العنف، وبالتالي من التأزم والاحتراب والعدمية السياسية والأخلاقية. ولن نستطيع إطفاء الحرائق بإشعال مزيد منها، وإنما بسد الذرائع، حسب قاعدة فقهية شهيرة، وهي كامنة، كما ذكرت، في الأزمة الوجودية المديدة والمتفاقمة التي تغذي جحافل المحتجين والمتمرّدين والمنقلبين على النظام والقانون، وفي شروط حياة الناس التي تدفع إلى التمرّد والانحراف في الجزء الاكبر من العالم اليوم. وهي الشروط التي يعمل على تدهورها، يوما بعد يوم، التحالف المدمر بين نظم الأوليغارشية العالمية المهيمنة ونظم الاستبداد والقهر المنتشرة في معظم بلدان الجنوب وانعدام أي أمل في التغيير أو تحسين الأحوال على المدى المنظور. ولا يتعلق البؤس اليوم بشروط الحياة المادية وحدها. إنه يتغذّى أكثر من الشعور بالتمييز، وانعدام المساواة، والشعور بالإذلال وفقدان الكرامة والأمل بالمستقبل. بهذا المعنى، ما يثير اليأس والقلق والخوف بشكل أكبر اليوم ويعمق الشعور بانسداد الآفاق هو الانهيار الواضح لقيم التضامن العالمي وآلياته، وتخلّي الحكومات المنفردة بالقرار العالمي عن مسؤولياتها ونزوعها إلى تقاسم المصالح والنفوذ والمواقع على حساب الشعوب الضعيفة والمفتقرة لأي قيادة وطنية أو اجتماعية حقيقية.
يتطلب هذا أيضا أن يدرك أصحاب السلطة والقرار في داخل كل قطر، وعلى الصعيد العالمي، أنه لم يعد من الممكن مواجهة التهديدات والمخاطر الكامنة بالإنكفاء على الدوائر القومية أو المحلية، كما لو كانت إقطاعيات مستقلة قروسطية يتحكم بمصيرها سيد وحيد كما يشاء، ولا معالجة الأزمة الضاربة في بعض المجتمعات بمعزل عن الأزمة العامة التي تغذّيها جميعا، وهي أزمة النظام الدولي النابعة هي نفسها من فساد السياسة الدولية وتناقضاتها وتخبط أجنداتها، فنحن نعيش جميعا الآثار المدمرة لفشلنا المحزن كمجموعة إنسانية في المعارك العولمية الرئيسة التي كان علينا ربحها خلال نصف القرن الماضي، أعني معارك الإستقلال وتعميم حكم الدولة والقانون وتثبيته في الأقطار المستقلة، ومعالجة التخلف وتحقيق التنمية الإنسانية والقضاء على آفة الفقر، ثم معركة تعزيز السلام العالمي وتقليص رقعة الحرب.
فما نعيشه اليوم من تطرّف وعنف على مستوى البلدان الفقيرة، والذي لم يعد من الممكن حصره في أماكنه البعيدة، ومنع اختراقه فضاء الدول المركزية، مهما كانت تحوّطاتها الأمنية، ليس سوى من آثار هذا الفشل الكبير، والذي نجم، بشكل رئيس، عن رفضنا التفكير عالميا، وانكفائنا على سياسات التقدم الأنانية القومية والمحلية. ولم يعد لنا اليوم مخرج، إذا أردنا مواجهة المستقبل المظلم المليء بالمخاطر والتهديدات للجميع، إلا أن نتمثل، بالفعل وبالعمق، وليس باللسان فحسب، أننا أصبحنا نعيش، وسوف نعيش أكثر، باضطراد، في مجتمع واحد، وعالم واحد، وأننا أمام إنسان فرد واحد في كل مكان على ظهر المعمورة، تحرّكه المشاعر والمطالب والتطلعات والآمال والأحلام ذاتها بالكرامة والحرية والعدالة والمساواة، بصرف النظر عن ثقافته القومية الخاصة أيضا، أي أننا نعيش في حضارة واحدة وثقافة عالمية. وما لم ندرك هذه الحقيقة، ونعمل بوحيها، سوف نجد أنفسنا أكثر فأكثر غرقى حروب أهلية واقليمية ودولية لا نهاية لها، وضحايا بؤس معمم لا قاع له أيضا.







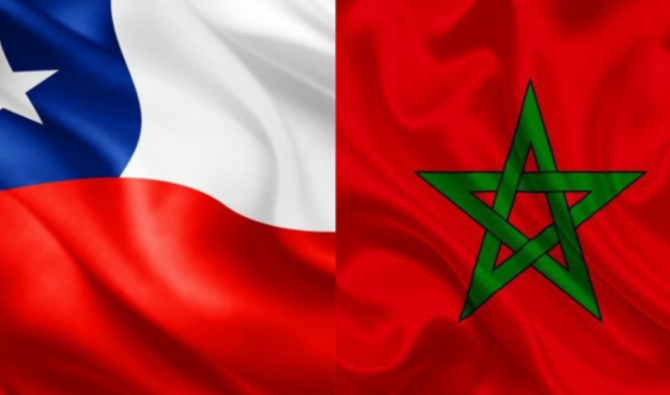







تعليقات الزوار ( 0 )