صورة المعلم (أو أي شخصية) في الإعلام العمومي المغربي لا يمكن فصلها عن صورته في الثقافة الشعبية، إذا سلَّمنا جدلا بأن هذا الإعلام العمومي فعلا يعكس ثقافة المجتمع المغربي، ويجسد هوية المجتمع المغربي بصدق. وحتى لو سلَّمنا جدلا بهذه الفرضية، فإن المصداقية في الإعلام العمومي سواء من خلال البرامج أو الإعلانات أو الأفلام والمسلسلات وغيرها من المواد التلفزيونية، لا تقتضي دائما رسم صورة صادقة لواقع فاسد من شأنه تكريس ثقافة رديئة وفكر سخيف عند المتلقي، بل المصداقية تتعدى نقل تلك الصورة البئيسة كما هي إلى محاولة الارتقاء بوعي المجتمع وبناء الفكر المجتمعي المنشود. فوجود كثير من المضامين والظواهر السلبية في المجتمع كعقوق الوالدين؛ والتدخين؛ والعلاقات غير المشروعة؛ والتمسح بالأضرحة؛ واللجوء إلى السحرة والمشعوذين للعلاج… يجب أن يحملنا على فضحها إعلاميا وفنيا، وتناولها بطريقة نقدية لاذعة تُنَفِّرُ من فعلها وتدعو إلى الابتعاد عنها، لا التصالح معها عبر الأفلام والمسلسلات بحجة أنها موجودة في الواقع، وأن الواقع الاجتماعي يفرض نفسه على الفن. فإذا كان الفن الحقيقي يمتح من ثقافة مجتمعه ولا يمكن عزله عن واقعه الاجتماعي، فإن الأعمال الفنية (السينمائية) تعتبر تمثلا اجتماعيا قبل أن تكون تمثلا فرديا لكاتب أو مخرج أو ممثل، يفرض تصوره الشخصي على عموم المتلقين.
لسنا هنا بصدد شرح نظرية الانعكاس في الفن، ولكن بصدد إبداء رأي في حدود هذا الانعكاس التي يتم توقيرها والالتزام بها حرفيا في قضايا حساسة وفي تناول شخصيات نافذة، وبالمقابل يتم دَوْسُهَا دَوْسَ الحصيد عند تناول قضايا وشخصيات أخرى في القنوات العمومية الرسمية خدمة لأجندة جهات معينة. إن الوظيفة الرئيسية لأي فن هي تهذيب النفس البشرية والسمو بها إلى أعلى مراتب التعبير الجمالي. وقد تحدث الفلاسفة الغرب (والمسلمون) بمختلف مشاربهم عن هذا المعنى العام، وأكدوا بما يشبه الإجماع على أن الهدف النهائي للفن هو إيقاظ النفس وتهذيب الأخلاق؛ ويكفي هنا الاستشهاد بالفيلسوف الألماني “هيغل” في كتابه الشهير “المدخل إلى علم الجمال”. وبالعودة إلى معنى الفن في اللغة العربية، نجد أن “الفن بالمعنى العام هو جملة من القواعد المتبعة لتحصيل غاية معينة: جمالاً كانت أو خيرًا أو منفعة. فإذا كانت هذه الغاية هي تحقيق الجمال سُمِّيَ بالفن الجميل؛ وإذا كانت تحقيق الخير سُمِّيَ بفن الأخلاق؛ وإذا كانت الغاية هي تحقيق المنفعة سُمِّيَ الفن بفن الصناعة“. وبناء عليه، فإن تحري المصداقية في الفن من بوَّابة الإعلام العمومي، لا يجب أن يُنسينا في المبادئ العامة النافعة التي تؤدي إلى تحقيق هذه الغاية النبيلة والسامية، والكفيلة ببناء مجتمع أفضل.
وأمام الإساءات المتكررة لصورة المعلم/المربي بالقنوات العمومية الرسمية، دعنا نسائل أصحاب القرار والمسؤولين عن البرامج التلفزيونية في رمضان بضعة أسئلة تؤرق المشتغلين بالحقل التربوي:
ــ ضمن أية غاية من بين هذه الغايات المذكورة سلفا يمكن إدراج السلسلة الكوميدية “ولاد إيزة” التي تعرضها القناة المغربية الأولى في شهر فضيل: ضمن غاية تحقيق الجمال أم تحقيق الخير أم تحقيق المنفعة العامة للمجتمع؟
ــ ماذا حققت تلك السلسلة وهي تحكي مغامرات امرأة أرملة بالبادية مع زوجتَيْ ابنيها، أحدهما معلم، غير استهداف المعلم والسخرية من رمز من رموز الشرف والبناء في المجتمع؟ هل هذه هي مواصفات المعلمين المغاربة بالقرية الذين درستم على أيديهم، ويعود لهم الفضل في وصولكم إلى مناصبكم؟ أليس هناك معلمون مخلصون ومميزون يقدمون نماذج مضيئة، ويقومون بدورهم على أكمل وجه ويولون الناشئة كل العناية والاهتمام؟
ــ ثم هَبْ أن الصورة البئيسة التي ظهر بها المعلم “علي” في “سلسلة ولاد إيزة” مُمْتَثِلَةٌ تماما لصورة المعلم في واقعنا المغربي، وأن شخصية “علي” تحاكي شخصية حقيقية لمعلم في الواقع الاجتماعي، فهل المطلوب من الأعمال الفنية عند تناولها للمعلم أو أي رمز من رموز الإصلاح والبناء، هو الحفاظ على هذه الصورة البئيسة وترسيخها في البيئة الثقافية دون تطوير للمحتوى، أم المطلوب رؤية فنية تجاوزية تنتقد أداء المعلم مثلا، لكنها لا تُبَخِّسُ دوره ولا تتجرأ على التقليل من شأنه أمام عموم المشاهدين، تارة بنعته بالمعتوه وتارة بوصفه ب”لاصق في الدولة”، وتارة بتصويره بمظهر مثير للشفقة في لباسه وهيئته، وتقديمه للجمهور بشخصية ضعيفة، قليل الحيلة، مما يجعله يحتمي بزوجته أو أمه في أغلب الأحوال لجلب مصالحه والدفاع عن حقوقه؟
ــ كيف نريد لهذا الجيل أن يَشُبُّ على احترام المعلم وهو يراه بهذه الصورة المُجَفِّلة؟ هل سيتعلق الجيل الناشئ بمهنة التعليم وهو يرى أن التعليم بات ملجأ للفاشلين في صورة هذا المعلم؟
ــ لماذا تسعى مثل هذه السلسلة وغيرها من الأعمال الفنية في رمضان إلى تحطيم صورة المربي عند الناشئة، وفي الوقت نفسه تسعى إلى تحبيب شخصية “الكاطورز” لهم في مسلسل “بين القصور” الذي يعرض بالقناة الثانية، وتقديمه لهم كأنه “بروفايل” جديد لشاب منحرف لا تكاد تخلو قطعة في جسده من الوشم، لكنه مرحب به في محيطه وقدوة يحتذى به في مجتمعه رغم أنه يمثل محور الشر كله في المسلسل، بدليل أن فتيات الحي تعلقن به وصرن يتخاصمن فيما بينهن للظفر بحبه. وهو ما حصل بالضبط مع صورة “الشيخة” (عفا الله عنا جميعا) في مسلسل “المكتوب” الذي عُرض في السنة الماضية بالقناة الثانية، وتقديمها في بعدها الإنساني النبيل وإظهارها بمظهر المرأة التي مهما اختلفتَ معها في انحرافها فإنها تفرض عليك احترامها بمعاملتها الطيبة وعلاقاتها الإنسانية المميزة في محيطها، مع تعمد إخفاء الوجه الآخر القبيح والمتمثل في بيع الجسد ومناكر الليالي الحمراء، حتى يتعاطف معها الجمهور المغربي ولا تبقى في عينه رمزا للانحراف والضلال؟
ــ وأخيرا وليس آخرا، هل يستطيع المسؤولون عن الإعلام العمومي بالقناة الأولى والقناة الثانية السماح بمرور سلسلة كوميدية في قادم الأيام، تتهكم مثلا على رجال الدولة أو القضاة أو رجال السلطة (مع خالص مودتنا واحترامنا لكل هذه الرموز والشخصيات) بالدرجة نفسها التي تم التهكم بها على مربي الأجيال؟
إن ترويج محتوى معين عبر الإعلام العمومي في وقت الذروة (ذروة المشاهدة) في رمضان، لا يمكنه أن يكون بريئا مهما أحسنا النية في الحكم على هذا المحتوى، ومهما حاولنا إبعاد تهمة الاستهداف عنه. كما أن ترويج هذا المحتوى في دقائق ليس هو الترويج له في شهر كامل، وليس هو نفسه في سنة أو سنوات كما يحصل مع القصص التي تطرحها المسلسلات المدبلجة، خاصة في ظل الطابع التبسيطي لمحتوى السلسلات الكوميدية أو المسلسلات المدبلجة، والذي عادة ما يستقطب شريحة كبيرة من المشاهدين في القرية والمدينة على حد سواء، نظرا لارتفاع نسبة الأمية في مجتمعنا، ونظرا للهبوط الكبير في المستوى الثقافي وانتقالنا إلى مجتمعات تقرأ بأذنها وتُشَكِّل ثقافتها بالسمع، ويتحكم الإعلام في صناعة وعيها عن طريق استهلاك الصورة النمطية الواحدة.
وتكمن خطورة هذا الترويج لصورة المعلم البئيسة على المدى المتوسط والبعيد في القنوات العمومية الرسمية فيما يلي:
ــ الربط الآلي والتلقائي عند الجمهور المستهلك بين الصورة البصرية البئيسة للمعلم في الإعلام وبين صورته في الواقع، حتى يصبح المعلم مَعَرَّة في مجتمعه، وتصبح مهنة معلم مُنَفِّرة في الثقافة الشعبية ولا جاذبية لها في نفوس الطلاب الباحثين عن وظيفة؛
ــ إسقاط القدوات الحقيقية من عين المتلقي من خلال التشهير المتواصل بالمعلمين ورجال الدين والتقليل من شأنهم؛
ــ تقليص العلاقة الحميمية بين الطلاب والمعلم في ظل تجريده من هيبته وصلاحياته؛ وهذا ما يفسر تجرؤ أجيال اليوم على الآباء والمعلمين والعلماء والفقهاء واحتقارهم لهم؛
ــ المساهمة في رسم ملمح آخر من ملامح الحياة المادية للمجتمع، وتكريس ثقافة النظر إلى الشخص من خلال جيبه وليس لتدينه أو قيمه وأخلاقه، حيث يُراد للناس أن يزنوا المعلمَ بميزان مادي صِرْف بعيدا عن دوره الكبير في التغيير وفي بناء العقول؛
ــ إنتاج نسخ متشابهة من المتلقين (ومنهم تلاميذ وطلاب) تفكر وتتذوق وتستدل بطريقة شبه موحدة، عن طريق التحكم البطيء والتدريجي في قناعات الجمهور وعواطفهم ووجهات نظرهم حول المربين ورجال التعليم؛
ــ إفراغ هذا الشهر الفضيل من أبعاده التربوية المتمثلة في التربية على الأخلاق والقيم، ومنها الإحسان إلى أهل المعروف والخير وعلى رأسهم المعلم عن طريق الإيحاء السلبي في تربية النشء؛
ــ التصالح مع جميع أشكال الانحطاط والتفاهة في الأعمال الفنية، والقبول بأي محتوى فني ـ مهما كان رديئا ـ مادام يضحك الجمهور…
لقد بات الفرق واضحا للعيان بين معلم الأمس ومعلم اليوم، ولم يعد المعلم يحظى بالتقدير والاحترام اللازمين كما كان أيام الزمن الجميل، حين كان للمعلم هيبته في صفوف تلاميذه بحيث لا يستطيع أحد ذكر اسمه حافيا في غيبته دون تجميله بعبارة “سي فلان”، ولا يتجرأ أن يشرب الماء والمعلم ينظر إليه تقديرا له وتبجيلا؛ وحين كان لمهنة التعليم جاذبية كبيرة في صفوف الحالمين بوظيفة إيمانا منهم بأهمية المعلم ونبل رسالته، وتصديقا منهم بأن بناء المجتمعات ونهضتها يقوم على كاهل المعلم. أيام الزمن الجميل، كانت الأسر تتهافت على استضافة المعلم (شأنه شأن الفقيه) في البيوت لمناسبة أو من دون مناسبة، وتتناوب على إطعامه بشكل يومي (نوبة المعلم)، وتستعين به في تربية أبنائها وتأديبهم في تناغم تام وتكامل وافٍ بين البيت والمدرسة في أدوار التربية والتعليم. مثل هذه المواقف وغيرها هي التي كانت تجعل المعلم فخورا بعمله، وتشجعه على تقديم مزيد من التضحيات مع أبناء الشعب؛ ومثل هذه المواقف هي التي تدفعه إلى تحمل المشاق وشح الإمكانات وغياب الظروف التي توفر مناخ العمل، فيقطع عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام قبل الوصول إلى فرعيته النائية، ولا يتغيب عن أداء واجبه المهني إلا لضرورة قصوى.
واليوم لم نعد نسمع عبارات من قبيل “كاد المعلم أن يكون رسولا” و “من علمني حرفا صرت له عبدا”، بل صرنا نسمع من يتكلم عن المعلم كأي موظف يؤدي وظيفته ويتلقى عنها راتبا شهريا، ويعطي لنفسه الحق في الصراخ عليه ومحاسبته، وتوجيه اللوم إليه بسبب ضعف مستوى ابنه أو ابنته… وصار المعلم عرضة للتنكيت والسخرية من قبل المجتمع في جرأة عجيبة عجيبة على مكانة هذا الرسول التي استقاها من تقديره لمهنته الشريفة وتقديره للعلم.
إن المعلم بوصفه موظفا ليس شخصا مقدسا أو فوق المحاسبة والنقد في وسائل الإعلام وفي الأعمال التلفزيونية. فلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبير عن كوارث المعلمين والأساتذة وإساءتهم لقطاع التعليم بأسره، وإن كانوا لا يمثلون السواد الأعظم من المربين المخلصين: الابتزاز الجنسي مقابل النقط؛ تسريب أسئلة الفروض لفائدة تلاميذ الساعات الإضافية؛ مضاعفة الجهد بالمدرسة الخصوصية والاستراحة بالمدرسة العمومية؛ النفخ في النقط تفاديا للمحاسبة من الإدارة… هذا واقع لا ينكره إلا جاحد؛ بيد أن شخصية المعلم الاعتبارية بين الناس تفرض قدرا من الاحترام عند الحديث عنه، وتفرض أن تحظى صورته بالهيبة والتقدير المطلوبين عند تمثيل دوره في الأعمال الفنية لأنه أجل بالإكرام. وما دام هذا المعلم المربي يحمل الإنسانية في صدره ويقدمها علاجا للأجيال، فهو أحق أن تبتعد الأقدام عنه بأمتار خشية أن تدوس ظله، فكيف بأن تدوس الأقلام شخصه وتدوس الأفلام صورته؟!
تمنينا أن تُعرِّف القنوات العمومية الرسمية بوضع المعلم بالقرى والمداشر والجبال، وأن تسلط الضوء على جزء من معاناته مع هذا الجيل، وعلى ظروف اشتغاله المزرية: الاكتظاظ؛ الأقسام المختلطة؛ غياب العدة اللوجستيكية والبيداغوجية؛ التكليف في مادة أخرى غير مادته… وتمنينا من هذه القنوات أن تناقش في حلقات وحلقات كيفية تطوير أداء المعلم وتأهيله باستمرار لممارسة مهنته باقتدار وكفاءة عالية، وتزويده بالمهارات الكفيلة بمواكبة روح العصر… لسنا ضد النقد البناء والهادف، فالمعلم تَعَوَّد على النقد من المفتش، من المدير، بل من تلاميذه وطلابه في نهاية كل سنة حين يطالبهم بكتابة ملاحظاتهم حول أدائه وتعامله معهم.
أيها المسؤولون، مرحبا بنقد وضع المعلم المادي والمهني وحتى الأخلاقي إذا أردتم، لكن وضعه الاعتباري بين الطلاب ووضعه الرمزي في المجتمع يظل خطا أحمر، لأنه باختصار ليس شخصا “لاصق في الدولة”، بل هو عماد الدولة وأساس نهضة الأمة. وصدق الراحل المهدي المنجرة رحمه الله حين قال: “إذا أردت أن تهدم مجتمعا اهدم التعليم، وإذا أردت أن تهدم التعليم فاهدم المعلم”. فرجاء لا تهدموا المعلم باسم الفن، لأنه إذا سقطت القدوة والمرجعية فمن يربي النشء على الأخلاق والقيم؟







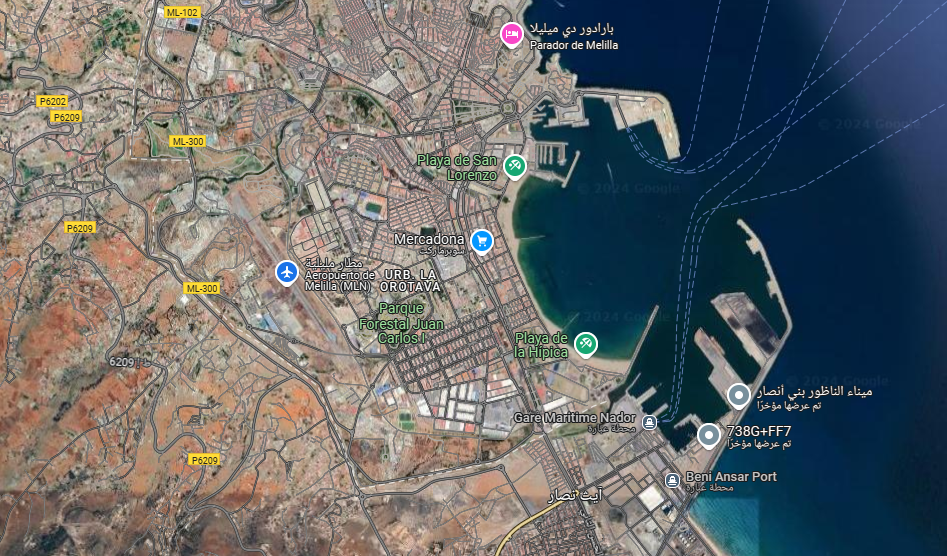







تعليقات الزوار ( 0 )