تعلن منصّة “نتفليكس”، كلّ صباح، عن لائحة البرامج العشرة الأكثر مُشاهدة. يحضر الجنس، غالباً، في نصف الأفلام والمسلسلات. جنس مُقحَم وليس ضرورة درامية، كما في “365 يوماً من الحبّ”، للمخرجين البولنديين باربارا بيالواس وتوماس ماندِسْ، الصامد ستة أشهر في لائحة الأكثر مُشاهدة، التي يتكرّر فيها تحذير: جنس، عنف، تعرٍّ، لغة بذيئة، ممنوع على من هم دون 18 عاماً.
في مقابل هذا النهم لاستهلاك العنف والجنس، يُطالِب المتفرّج المغربي المؤسّسات الإعلامية الوطنية والمخرجين المغاربة بالعفّة والتقوى، وتزييف الواقع. عرض قُبلة بين زوجين على التلفزة المغربية كارثة إعلامية. لكنْ، مرحباً بمُشاهدة القبل فماً لفمٍ على “نتفليكس”.
هذا المعطى ليس افتراضياً فقط. في المغرب، بلغ وباء كورنا أوجّه، ومع ذلك يحتلّ الجنس رأس أجندة النقاش العمومي.
تحاول هذه المقالة الربط بين المُشاهدة وما يجري في الواقع، لأنّه لا يُمكن للنقد السينمائي تجاهل سوسيولوجيا المتفرّجين، في بلدٍ يُجرّم العلاقات الرضائية بين راشِدَين من الجنسين، وتتصاعد فيه الاعتداءات الجنسية على الأطفال. تنعكس هذه الطهرانيّة الوهمية على الفنّ، فتنتصر “السينما النظيفة”. يجري هذا في بلدٍ ينصّ دستوره على أنّه دولة حديثة، تصون الحريات والحقوق. لكنْ، يبدو أنّ التشريع يسبق المجتمع المُحافظ.
يتناول كتاب “علم الاجتماع الديني ـ الإشكالات والسياقات”، لسابينو أكوافيفا وإنزو باتشي، الآثار السياسية والاجتماعية لتحرير الجنس والجسد، وعلاقة ذلك بالدمقرطة ومحاربة التشدّد في إيطاليا منتصف القرن الماضي، في مرحلة صعود أفلام الواقعية الجديدة، التي تصوِّر في الشارع، بدلاً من الواقعية القديمة، التي تُصوِّر في استديو “شينيشيتا موسيليني”.في طنجة، اختَطف شابٌّ طفلاً واغتصبه ثم قتله. عثر على الجثة في 11 شتنبر 2020. ارتفعت أصواتٌ تطالب بإعدام المجرم، وأخرى ضد الإعدام. مع الجدل، هناك نهرٌ من الشتائم حول العنف الاجتماعي والتربية الجنسية. فجأة، تبدّد النقاش المبدئي، وصار القتيل مجرّد ذريعة لتصفية حسابات سابقة بين تيارات تسمّي نفسها سلفية وحداثية. ظهر آلاف الناصحين والمحذّرين، مُعبّرين عن غيرتهم على الأطفال. صرّح قريبٌ من الضحية: “برزت تدوينات ومزايدات لا تحترم حرمة الموتى، وتسعى إلى تصفية الحسابات”.
كلّ أسبوع، يُقتل شخصٌ واحدٌ في المغرب. لا أحد ينتبه إلى الخبر، عندما لا يحضر الجنس في الجريمة. لكنْ، عندما يحضر الجنس، يكثر الجدل. هذا ردّ فعل يُخبر عن اهتمامات أصحابه. حينها، طرحتُ سؤالاً: “على “فيسبوك”، تنديدٌ بالاغتصاب والقتل في طنجة. على “نتفليكس”، أفلام الجريمة والجنس هي الأكثر مُشاهدة في المغرب. هل من يُندِّد هو نفسه من يُشاهِد”؟ لم أتلقّ جواباً. حين يكون هناك نقاشٌ جماعي، يُستحسن عدم تقديم رأي، بل طرح سؤال دقيق يفكّك جماعات الأحكام المسبقة. في الأسبوع نفسه، تمّ هَتكُ عرض فتاة قاصر من أحد أقاربها، لكنّ الحدث مرّ من دون جدل، ولم يتحدث أحدٌ عن الـ”بيدوفيليا”.
بعد أسبوع، ظهرت جمعية تطلب التحقيق في هَتْك عرض طفلة، تبلغ 8 أعوام، في مراكش. لم تظهر تبعات للملف. عندما يكون المغتصَب طفلاً، يرتفع التنديد بالبيدوفيليا. اغتصاب طفلة أمرٌ آخر. يُطرح سؤالٌ عندها: كمْ عمرها؟ يفضح السؤال منطق من يطرحه. سؤال لا يدين ما جرى.
ما الخَطِر بالنسبة إلى المعلّقين: القتل أو الجنس؟ هل الـبيدوفيليا اعتداء على الأطفال ذكوراً وإناثاً، أو هي اعتداء على الذكور فقط؟ اشتدّ الجدل مجدّداً. كلّ من يتحدّث، يصف مخالفيه بالوحشية والحمق والجهل والكفر، ثم يدعوهم إلى الحوار. واضحٌ في هذا الجدل أنّ الأحكام المسبقة، التي يُحرّكها الكبرياء، سابقةٌ على المعلومات. في هذا السياق، رصدت إحدى الصحافيات حالات مناضلين يغلقون الأبواب على زوجاتهم في المنازل، ويصعّدون جدران “فيسبوك” لتمجيد الحداثة والديمقراطية. لا يُمكن لمناضل قبليّ عرقيّ طائفيّ أن يكون حداثياً.
في منتصف شتنبر 2020، ظهرت صُور مُجسّم لسمكتين في حالة قفز، في مدينة شاطئية شمال الرباط. اعتبر الناظرون، المدمنون على الصُوَر الإباحية، أنّ للمُجسّم إيحاءات جنسية، فانطلقت حملة فيسبوكية مظفّرة، انتهت بإعدام المُجسّم. انتصرت شرطة الذوق للفضيلة.
للإشارة: الأفلام الأكثر مُشاهدة على “نتفليكس” في المغرب مُشبعة بالأعضاء الجنسية الحقيقية، لا الموحية. الإحصاءات الإلكترونية تفضح هذا. يتعايش المتفرّج مع الانفصام بسلامٍ. “فيسبوك” لم يصنع الـ”سكيزوفرينيا”، بل يجعلها مرئية فقط. حالياً، تمنح مواقع التواصل الاجتماعي فرصة للظهور. هذا مُفيدٌ لمن يبحث عن جذب العملاء، ولديه ما يبيعه. لكنّ السؤال: هل لدى الفرد عامة ما يُظهره غير وجهه حين يتصوّر، أو لاوعيه حين يتكلّم؟
“فيسبوك” تطبيق فيه صفحات يملؤها الزبائن بسِيَرهم وصُورهم، بعسلهم وقيئهم. تُملأ أيضاً بصُوَر فقيهٍ اغتصب ثماني طفلات وأربعة أطفال، واعتُقل في 17 شتنبر 2020. هنا تغيّرت نغمة النقاش. صار نقاشاً أجوف ومُعتلّاً، لا يُميّز بين المعلومة والرأي. حين اعتُقل الفقيه، أصدرت محكمة طنجة بلاغاً يتحدّث عن موظّف ديني هَتَك عَرض، وفَضّ بكارات. يصعب في المغرب التضحية بفقيه، ويسهل التضحية بأطفال. لذلك، ابتكرت المحكمة لغة جديدة، لأنّ الفقهاء أنقياء مسبقاً وأبداً. وضع الموظّفين مختلف.
تعليقاً على اعتقال الفقيه، تحدّث شيخٌ سلفي، له أتباع كثر، عن الزنى. اختفى الأطفال من الشاشة. الزنى متعة محرّمة ربما يغفرها الله، بينما مُحيت صُوَر الضحايا. برّر الشيخُ الجريمة، حين طالب بشهود لإثبات دخول “المرود في المكحلة”. أين يجب أنْ يكون الشاهد ليرى المرود؟ هذه ماهية الزنى الموجِب للحدّ. أي أنّ الاعتداء على طفلة، تبلغ 10 أعوام، ليس جريمة. حتّى في حال حضور الشهود، فهم من وجهة نظر المحكمة مجرمين. من سيقدّم شهادة ليصير متّهماً؟
من حسن الحظ، أنّ الدولة المغربية تعتمد الفحص الطبي لإثبات الانتهاكات. حالياً، يُمكن لكاميرا أو هاتف تقديم معلومات أكثر من الشهود.
بتعريف البيدوفيليا كزنى، أعاد الشيخ تصنيف العنف، فخفّض من قيمة ما جرى. تمّت العودة بالنقاش إلى نقطة الصفر. ما فعله الفقيه زنى لا “بيدوفيليا”، لكن الواقع مسألة أخرى. هذا مجتمع فيه 8 ملايين عزباء وأزمة اقتصادية، ويُجرّم العلاقات الجنسية الرضائية بين رجل وامرأة، ويُصنّف حصول عاملة جنس راشدة على نقودٍ بشكل إرادي “تجارة في البشر”. نتيجة الانسدادات الـ3، تتصاعد ممارسة الاعتداء جنسياً على الأطفال. عادة، يُتّهم السياح بالـ”بيدوفيليا”. في زمن كورونا وعزلتها، توقّفت السياحة، فرأى المجتمع المغربي وجهه الحقيقي في المرآة.
بين البيدوفيليا ووقف تجريم العلاقات الرضائية، أيهما أقلّ ضرراً؟ مطلوب جواب عاجل في مجتمعٍ يتأخّر فيه الزواج، وتوقف الشرطة العشّاق، فيتمّ استغلال الأطفال جنسياً. الأرقام الحقيقية أكبر مما تقوله وسائل الإعلام، فغالباً ما يُطمس ما يجري داخل الأسر، خوفاً من الفضيحة.
النتيجة: مُستقبل المُشاهدة اللذيذة التعويضية على “نتفليكس”، ومستقبل التابوهات، يزدهران في هذا البلد.




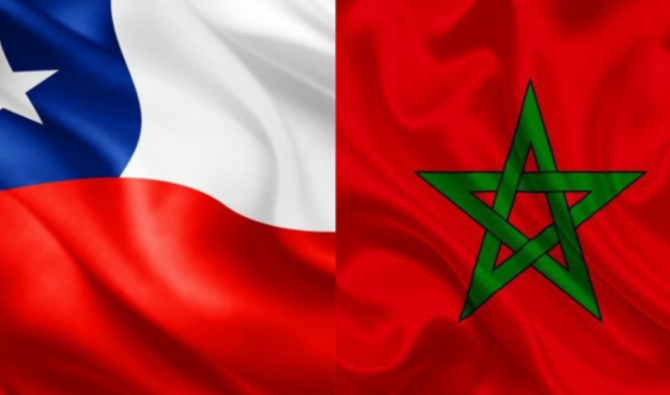










تعليقات الزوار ( 0 )