لعل أبرز التأثيرات المدمرة لجائحة (كوفيد-19) تزايد المخاوف من الإصابة لدى كثير من المواطنين، بيد أن هناك أيضًا تطورات تتكشف سريعًا، مثل إضفاء الطابع الأمني على الوباء، وهو ما يحتاج إلى مزيدٍ من الدراسة والفهم لأنها تؤثر على مستوى معيشة المجتمعات وأمنها بشكل يومي. تُبرز المتابعات الفاحصة منذ تفشي المرض أول مرة في الصين نهاية العام الماضي “أمننة” وعسكرة المفهوم، بحيث أضحى يمثل أكبر تهديد أمني في عالم اليوم. أضحى من المعتاد في لغة الإعلام والسياسة وصف الاستجابات بأنها “إعلان حرب” بالمعنى الرمزي والعملي. تبدو الأجواء وكأننا أمام مسرح عمليات عسكرية في بعض الدول الأجنبية، حيث تتم تعبئة قوات الشرطة والجيش، وتُغلق الحدود، وتُفرض رقابة مختلفة الدرجات على المواطنين، حتى أضحت حالة الطوارئ الوطنية في كثير من البلدان هي الوضع الطبيعي الجديد. بيد أن الأخطر من ذلك كله هو توسيع مسرح العمليات ليشمل المجال المجتمعي العام، حيث فرضت سياسات التباعد الاجتماعي مفاهيم جديدة، مثل النظر إلى الآخر على أنه “تهديد”، وهو ما يستوجب أن يتحصن الجميع بمنازلهم من أجل البقاء.
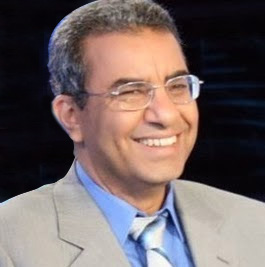
لقد تم رسم خطوط معارك جديدة بشكل يستدعي الانحيازات العرقية القديمة وأجواء التحولات الكبرى التي شهدها العالم من قبل. كما هيمنت مفاهيم الأمن على لغتنا اليومية من خلال استخدام مصطلحات “الحرب” و”المعركة” و”الهجوم” و”الدفاع” و”الجيش الأبيض” الذي يرمز للأطقم الطبية في الصفوف الأمامية، وهو ما يُعزز الجو النفسي للعمليات العسكرية. أضف إلى ذلك فإن فشل المؤسسات النيوليبرالية قد أعاد الاعتبار لمفهوم الدولة المتدخلة، ومنحها سيطرة مطلقة على الاقتصادات باعتبارها الملاذ الأخير للسلطة المجتمعية. لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تم تعزيزه بقوانين الطوارئ التي تمنح سلطات غير محدودة تقريبًا للشرطة والجيش، بل إن بعض زعماء الدول يتصورون أنفسهم كقادة “زمن الحرب”. في العديد من الدول، بات النموذج الصيني في الاستجابة للجائحة يعني الميل طوعًا إلى نمط الدولة المهيمنة، مع العودة لمركزية السلطة كمبررات لإعلان الانتصار النهائي على العدو. لقد بات من الواضح تحول المجتمع العالمي إلى عقلية الحصار كما لو كان تحت الاعتداء من قبل القوى المعادية الخفية.
ماذا يعني ذلك كله بالنسبة لإفريقيا؟ لأول وهلة يبدو الأمر كارثيًّا بالنسبة لمعظم البلدان الإفريقية التي ليست لديها بنية تحتية صحية مناسبة وفعالة. لقد انتشر المرض المستجد منذ ظهوره لأول مرة في إفريقيا خلال شهر فبراير الماضي ليشمل جميع أنحاء القارة في وقت قصير جدًّا. وعلى الرغم من ذلك يذهب بعض علماء الأوبئة إلى القول بأن الدول الإفريقية لديها خبرة طويلة في الاستعداد والاستجابة لتفشي الأوبئة، ابتداء من الإيبولا وحمى ماربورغ ومرورًا بالحمى الصفراء وانتهاء بالحصبة والكوليرا، وهو ما يعني إمكانية تعلم الدروس والبناء عليها. وفي خضمّ الجدل حول تأثير جائحة مرض كورونا المستجد على إفريقيا يمكن التمييز بين روايتين أو رؤيتين تعكسان حقيقة الانقسام المعرفي حول موقع إفريقيا في تطور النظام العالمي.
سردية الخطاب الاستعماري الجديد:
منذ تسارع وتيرة انتشار مرض كورونا المستجد في إفريقيا، كانت الرواية الرئيسية في وسائل الإعلام الغربية حول إفريقيا وجائحة (كوفيد-19) تتساءل عما إذا كانت إفريقيا -وفقًا للتصور الغربي الغالب بانحيازاته المعرفية الموروثة- قادرة على التعامل مع هذا الوضع. ثمة تشكيك طبقًا لهذه الرواية في قدرة الأفارقة على مواجهة الأزمات عمومًا، وتلك الجائحة على وجه التحديد، وأنهم بحاجة إلى مد يد العون الخارجي إليهم. وعلى أية حال فإن هذه الرؤية أو الرواية تتجاهل بشكل كبير تجربة إفريقيا في مواجهة الأوبئة، مثل مكافحة إيبولا الناجحة، حيث كان لمعرفة عامة الناس وقدراتهم على التكيف دور مهم في المواجهة المجتمعية.
يعيد هذا الخطاب الاستعماري الجديد إلى الأذهان الخبرة الغربية ومفاهيم التفوق العنصري في إفريقيا، حيث تم التعامل مع الأفارقة كفئران تجارب لصالح الإنسان الغربي. لقد أعاد “جان بول ميرا” -رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى كوتشين في باريس- الاعتبار لهذا الخطاب من خلال اقتراح إجراء اختبارات التطعيم ضد فيروس كورونا في إفريقيا، حيث لا توجد أقنعة ولا علاجات ولا إنعاش. يستند منطقه الاستعماري الذي وجد ترحيبًا من بعض النخبة الطبية في باريس إلى أن المستويات العالية نسبيًّا من الحماية التي يتمتع بها السكان الأوروبيون في العزل الصحي تعني أنه سيكون من الصعب قياس فعالية مثل هذا التطعيم الذي كان يُستخدم من قبل لعلاج الملاريا.
بغض النظر عن هذا الوجه القبيح لهذا الخطاب الاستعماري، فإن هناك رؤية تشاؤمية أخرى تشير إلى أبعاد الكارثة القادمة إلى إفريقيا جراء انتشار جائحة كورونا. إن أوضاع معظم البلدان في إفريقيا غير مواتية في العديد من المجالات، سواء من حيث احتياجات النظافة الأساسية أو البنية التحتية الصحية. كما توجد عوامل أخرى مهمة ومثيرة للقلق هي وجود الأشخاص الذين يعيشون في ظروف غير مواتية في المدن الكبرى، وكذلك مجتمعات النازحين واللاجئين في البلدان الإفريقية ولا سيما جنوب الصحراء الكبرى، الذين أجبروا على الهجرة إلى بلدان أخرى والعيش في بيئات غير معقمة في المخيمات. إذا انتشر الفيروس في هذه المناطق، حيث يكافح هؤلاء الأشخاص في المخيمات من أجل الحياة، فإن النتائج بالنسبة للدول المضيفة والمجتمع الدولي قد تكون كارثية.
وتعاني أنظمة الرعاية الصحية في إفريقيا بشكل عام من نقص التمويل وقلة التجهيز. لقد دفع الصراع العنيف وتغير المناخ والكوارث الطبيعية نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء القارة إلى العيش في مخيمات سيئة الخدمة ومزدحمة باللاجئين والنازحين داخليًّا، حيث يكون التباعد الاجتماعي أو حتى غسل اليدين أمرًا مستحيلًا. كما يحوّل الفقر عمليات الإغلاق والعزل الصحي إلى حكم بالإعدام. فضلًا عن ذلك فإن انعدام الثقة بالحكومة في هذه المجتمعات يمثل بيئة خصبة لترويج الشائعات وانتشار المعلومات الخاطئة.
وتشير بعض التقديرات للسيناريو الكارثي مع تباين الفصول المناخية في القارة، إلى أن ربع أو أكثر من السكان الأفارقة يمكن أن يصابوا، أي يمكن أن يصل ذلك إلى نحو 250 مليون حالة، وهو احتمال مرعب. لا توجد إحصاءات دقيقة على مستوى القارة حول عدد أجهزة التنفس أو وحدات العناية المركزة، لكن التقارير الجزئية ترسم صورة قاتمة للخدمات المتاحة. في العديد من القرى والمجتمعات النائية، قد لا يكون هناك طبيب واحد. بشكل عام، يوجد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أقل عدد من الأطباء لكل عشرة آلاف نسمة، وهي إحصائية شائعة الاستخدام لقياس جودة الرعاية الصحية في بلد ما. فعلى سبيل المثال، يوجد في إيطاليا طبيب واحد لكل 243 شخصًا، أما في دولة مثل زامبيا فإن النسبة هي طبيب لكل عشرة آلاف شخص.
سردية خطاب “إفريقيا تستطيع”:
إن سرد الكارثة المحتملة التي ستأتي على إفريقيا -وفقًا للخطاب التشاؤمي الغربي ومن شايعه- يقلل من أهمية الخبرات الإفريقية المتراكمة في التعامل مع الأوبئة من ناحية، والخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في الاستجابة للأزمة من قبل المؤسسات الوطنية والقارية الإفريقية من ناحية أخرى. إن سيناريوهات تأثير جائحة كورونا على إفريقيا ليست قاتمة تمامًا. لقد تعلمت العديد من الدول بالفعل من التجارب السابقة في تعاملها مع فيروس إيبولا، وتصرفت بسرعة لإجراء فحوصات درجة الحرارة، وإلغاء الرحلات الجوية الدولية، وفرض إجراءات عزل على أولئك الذين تظهر عليهم أعراض المرض، وربما تساعد هذه الإجراءات بعض البلدان على تأخير وصول (كوفيد-19).
ورغم ذلك، من الصعب الإجابة عما إذا كانت الدول الإفريقية ستتمكن من تغيير منحنى انتشار المرض التصاعدي بعد أن يبدأ في الانتشار محليًّا بين سكانها. وتقوم العديد من الدول بتبني استراتيجيات مبتكرة لاحتواء انتشار المرض. ربما تستفيد البلدان الإفريقية أيضًا، في أفضل سيناريو، من بعض فوائد المناخ والتركيبة السكانية الفريدة للقارة. إذ يأمل علماء الأوبئة أن يكون فيروس كورونا، مثل الإنفلونزا الموسمية، أقل قابلية للانتقال في درجات الحرارة المرتفعة، وعلى الرغم من أننا لا نعرف على وجه اليقين، فقد اقترح بعض الخبراء أن المناخ الحار نسبيًّا في القارة قد يساعد في تفسير الانتشار البطيء للفيروس عبر إفريقيا.
وتُعد التركيبة السكانية للقارة مصدرًا محتملًا آخر للتفاؤل، حيث إن إفريقيا قارة فتية. ومن المتعارف عليه حتى الآن، أنه على الرغم من كون فيروس كورونا معديًا وينتشر بسرعة عبر المخالطة، فإنه غالبًا ما يكون بدون أعراض أو بأعراض خفيفة ومتوسطة بين الشباب. نحو 70% من سكان إفريقيا تحت سن الثلاثين. كما أن نسبة 4% فقط من السكان فوق 65 سنة، وهي الفئة العمرية الأكثر تعرضًا للخطر. ونظرًا لأن هذا الفيروس يصيب الأجيال بشكل مختلف تمامًا، فمن الممكن أن تختلف تجربة إفريقيا مع فيروس كورونا اختلافًا كبيرًا عن تجربة العالمين الغربي والآسيوي.
ولعل أحد الجوانب المهمة في الاستجابات الإفريقية لجائحة كورونا تتمثل في المنظور القاري الإفريقي. على عكس الخبرة الأوروبية، كان الاتحاد الإفريقي خلال الفترة الماضية فاعلًا في توفير الخبرة والمعلومات والتنسيق بين الحكومات والمواطنين بشأن كيفية الاستجابة لانتشار الفيروس الذي لا يمكن إنكاره. ففي الوقت الذي رفعت فيه معظم مناطق العالم منطق السيادة الوطنية، شهدت إفريقيا صعودًا غير متوقع للأممية والجامعة الإفريقية بشكل يتطلب الاهتمام والدعم.
واستطاع الاتحاد الإفريقي التحرك من خلال المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها رغم أنه لم يبدأ إلا منذ ثلاث سنوات فقط. عندما تم الكشف عن فيروس كورونا المستجد لأول مرة في الصين في ديسمبر 2019، بدأ المركز العمل بشكل وثيق مع منظمة الصحة العالمية ومراكزها دون الإقليمية من أجل دعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في استجاباتها للانتشار المحتمل للفيروس. ومنذ ذلك الحين، قام الاتحاد الإفريقي بأداء خمس وظائف على الأقل يعزوها علماء العلاقات الدولية إلى المنظمات الدولية: التنسيق ووضع المعايير، والخبرة، والدعم الفني، ووضع جدول الأعمال العام، بالإضافة إلى تعبئة الموارد.
فأولاً قاد الاتحاد الإفريقي عددًا من الاجتماعات المهمة التي أدت إلى التنسيق ووضع المعايير المشتركة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي. ففي منتصف فبراير 2020، التقى وزراء الصحة الأفارقة في اجتماع طارئ للاتفاق على استراتيجية قارية لمواجهة انتشار الفيروس المحتمل في إفريقيا. كما عقد وزراء المالية الأفارقة اجتماعًا افتراضيًّا في مارس ناقشوا فيه العواقب المالية المحتملة للفيروس وطرق معالجتها. وفي أواخر مارس، عقد الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوسا”، اجتماعًا افتراضيًّا لمكتب الاتحاد الإفريقي حيث قرر إنشاء صندوق إفريقي لفيروس كورونا.
ويقدم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا خبرة مهمة للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ومواطنيها. وكجزء من الاستراتيجية القارية، تم تشكيل فريق عمل إفريقي لمكافحة الفيروس لإعداد استراتيجيات وبيانات وتدريبات في ستة مجالات فنية تتراوح من المراقبة إلى الإدارة السريرية للحالات الإيجابية وتوقع المخاطر.
وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من أجل الاستجابة لانتشار الفيروس. قام المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض بتنسيق توزيع أجهزة الفحص وكذلك الإمدادات والمعدات الطبية المتبرع بها للدول الأعضاء.
ويقوم مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا ومؤسسات الاتحاد الإفريقي الأخرى بحملة واضحة للتوعية العامة من خلال قنواتها على فيسبوك وتويتر، ومن خلال المنشورات المطبوعة، بهدف خلق الوعي وتوفير المعلومات للمواطنين الأفارقة حول أنماط العدوى أو استراتيجيات الرعاية والوقاية.
وقام الاتحاد الإفريقي بدور مهم في تعبئة الموارد من أجل مكافحة تفشي هذه الجائحة. فقد تم تمويل الصندوق الإفريقي لفيروس كورونا بمبلغ 12.5 مليون دولار أمريكي كتمويل أولي له. وإن كان الصندوق يهدف كذلك إلى جذب انتباه المجتمع الدولي والجهات المانحة.
ولم يقف الأمر عند مستوى التنظيم القاري الإفريقي، وإنما قام رؤساء دول وحكومات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بالاجتماع الافتراضي عبر الإنترنت لمناقشة تداعيات كورونا وسبل الاستجابة. وبالمثل اجتمع وزراء الصحة في الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بشكل طارئ في باماكو (عاصمة مالي) لتنسيق الجهود الإقليمية من أجل الاستجابة لتفشي مرض كورونا المستجد.
التحديات الجيوستراتيجية:
إن عالم ما بعد كورونا في إفريقيا سوف يختلف يقينًا عما قبله. ربما تكون العواقب في مجالات الاقتصاد والسياسة والأمن أكثر حدة من الجوانب النفسية والاجتماعية التي سوف تعاني منها الشعوب الإفريقية. قد نشهد وجهًا مستبدًّا للدولة الإفريقية على الرغم من عجزها عن تقديم الخدمات العامة. ومن المحتمل كذلك أن تتراجع وتيرة الإصلاحات السياسية بحجة مواجهة العدو غير المرئي. يؤكد هذا المنحى شواهد تأجيل الانتخابات الإثيوبية المثيرة للجدل، وقسوة تعامل الجنود في كل من كينيا وزيمبابوي مع الجماهير لفرض الإغلاق الصحي.
هناك دول مُصدّرة للنفط (مثل: الجزائر، وليبيا، ونيجيريا، وأنغولا، والكونغو، والجابون، وغينيا الاستوائية) يعتمد دخلها على النفط، ولسوف تتأثر بشدة على المدى القصير جراء انخفاض الأسعار بشكل لم يسبق له مثيل على مدى العقدين الماضيين. وقد اقترنت هذه الأزمة بالانخفاض السريع في الطلب على النفط في الصين حيث ظهر الوباء، مما حرم البلدان الإفريقية المصدرة للنفط المرتبطة بهذا البلد من مصدر دخلها الرئيسي.
ربما يكون الضرر الذي تُسببه جائحة كورونا بالاقتصاد الإفريقي في المدى المتوسط أشد بكثير من تأثيره الصحي. في الوضع الحالي، فإن الاتجاهات السلبية في أسواق الأسهم، وأسعار السلع، وقيمة العملات الوطنية وأسعار الفائدة، بالإضافة إلى منع أو تخفيض التداول الدولي؛ هي العوامل الرئيسية التي تسبب أزمة اقتصادية عالمية. ستحاول الحكومات الغربية التغلب على هذه الأزمة من خلال برامج مساعدة واسعة النطاق للقطاعات المتضررة من تفشي المرض، ولكن ليس من المحتمل أن تقوم الدول الإفريقية التي لا تملك الموارد نفسها باتخاذ مثل تلك التدابير. ومع ذلك، من المرجح أن تتغلب بعض البلدان الإفريقية، ولا سيما البلدان التي يزدهر فيها القطاع الزراعي، على الأزمة بأقل قدر من الضرر نسبيًّا.
من المتوقع كذلك على الصعيد الأمني تكريس أوضاع الدول الفاشلة، واستمرار دائرة الصراع العنيف. وتطرح حالات ليبيا ومالي وبوركينافاسو وموزمبيق، أمثلة للدولة التي تعاني من صراعات عنيفة. ومن المحتمل كذلك أن تحاول الجماعات الإرهابية المدعومة دينيًّا استغلال هذه الجائحة والمصاعب الاقتصادية في تمديد أنشطتها الإرهابية عبر الحدود. ونظرًا لامتلاك الكثير من الدول الفاشلة ثروات طبيعية هائلة، فإنها سوف تكون عرضة لمزيد من تكالب القوى الإقليمية والدولية عليها.
ختاماً لا تزال هناك حاجة ملحة لضمان الاستدامة على المدى الطويل لما تم تحقيقه عبر الخبرات السابقة في مواجهة الأوبئة. إذ تحتاج إفريقيا إلى مواصلة الجهود المبذولة من أجل تطوير الصحة العامة، واكتساب الخبرة والمعرفة العلمية والالتزام السياسي، بحيث يمكن وقف أي تفشٍّ للأمراض المعدية في المستقبل قبل أن تتحول إلى وباء مميت. وفي هذا السياق، تبدو أهمية تبني المنظور القاري التعاوني في المجال الصحي من أجل مواجهة تحديات التهديدات الصحية العامة الحالية والمستقبلية. لقد ظهر جيل جديد من الأفارقة المتحمسين والمخلصين في مجالات الصحة العامة وعلم الأوبئة والرعاية الصحية على مدى السنوات الخمس الماضية، وهم بحاجة إلى الدعم والتمويل المناسب لتمكينهم من المضي قدمًا في تعزيز قدراتهم البحثية والتدريبية. وعليه فإن مستقبل أمن الصحة العامة في إفريقيا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على تطوير هذه البنية التحتية العلمية. ومن جهة أخرى، يتعين زيادة الاستثمارات الحكومية وتلك المقدمة من القوى المانحة للنهوض بأعمال الصحة العامة وفقًا للمستويات العالمية، مع تمكين القيادة الوطنية، وتعزيز شبكة البيانات والمعلومات من أجل تحقيق سرعة الاستجابة في حالة تفشي المرض.
إن وجود استراتيجية طويلة الأمد جيدة التخطيط من قبل الاتحاد الإفريقي يُعد أمرًا لازمًا لتعزيز القيادة الإفريقية لبناء قدرات الصحة العامة والتدريب والبحث. وأيًّا كانت الاستجابات الإفريقية لجائحة كورونا فسوف تطرح مجموعة من التساؤلات المهمة التي ترسم ملامح المستقبل الإفريقي، ومن ذلك: ما هي طبيعة الآثار الجيوستراتيجية للفيروس التي طرحنا بعضها وكيف يمكن مواجهتها؟ وكيف ستتأثر العلاقات الخارجية لإفريقيا؟ وما هي المخاوف الأمنية الجديدة التي سوف ترتبط يقينًا بهذه الجائحة؟
مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المستقبلية















تعليقات الزوار ( 0 )