تعم اليوم كافة أرجاء الأرض، وتقبع في كل مدينة وقرية وبيت، حالة متقدمة من الخوف الفردي والجماعي، توجسا من زائر غريب، لا شكل له ولا ولون ولا رائحة، لكنه في غاية الشراسة حين يتمكن من ملامسة جسم أي إنسان، لدرجة الفتك به حالما توفرت له البيئة اللازمة لتدمير الخلايا والأعضاء، وما يزيد من حجم الخوف، أن وسائل الإعلام ما فتئت تنقل يوميا أخبار المرض والموت واليأس والمدن الموحشة، وتردد كل حين أن هذا الفيروس لا علاج حقيقي له، سوى أدوية تعطل من نشاطه المدمر، ولا وجود للقاح فعلي له على الأقل قبل سنة من الآن، ذلك ما يصرح به الخبراء الذين تتضارب آراؤهم حول كل شيء.
هذه الحالة من الخوف “السائل” كما يصفها عالم الاجتماع البولندي زيغمونت باومان، تُحَوِّلُ الخوف إلى “الاسم الذي نسمي به حالة “اللايقين” التي نعيشها، وهو الاسم الذي نسمي به “جهلنا” بالخطر، وبما يجب فعله لمنع الخطر، وبما يمكن فعله لمنعه وبما لا يمكن فعله، أو بما يمكن فعله لِصَدِّه إذا لم يكن لنا طاقة بمنعه”، وتتطور في هذه الحالة إحساساتنا المضطربة لتغطي على كل حالات القلق والخوف الاعتيادية التي طالما خيمت على حياتنا، ويحل مكانها نمط جديد من الرهاب الاجتماعي، تتغير فيه نظرتنا إلى الآخرين، وتتأسس علاقاتنا مع محيطنا على الشك المتواصل، والتحرز في كل مرة يحاول فيها الآخرون الاقتراب منا أقل من المسافة الآمنة التي فرضتها قيود الإجراءات الصحية التي أضحت القانون الأوحد الذي يحكم العالم، لدرجة أننا لا نستطيع، على الأقل في الفترة الراهنة، أن نمارس دفئنا الإنساني تجاه كل من نحب، إننا نعيش فعلا مرحلة عجيبة، انقلبت فيها روابطنا مع الآخرين من التقارب إلى التباعد، ومن التقدم باتجاههم إلى التراجع أمامهم خوفا من وقوع الخطر.
بل إن علاقتنا بذواتنا قد شابها الكثير من التحول، إذ اكتشفنا لحظة إعلان انتشار الوباء أننا مجبرون على ترويض أنفسنا، والتعود على تغيير طارئ ومهول في عاداتنا اليومية، بناء على الخوف من الانتقال الافتراضي للفيروس بين أطرافنا وأشيائنا وكافة أشكال المادة من حولنا، لقد أضحى الخوف بشكل فجائي وفعلي عاملا محركا لكل علاقاتنا وأعمالنا اليومية، ومبعث قلق وجودي يتحول تدريجيا بسبب حالة اللايقين إلى ما سماه الفيلسوف الدنماركي “سورين كيركيغارد” بالدوار الناتج عن اندهاشنا من العدم.
وانطلت هذه الحالة أيضا على منطق التفكير الجمعي، مع الصدمة النفسية التي تلقاها الناس، حين اكتشفوا ضعف دولهم ومنظوماتهم الصحية ومختبراتهم أمام أخطر جائحة بعد وباء الإنفلوزا الإسبانية سنة 1918 الذي فتك بخمسين مليون إنسان، والمذهل أن هذه الدول ظهرت هشة ومرتبكة في مواجهة الكوفيد 19 الأقل سوءا بعد أزيد من قرن من الزمان، على الرغم من تقدمها العلمي والتكنولوجي الهائل.
ويزيد من حدة الهلع انتشار نظريات المؤامرة، حيث خيمت على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي رؤى وتصورات تتهم دولا بعينها بالتسبب في نشر الوباء، والتعتيم على مسبباته الحقيقية، بل إن البعض استدعى نظريات مؤامرة قديمة ظلت إلى وقت قريب حبيسة صفحات وأدراج المهووسين بتصورات عقائدية خاطئة وسيناريوهات متخيلة لنهاية العالم، فضلا عن تناسل الإشاعات والأخبار المضللة التي تملأ عقول المتلقين بالأوهام والأكاذيب الموجهة.
وإذا كان الوباء قد طال كل طبقات المجتمع، من حيث أنه لا يميز بين الفئات الاجتماعية لمصابيه، فإن الخوف بدوره قد وحد بين كل الناس، مهما اختلفت منازلهم ومراتبهم، وعلى الرغم من التفاوت الحاصل في درجة التعامل مع الجائحة والوعي بأبعادها ونتائجها لدى فئة على حدة، إلا أن الكل ساهم في فوضى الأسواق عبر العالم التي دفع الخوف مرتاديها إلى تبضع هستيري اختفت بعده السلع من الرفوف، بل إن وسائل الإعلام نقلت لنا بكل دهشة صورا لطوابير في الولايات المتحدة الأمريكية اصطف فيها أشخاص لساعات أمام محلات خاصة ببيع السلاح !.
ولم تسلم الدول وقادتها ونخبها من الارتباك الناتج عن شراسة العدو الجديد، فقد أعلنت معظم البلدان دخولها حالة حرب حقيقية، مع ما يستتبع ذلك من إجراءات استثنائية وتطبيق لقوانين الطوارئ، وهو الوضع الذي جر العديد من الانتقادات على الحكومات، باتهامها بالتحول إلى دول قمعية تعطل الدساتير وتتراجع عن مكاسب الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تحت غطاء الحرب على الوباء، أو تستغل الظرف الطارئ من أجل التملص من كل عقودها والتزاماتها تجاه مواطنيها في محاولة منها لإعادة تشكيل إطار جديد لعلاقتها مع رعاياها قوامه التغول والسيطرة من خلال التطبيق الصارم والقسري لقوانين العزل والحجر الصحي، فيما تلتقي هذه الدول نفسها مع نخبها في التعبير عن القلق الشديد من مستقبل العالم الاقتصادي والتخوف من مدى قدرتها على الصمود في مواجهة المشاكل الاجتماعية الجمة التي يتوقع الخبراء مواجهتها بعد انقشاع غيمة الوباء.
وثمة سؤال يستحق التأمل بحسب بعض المراقبين: إذا كانت الدول والسلطات الصحية حول العالم قد استعملت الخوف من انتشار العدوى محفزا كي يمتثل المواطنون لتعليمات وإجراءات الاحتراز الصحي، ألم يأت هذا الخوف أو التخويف متأخرا للغاية في كثير من البلدان ؟ أما كان أحرى أن يتحرك خوف الدول ومواطنيها، فور ورود الأنباء عن سقوط أول الضحايا والمصابين في مدينة ووهان الصينية، بدل الاكتفاء بمتابعة الحدث ومراقبة انتشار الوباء في الصين بل والتشفي والسخرية الساذجة من الموضوع؟
يبدو أن دولا كثيرة توجد في قلب الجائحة اليوم، قد تؤدي غاليا ثمن خوفها “المتأخر”، خاصة وأن المجتمعات التي تشكل مواطنيها و”ناخبيها” قد أخذت تستفيق تدريجيا من هول الصدمة، وأضحت أكثر اتجاها نحو المطالبة برفع قوانين الطوارئ، وتحميل الحكومات مسؤولية التقصير المؤدي إلى الأرقام المفجعة في عدد الوفيات، وقد يقع لها تحديدا ما أشار إليها الكاتب والناقد البريطاني الساخر كريغ براون في كتابه التأريخي “1966 وكل ذلك” من أنه “في كل مكان ترتفع درجة حرارة التحذيرات العالمية، وكل يوم تظهر تحذيرات عالمية جديدة من الفيروسات القاتلة، والموجات القاتلة، والمخدرات القاتلة، والجبال الجليدية العائمة القاتلة، واللحوم القاتلة، واللقاحات القاتلة، والأمراض القاتلة، وغيرها من الأسباب الممكنة للموت الوشيك، وكانت هذه التحذيرات مرعبة في أول الأمر، ولكن بعد فترة بدأ الناس يستمتعون بها”.
فهل يتحول التطبيع مع الخوف إلى شرارة لتغيير قادم في الخريطة الاجتماعية والسياسية العالمية ؟ الجواب لن يتأخر بالتأكيد !.
*كاتب صحافي






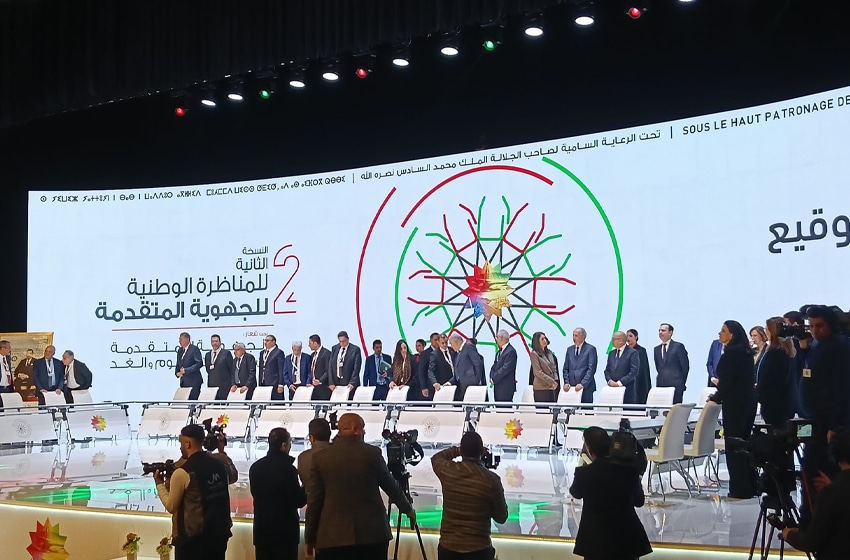








تعليقات الزوار ( 0 )