عناد القيادة الجزائرية واستعصاء ذهنية العسكر الجزائري، وليد تيارات الاستقلال والحرب الباردة، كان أحد أهم خلفيات لغة الخطاب الملكي لعيد العرش تجاه الجزائر. كانت لغة هادئة ومتوازنة وربما تبدو متنازلة عن بعض أي شروط أو ضغوط، داعيا إلى حوار مباشر دون وسائط ودون السماح لأي جسم دخيل بالتأثير في هذا الحوار.

وأتصور أن هذا الجسم الدخيل، الذي ربما تعمد الخطاب تركه مجهولا أمام القراءات.
لن يكون هو عناصر البوليساريو لاننا في المغرب، نعتبرهم في آخر المطاف أبناء المغرب الذين ضلوا الطريق وهم من أهل الصحراء المغربية وليسوا دخلاء على المنطقة. ذلك يوحي بأن هذا الجسم الدخيل نفترض أن يكون هو الاستعمار بشقيه الفرنسي والإسباني أو هو جزء من منظومة أوروبية، بما فيها ألمانيا، تصطاد في الماء العكر بين البلدين.
وفي محاولة لقراءة سياق البيئة السياسية الإقليمية والدولية الحالية للبلدين، فإن من الخلاصات المركزية التي يمكن الوثوق بها هي أن التسويات السياسية الكبرى بين الدول، لإنهاء القطائع وخلق التحالفات الصلبة، لا تمر بالضرورة عن طريق التفاهمات الاقتصادية أو التعاون العسكري، وإنما هي ممكنة عن طريق القوة الناعمة أيضا، لاسيما أمام قيادة عسكرية جزائرية متعددة التيارات الوليدة عقب استقلال الجزائر. تيارات بعضها موال لفرنسا وبعضها عروبي قومي، وبعضها تقدمي وبعضها وريثا لجمعية العلماء والكشافة الإسلامية، مما خلق تصدعات وتطاحن داخلي كبير من أجل السيطرة على جهاز الدولة، و ولد نفسيات تحرك القرار السياسي وتخلق عداء غير سهل التفكيك.
عموما قد تكون البراغماتية الاقتصادية المعبر عنها صراحة من قبل دولتين، من خلال البحث عن الأرباح، حلا لمشاكل سياسية عالقة. ومع ذلك فهي ليست دائما الحل الأمثل للمشاكل المتعددة بينهما. في كثير من الحالات تظهر بوادر الحلول في مفاتيح، مهما بدت صغيرة ومهمشة، إلا أنها فعالة ومؤثرة بإمكانها تغيير مسار شعوب بأكملها، لسبب بسيط وهي أنها تزيل لغة الاستعلاء والأفضلية بينها وتتفهم نفسيات كل جهة.
الذهنيات السياسية المستعصية على تمرير قناعات الوحدة والتوافق والانفتاح، يمكن أن يتم الإلتفاف حولها، عبر ممر الحوار والاعتراف بالتلاقح الثقافي بين الشعبين. وهنا لا بد من التدقيق في الفاعل الثقافي، ودوره الذي تم تغييبه، في مد الجسور.
شعوب المنطقة تكره من يحتقرها ويزدري تقاليدها و ثقافاتها، فعندها قد تنغلق على نفسها وعلى هويتها، وقد تختار التشبث بقيادة سياسية عنيدة تحافظ على وهم الكرامة، هذا حتى وإن كانت هذه القيادة متطرفة سياسيا تصب مزيدا من الزيت على نار الأحقاد الثقافية مع دول جارة.
وعندما نتحدث عن الحوار الثقافي والفكري الشامل بين المغرب والجزائر ، فهو ذلك الحوار الذي يقوده المثقفون باستقلالية عن التسلسلية الرسمية. بمعنى أنه غير خاضع لهياكل وزارات الخارجية أو مبني على اتفاقات سياسية. هذا الحوار تعتمل فيه قناعات هوياتية مشتركة وتمليه رغبات تجاوز الانغلاق، وتترسخ فيه قناعة المصير المشترك، بعيدا عن عقلية التسيد الثقافي لجهة على أخرى الذي ترفضه كرامة الشعوب.
ولعل محاور هذا الحوار مفتوحة، تمتد من القراءات الفكرية والنظرية، العقدية والفقهية للدين المشترك، وأيضا التاريخية والاقتصادية وغيرها إلى جميع السلوكات الثقافية الاجتماعية، من هندام وطقوس للطعام والعمارة والشعر والأدب و الفنون و الرياضة وغيرها.
ولا يخونني الحدس إذا افترضت أن أزمة العلاقة بين المغرب والجزائر، تكاد تكون في عمقها أزمة اعتراف ثقافي متبادل، أو أزمة ثقة ومصالحة ثقافية، التي لن تحسمها السياسة بالمطلق، وإنما علاجها لن يكون سوى في محراب المثقف المغاربي.
ولأعطي مثالا على وجود رفض ثقافي متبادل بين المغرب والجزائر، والذي لا شك طعمه الاستعمار الفرنسي، أستدعي ذاكرتنا للنظر في مراجع الاختلاف الفقهي الإسلامي بين البلدين، باعتبار الدين محركا نفسيا وعصبيا للثقافة وللسلوك الاجتماعي للشعوب، أكثر من أي عامل آخر.
وهو، أي الدين، من جهة أخرى تمارس على أساسه بعض السياسة في المنطقة، وهو أحد نقاط الاختلاف الجوهرية بين البلدين. لا أذكر أننا فتحنا الحوار بشأنه بين البلدين، عكس الحوار الفقهي والديني بين المغرب وتونس أو مع دول إسلامية وعربية مشرقية.
ولعل أحد الأسباب هو غياب بنية علمية عريقة في الجزائر تعيد إنتاج قيم الإسلام، كما هو الشأن من خلال جامعة الزيتونة في تونس والقرويين بالمغرب.
خلال القرن الماضي وتحديدا مع مطلع الثلاثينيات منه، عندما أسست جمعية العلماء في الجزائر على يد الشيخ عبد الحميد بن باديس والشيخ البشير الإبراهيمي وغيرهما، امتدادا لنادي الترقي الذي أسس في أواخر العشرينيات، وقد كان محرك هؤلاء العلماء مدارس فقهية ومذهبية سلفية مشرقية سعودية ومصرية تخرجوا منها. كانوا متأثرين إلى حد كبير بالفكر الوهابي والعروبي في نفس الوقت، وهي في عمقها مدارس متناقضة إلى حد ما مع المدرسة الفقهية المغربية المالكية والأندلسية في التدين.
لم يكن أحد من علماء الجمعية متخرج من القرويين أو له علاقات مع علماء المغرب. لم يتأثروا برواد السلفية المغربية الوسطية ذات البعد المقاصدي الإجتماعي، كأفكار علال الفاسي أو بعلماء المغرب، بقدر ما تأثروا كثيرا بالمشارقة أمثال محمد عبده.
كان هاجس الجمعية الرئيسي هو إرجاع شباب الجزائر إلى الدين الإسلامي وإلى اللغة العربية. فقد كان الضرر كبيرا، عرضه لهما الاستعمار الفرنسي، من تدمير ممنهج وواضح وعميق جدا، أفقد الجزائريين جزءا من ذاكرتهم الثقافية والهوياتية وجزءا أكبر من تقاليدهم، التي بدؤوا البحث عنها بشكل غير معلن في الذات المغربية خصوصا مع مجيء عبد العزيز بوتفليقة.
من بين ما قامت به جمعية الشيخ بن باديس أنها ركزت في البداية على إنشاء عدة دور لتحفيظ للقرآن. ثم ساهمت في تأسيس الكشافة الإسلامية، التي تعد مشتلا للثوار الجزائريين. شاركت في إنتاج وجوه ورموز وشهداء الثورة الجزائرية، منها مراد ديدوش و هوراي بومدين وعدة قادة عسكريين.
وكان لافتا أن يسمي الثوار الجزائريون أنفسهم بالمجاهدين، في صيغة غير موفقة بين أفكار الثورة والاشتراكية وبين مفاهيم الإسلام. وهي الصفة التي يحملونها إلى اليوم، معتبرين أن ثورة 1954 هي جهادا دينيا قبل كل شيء، وأن كل الذين قضوا شهداء بالمعنى الديني للكلمة، بل أن وزارة المجاهدين استحدثت منذ الاستقلال و مستمرة في الحكومات الجزائرية إلى حد الآن.
كان الرئيس الراحل التقدمي أحمد بن بلة ضد الجمعية فقام بحلها عندما ترأس الجزائر المحررة. غير أن الرئيس الراحل هواري بومدين، كان معترفا بجميلها و متأثرا بها، ظهر ذلك في عدة قرارات ذات طابع ديني اتخذها كبناء المساجد.
كانت الدولة الجزائرية تعي أن هناك فراغا قاتلا في التأطير الديني، خصوصا في غياب جمعية العلماء المنحلة. لذلك فإن الرئيس الراحل الشاذلي بنجديد، ولملأ هذا الفراغ وبناء على العقدة الثقافية مع المغرب، فضل استقدام عدة دعاة وعلماء كبار من المشرق العربي بدل الاستعانة بعلماء تونس أو المغرب، مما زاد التنافر مع البيئة الدينية والفقهية للمنطقة ومع المغرب تحديدا، ومما ساهم أيضا بنوع من الاندفاع الديني لنصرة قضايا المسلمين. برز هذا على نحو كبير في توجه عدد كبير من الجزائريين إلى أفغانستان بداية الثمانينات، الذين سيشكلون نواة لتنظيمات إسلاموية متطرفة فيما بعد. وكان لهؤلاء العلماء المشارقة تأثير قوي على نخب الجزائر، انطلاقا من جامعة قسنطينة تحديدا.
كان من أبرز العلماء الأزهريين الذين تمت دعوتهم للجزائر، الشيخ محمد الغزالي الذي مر من جماعة الإخوان المسلمين ثم انسحب منها بسبب خلافات في تصور إدارة الصراع أو العلاقات مع الدولة. وقد مكث في الجزائر مدة ليست بالقصيرة، كون خلالها أجيالا وأطرا كثيرة، ساهمت في ظهور الفكر الإسلامي من جديد في الجزائر، وفي نشأة الحركة الإسلامية، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الإسلامي بزعامة الراحل عباس مدني وعلي بلحاج.
بعد ذلك لم يكن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعيدا عن هذا التوجه، أي البحث عن الذات الثقافية. سعى بوتفليقة إلى تعزيز الثقافة التقليدية في الفضاء العام، من خلال فتح المساجد ودعم الطرق الصوفية والزوايا، وإطلاق دروس دينية على غرار الدروس الحسنية، وفتح قناة تلفزية للقرآن الكريم، والاهتمام بالتقاليد العمرانية وحتى في تنظيم الحفلات والأفراح وطرق اللبس والطهي، تشبها بالمغرب إلى حد كبير.
هذه عناصر من جملة عناصر كثيرة تساعد على فهم عقد الجسد الجزائري غداة الاستقلال ومسعى الحركة الوطنية الجزائرية، خلال الاستعمار الفرنسي، من أجل البحث عن ممرات ترجع الشعب الجزائري إلى هويته والى ثقافته وتقاليده، التي طمس جزء مهم منها إبان الخلافة العثمانية ثم جراء الاستعمار الفرنسي الطويلي الأمد.
إلى هذا يمكن أن نضيف المواجهات المذهبية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وهي خلافات ذات عمق ثقافي ايديولوجي سياسي ومعرفي تنموي بين المغرب والجزائر، منذ الحرب الباردة. خلافات بين اختيارات الإشتراكية والحزب الوحيد والدولة الراعية في الجزائر، وبين التعدد الحزبي وبعض مبادئ الليبرالية الاقتصادية كاقتصاد السوق والتقاول الفردي في المغرب، باعتبارها توجهات ثقافية اجتماعية وسعت الهوة بين البلدين والشعبين.
غياب الحوار الثقافي المنتظم والدائم بين البلدين، زاد من حدة الجفاء والنفور وعدم التجاوب السياسي. ولا أذكر أن لهم من العلماء من طلب لإلقاء درس من الدورس الحسنية مثلا، أو للمشاركة في تأطير ندوات دينية أو تكوينية في المغرب، والعكس أيضا صحيح. كما يظهر أيضا الجفاء بين رواد التصوف والزوايا أنفسهم، ليشمل حتى الفنون وباقي الإنتاجات الإبداعية والثقافية.
لذلك يمكن اليوم للمغرب وللمغاربة، أن ينفتحوا من جديد مع الجزائريين في إطار محاولات مد اليد لحوار ثقافي حقيقي ينسجم مع توجهات الخطاب الملكي لعيد العرش، يشمل الدين والأعراف والتقاليد والعمران والخيارات الإقتصادية وتبادل الخبرات والاستثمارات، بدون حزازات استعلائية، بغية اعتراف ثقافي متبادل، قوامه الإحترام والحب الحقيقي بين البلدين والشعبين.
هذا الحوار هو أساس أولي موازي لانطلاق أي اتفاقات مستقبلية في جميع الميادين. حوار ينبغي أن يتفهم العقلية و الذهنية الشعبية الجزائرية التي ترفض أسبقية التعامل المادي الاقتصادي على الإعتراف والمحبة الحقيقية. ذهنية الجزائري الثائر بفعل تراكمات التاريخ تجعله في معادلة إمكانية أن يخسر كل ما لديه في الحرب ضد طرف ما يحتقره ولا يحترمه ثقافيا. في المقابل يمكنه أن يعطي كل ما يملك إذا كان الإعتراف به واضحا وصريحا.
هذه الذهنية هي التي أطرت جزءا مهما من علاقات الجزائر الدولية، خصوصا مع المغرب. فكان جزء من حكام الجزائر لايروقهم نفسيا حفاظ المغاربة على تقاليد عريقة تعطي تفوقا ثقافيا وهوياتيا للمغرب، وقد عبر عبد العزيز بوتفليقة عن ذلك في أحد تصريحاته المصورة وهو رئيس الدولة.
المهم حاليا هو البحث عن معابر ثقافية صلبة للتوافق مع الجزائر من شأنها أن تزيل، أو تخفف أو على الأقل، تمهد للسياسي المرور في حقل من الألغام المزروعة في النفسيات و الذهنيات الثقافية، لتمرير قناعات التعاون والثقة.
هذا الخيار تمليه الحاجة إلى التكتل أمام مخاطر زحف ثقافات مسيسة دخيلة، وأيضا للتصدي لزحف مخيف وغير منفتح على القيم الانسانية، زحف إعلامي سياسي وعسكري، يهدف للسيطرة على المنطقة، زحف لم يطرق باب المغرب الكبير بلطف.
لا خيار في الأفق سوى الجنوح إلى التهدئة فهي سمة العقلاء وهي صفة المغاربة منذ القدم. فإما أن نحافظ جميعا على هوية المنطقة وأن نشترك في خيراتها واستثماراتها وأرباحها ، ونتجنب الاشتباك المميت، وإما أن نجعلها ساحة تنافس خارجي عربي وغربي حاد وقاتل، لذلك فإنه لا ينبغي أبدا أثناء وضع خطط السياسة والعلاقات الخارجية إغفال دور الفاعل الثقافي الذي بإمكانه أن يحسم النزاعات بقوته الناعمة أو على الأقل يخفف من حدتها، خصوصا مع وجود سياق اجتماعي جزائري جديد ومتحرك ضاغط على النخبة التقليدية، يبحث عن ذاته ويميل إلى حلول عقلانية براغماتية وسلمية، حلول تقطع مع عقلية نخب الحرب الباردة التي لم تتغير في الجزائر والمتتاقضة مع نخب وقيادة المغرب الجديدة المتحررة من خطاب الماضي خطاب الستينيات والسبعينيات من القرن البائد.

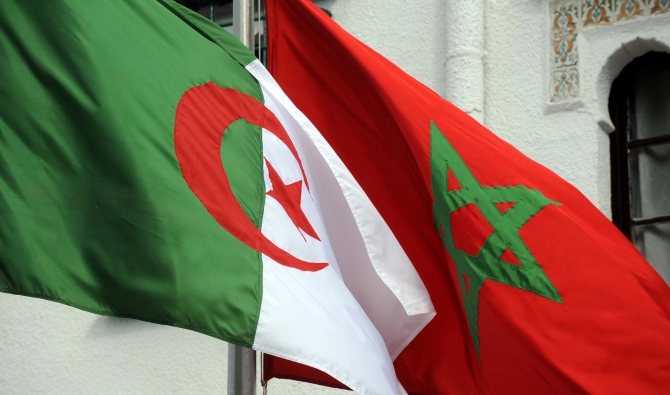













تعليقات الزوار ( 0 )