يعيش الضمير الحقوقي في المغرب لحظة صعبة وقاسية، وهو يتابع صرخات مدرسة من “أطر الأكاديميات”، تقول أنها أصيبت بمرض، بعد اجتيازها لمباراة الدخول لأحد مراكز التربية والتكوين، مرض لم يمنعها من النجاح والتخرج والإلتحاق بمديرية تعيينها، التي كلفتها بمهمة تدريس اللغة العربية بإحدى المؤسسات التعليمية، ثم ألغت تكليفها، بسبب حالتها الصحية، التي لم يطرأ عليها أي تغيير، فقد قضت فترة التكوين أشهرا، ثم التحقت بمقر عملها، وهي على حالتها الصحية المعلومة سلفا.
فما الذي استجد مع تقرير مندوبية الصحة، الذي ورد ذكره في مراسلة المديرية للمدرسة المذكورة؟ والحال أن المعنية تظهر واقفة بشكل عادي، خلال وقفة تضامنية معها، وتتكلم بلغة عربية سليمة، مما يطرح أكثر من سؤال عن وضعيتها الحالية، ويترك الكثير من النقط الغامضة بصددها، فهل تم إلغاء تكليفها بمهمة التدريس، في انتظار تكليفها بمهمة أخرى أم تم فسخ عقد عملها، وذلك طبعا بسبب وضعيتها الصحية التي كانت معروفة سلفا؟
ليست وضعية هذه المدرسة إلا عينة من وضعيات مهنية غريبة، أصبحنا نتابع أخبارها منذ تم العمل بمنهجية تشغيل من يعرفون في صفوف رجال التعليم ونسائه ب”المتعاقدين”؛ الذين تخلف إضراباتهم المتعددة، التي يطالبون فيها بتسوية وضعية المهنية من خلال إدماجهم في سلك الوظيفية العمومية إسوة بزملائهم “النظاميين”، ارتباكا حقيقيا فيما يخص السير العادي لمدارسنا العمومية.
وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فإن الضمير التربوي والحقوقي، لا يمكن إلا أن يشعر بالقلق والأسف لمشاهد المئات من تلاميذ المؤسسات العمومية وهم يجوبون الأزقة والشوارع الخلفية لمؤسساتهم، في أوقات يفترض أن يتواجدوا بها بين جدران حجرات فصولهم الدراسية؛ وذلك بسبب الإضرابات المتتالية التي يقوم بها أساتذتهم الذين يصفون بأنفسهم ب”المفروض عليهم التعاقد”، وتسميهم الخطابات الرسمية ب”أطر الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين”.
ويزداد الوضع حدة وصعوبة حينما يلاحظ المرء هذا التمييز، الذي يعيشه تلاميذ المؤسسات التربوية العمومية فيما بينهم، سواء ما بين تلاميذ القطاع الخصوصي الذين يستفيدون من زمنهم المدرسي كاملا، وبين تلاميذ القطاع العمومي الذين لا يستفيدون منها كما هو حال أقرانهم بالقطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى التمييز بين تلاميذ القطاع العمومي فيما بينهم، بسبب التمييز الحاصل بين مدرسيهم “النظاميين”، الذين يعيشون نسبيا أوضاعا شبه مستقرة و”المتعاقدين”، الذين يخوضون أشكال احتجاجية مختلفة، وفي مقدمتها الإضراب عن العمل؛ هذا طبعا إذا لم يكن المدرس المقول عنه “نظاميا” من حملة الشواهد العليا، أو من فئة من الفئات التعليمية الأخرى، التي تشعر بالحيف والغبن، بسبب مطالبتها بوضعية نظامية أحسن أو ترقية إلى درجة أفضل، مما يضطرها أيضا لخوض إضرابات متعددة، وغير ذلك من المشاكل الكثيرة بهذا القطاع الوطني الحساس.
لا تقل سوءا، مدعاة للأسى والحسرة، مشاهد الصور التي تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية، وهي توثق بالصوت والصورة، بين فترة وأخرى، مشاهد الاحتجاجات بالعاصمة الرباط، وتدخلات القوات العمومية لتفض هذه الأشكال الاحتجاجية، وما يرافق هذه التدخلات من إصابات في صفوف المدرسين، فضلا عن الاعتقالات والمتابعات القضائية، التي تزيد قضاءنا عبئا إضافيا يزداد على الأعباء الملقاة على قضاة المحاكم بسبب تراكم الملفات، فتضاف لهم ملفات يفترض تسويتها على طاولة الحوار والنقاش بين الحكومة في شخص الوزارة المعنية وهؤلاء المدرسين المحتجين.
إذ ما الذي يدفع مدرسا، أجرته منهكة بالاقتطاعات بسبب الإضرابات الكثيرة، وبسبب تكاليف الحياة وأعبائها الاجتماعية من جهة ثانية، إلى أن يتحمل اقتطاعات أخرى مرتقبة، ويخوض الإضراب لأيام، ويتنقل إلى الرباط، وهو يعرف أنه قد يتعرض للاعتقال أو للضرب، أو أنه، في حالة عودته “سالما” إلى مدينته، فلن يعود إلا وهو مثقل بتكاليف النقل والإقامة والإعاشة بالعاصمة؟
يتعلق الأمر بتمييز تعيشه المدرسة العمومية بين صنفين من المشتغلين بالقطاع، بين أطر نظامية تابعة لأسلاك الوظيفة العمومية، وبين أطر تابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ورغم حديث الوزارة عن المماثلة في الحقوق والواجبات، فإن مراجعتنا للنظام الأساسي لبعض الأكاديميات، والذي يؤطر قانونيا وضعية “أطر الأكاديميات”، ومقارنته بالنظام الأساسي المؤطر لعمل الأطر النظامية، نجد تمة عددا من أوجه الحيف.
ومن بعض مظاهر هذا الحيف، أن أطر الأكاديميات تنتهي مسارات الترقية العادية عند سقف السلم11 ، حتى ولو كانوا يمارسون بالتعليم الثانوي التأهيلي، ولا يمكن الانتقال إلى الدرجة الممتازة (= خارج السلم) إلا من خلال مباريات التبريز مثلا. على خلاف ذلك، يمكن لزملائهم النظاميين، أطر التعليم الثانوي التأهيلي ، أن يترقوا، بشكل عادي، وبعد استفاء عدد السنوات المطلوبة، إلى الدرجة الممتازة.
وإذا كان يحق للأطر النظامية، الحاصلين على الدكتوراه، اجتياز مباريات التحويل إلى التعليم العالي، فإن أطر الأكاديميات الدكاترة لا يحق لهم اجتياز هذه المباريات. هذا بالإضافة إلى التمييز المرتبط بالتمثلات الاجتماعية التي ترسخت في أذهان التلاميذ والأسر والأطر النظامية لفئة الأساتذة المعروفين اجتماعيا ب”المتعاقدين”.
لم تخطئ النقابات التعليمية حينما رفضت برنامج “التعاقد” بقطاع التعليم، واعتبرته قنبلة موقوتة تم الإلقاء بها في قطاع استراتيجي بالبلاد، لكننا نعيب على هذه النقابات أنها لم تواكب هذا الموقف الرافض للتعاقد بخطوات نضالية واضحة وقوية، وتتحمل مسؤوليتها المؤسساتية في طرح هذه المعضلة على طاولة الحوار القطاعي مع الوزارة، وعلى طاولة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وعدم ترك هؤلاء المدرسين وتنسيقيتهم الوطنية، يخوضون نضالاتهم بطريقتهم الخاصة، وكأنها قضيتهم وحدهم.
إن قضية هؤلاء المدرسين أصبحت اليوم قضية رأي عام وطني، ومتابعة من طرف الرأي العام الخارجي، الذي يشاهد صور الاحتجاجات والتدخلات الأمنية، والتي تعطي فكرة سيئة عن الوضع الحقوقي بالمغرب. الأمر الذي يفرض الدعوة إلى محاولة جماعية للتفكير في سبل حل هذه القضية.
وحينما نتحدث عن تفكير جماعي فإننا لا نستثني أي فئة من الفئات الفاعلة على الساحة الوطنية، نقابية وحقوقية، وهيئات وطنية رسمية ومدنية، فضلا عن الجهات الحكومية المعنية، ومن دون أن نعفي طبعا المثقفين من هذه المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقهم، والذين تعد مهمتهم الأولى هي التفكير الاستباقي، وتوظيف قوتهم الاقتراحية في النظر في مختلف المعضلات الاجتماعية والسياسية، فضلا عن الفكرية والثقافية، ومن بينها هذه المعضلة التي تهدد استقرار منظومتنا التربوية والتعليمية، ونحسب محاولتنا هذه تدخل في هذا النطاق، تماشيا مع التزامنا الوطني وواجبنا الأخلاقي بخصوص الدفاع عن جاذبية المدرسة العمومية وجودة خدماتها.
ومن بين المداخل التي نقترحها لتجاوز هذه الأزمة اشتغال وزارة التربية الوطنية وشركائها الاجتماعيين، على نظام أساسي جديد للعاملين بقطاع التربية الوطنية، يوحد بين مختلف الفئات التابعة لهذا القطاع، ووضع حد لكل تمييز مهني أو حيف حقوقي بين هذه الفئات، وسيكون مستحسنا إشراك التنسيقية الوطنية لأطر الأكاديميات في مختلف مراحل هذا الحوار.
نظام يتجاوز عيوب النظام الحالي، وينصف الفئات المتضررة، ويقضي على كل أشكال التمييز، ويعيد الاعتبار للتكوين والتكوين المستمر، ويأخذ بعين الاعتبار الترقية بالشهادات الجامعية العليا، تشجيعا للعلم والمعرفة في صفوف الشغيلة التعليمية، وربط ترقيها المهني بالجودة والمردودية بالدرجة الأولى، فضلا عما يتراكم لديها من خبرة مهنية ومعرفية.
لكن، خطوة توحيد رجال ونساء التعليم في نظام موحد، ستبقى غير مجدية، ما لم تجتهد الحكومة والبرلمان على إعادة تعريف مفهوم “الموظف العمومي” ووضع قوانين واضحة، وغير قابلة لأي تأويل سيء ورجعي وتمييزي، بين الموظفين الذين تم توظيفهم بطريقة مركزية، وبين الموظفين الذين يلجون أسلاك التوظيف من خلال مدراج جهوية، واعتبار الجميع منتمين إلى أسلاك الوظيفة، ويتمتعون بنفس الحقوق، كما هي عليهم نفس الواجبات.
*أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء


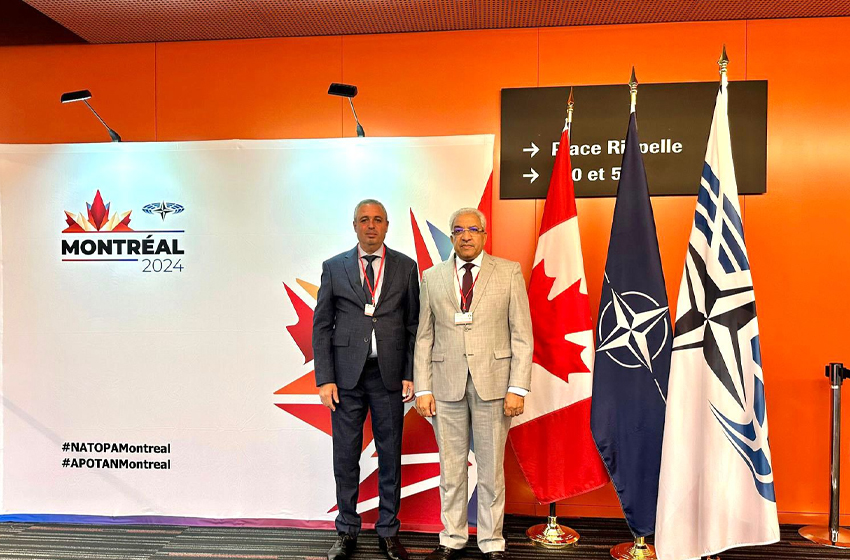












تعليقات الزوار ( 0 )