إهداء إلى المخرج حسن العلوي لمراني في محرابه ديونيزوس
تقديم
إن التميز الذي أقامه سارتر بين التراث الذي ينتمي إلى الرمز، والأسطورة، و الخيال، والصور، والذاكرة، حيث يحمل وعي يتحرك من منطلق إقامة نظرية المعرفة، لذا فمن اللازم على عدم الفصل بين الإثنين، رغم اختلاف المرجعية، لأن البحث في هذا التراث لا ينبغي أن يتخلى عن هذه اللازمة، ويندفع الى لوازم أخرى، كالبحث في صور هذا التراث بصرف النظر عن صحتها، لأن القراءة القائمة على تنوير المسرح كنشاط مقروء يؤسس عادة على ما تنتجه المعارف من ذكريات وما يؤطرها من رموز, وأساطير. فقراءة التراث يتجه دوما حسب حسن حنفي بمسار ظاهراتي[1] .لأنه يستند إلى أصول هو هوسرلية, والتي لا تأخذ بالقول ولا بمبدأ المطابقة, بل تحمل رؤية خاصة, و نظرية معرفية مميزة, من هنا أجد نفسي محصورا بين الفيلسوف والأديب, لذا سأعمل على الحفر البنيوي لمعرفة المرجعية التي جعلت الفيلسوف يندمج في ألأديب و الاديب كيف يندمج في معطف الفيلسوف, لأن سارتر إنسان و فيلسوف وأديب ومناضل, وثوري, استمد شرعيته من خلال قراءاته المتعددة, ومن خلال أيضا مجادلاته للمناهج والتصورات السابقة عنه, لذا اعتمد المسرح كبوابة مفتوحة للمقاومة والإبداع, والمواقف, وجاعلا منه أرضية إنباتيه قادرة على استيعاب الموجود, بلغة درامية لا تركن إلى المألوف, بل تغوص في الممكن المضمر. إذن، كيف قرأ التراث دراميا؟ وماهي المرجعية المعتمدة في هذا الشأن؟
إذا كان كل فرد وليد واقعه مساهم في تأطيره، فإن سارتر كأنه رجل المواقف الفلسفية بجانب ألبير كامو، وقد عمل سارتر بمهاجمة المسرح البورجوازي، والملحمي، والعبثي. حيث يتفق مع بريخت في رفض الفكر البورجوازي ومسرح الدعاية لخلق مسافة مع العواطف ومصالح المرحلة الراهنة، لأن المسرح السياسي الذي يعبر عنه هدف سياسي لا يحمل المتفرجين على الفعل كما يقول كمال فهمي ص 92 في كتابه الفلسفة والمسرح. فالمسرح الفرجوي في بعده التاريخي يأخذ مسافة من الموضوع المطروح من خلال تحوله في الزمان والمكان ويقول في هذا الصدد: إن المتفرج عليه أن يكون في مكانه الاثنوجرافي الذي يعقد بين فلاحي مجتمع متأخر جدا، والذي يظهر في الأخير على أن ما يدرسه هو نفسه[2]. فالمسرح حسب سارتر هو توحد بين الذات والموضوع، وبين مغامرة فردية، لأن بريشت حسب سارتر لم يعالج الموضوع من الداخل بل اعتمد التناقضات الخارجية وليس الصراع الداخلي الذي بناه الفكر البرجوازي لأن مهمة المسرحي هي تحليل التناقضات وتفسير ما لا يفسر دون طرح تقريبي. ويقول في هذا المقام إنه يحل مشكلة الذاتية والموضوعية التي طرحتها الماركسية ومن ثم لم يعرف أيضا بفسح غطاء للذاتية في مسرحية كما ينبغي[3]. فالمسرح الدرامي حسب سارتر هو الذي يجعل المتلقي يفهم وجهة نظر العالم، والإنسان دون استحضار التطهير الأرسطي.
إن مسرح سارتر هو مسرح المواقف وليس مسرح التشاؤم الذي تتغنى البرجوازية في نظره. تشاؤم اللا فعل الذي يحاكم كل المحاولات والإمكانيات وأمال الفرد[4]. وسارتر في هذه الأطروحة يحاول أن يحاكم السائد والمنتشر بين الجماهير لأنهم يلومونه برؤية سطحية دون استعمال العقل ولا النقد الداخلي، بل هدفهم هو استهلاك السائد والانغماس في الغربة والعزلة. لذا عملت البرجوازية على صناعة مثقفين مسرحيين يوزعون وينشرون الخارج دون معرفة ماهية الشيء. فهذا الموقف هو الذي جعل الانسان يخرج من جلباب البورجوازية ليعرض مواقفه لتكون فيها لحظة الاختيار هي الأكثر تأثيرا، وينبغي ان تكون هذه المواقف معروفة لدى المتفرج أي متعلقة بمواقف قصوى تختبر فيها حرية الأنسان كمشكل للغاية وللوسائل المشروعة العنف. ولنتائج الفعل، علاقة الشخص بالجماعة[5] فسارت تقربنا باندماج جديد لا يقاس بالذات، ولا بالحركة بل بالمواقف المتصارعة بين بني البشر، وأن هذه الحياة هي المسرح الذي يمدنا بالاختبارات في اتخاذ المواقف، فهذه المواقف هي المقيدة، تدفع الأبطال إلى اكتشاف أنفسهم كل مرة، حتى يصبح فعل الموقف موضوعا للتفكير كما يقول في كتابه “ما الأدب”، فالمسرح حسب سارتر هو الذي يقوم فيه الإنسان بعرض مشاكله وما على المشاهد إلا المشاركة في هذا الاختبار التمسرحي، وهذه هي “الحرية الإنسانية” التي تؤخذ دائما في ظرف وموقف[6].
إن سارتر يقربنا من دائرة الموقف والحدث، والتناقض، دون الانغماس في الطابع السيكولوجي، بل ينبغي الانخراط في الكون الذي يعيش فيه الإنسان، ويكون الفعل ألأخلاقي والإلزامي هو القاسم المشترك بين الناس. فهذه القراءة على اختلاف مشاربها وعلى اختلاف النظريات التي استعرضها سارتر تتمحور حول قضيتين أساسيتين هما:
قضية الموقف وقضية الحرية وعبرهما تتواجد الذاتية والموضوعية سواء في تحقيق التكامل المسرحي أم في تحقيق دلالته أو موضوعه الجمالي، فهل يمتلك مسرح المواقف وجوده المتحقق دون تدخل الذات المبدعة أو المخرجة؟ وهل يمتلك هذا المسرح هوية أو ماهية أنطولوجية؟ إن الذات المسرحية تدرك كنهها (كماهي) دون أن تكون انعكاسا أو نتيجة لفعل الممثل الممارس. فالمعنى ليس معطى بل موجود ومشكل في الوجود ويجب اكتشافه واستخراجه وتوصيله إلى الآخرين. فالذات المدركة هي التي تبنيه من خلال المعطيات والمواقف، لأنه ليس معطى وليس محددا سلفا بأي حال من الأحوال داخل الماهية، فهذه الحركات لا تغير أبدا الواقع الموضوعي للعالم، فهي ليست أفعالا ما دام الفعل يعرف بالتأثير على تغيير العالم، إن الممثل بكل مأ أوتي من مهارة جسدية. لابد له أن يمسرحها على الخشبة بواسطة حركات وإيحاءات. فهذه الحركات كما ذكرت لا تغير الواقع الموضوعي. وهذا ما نراه في مسرحية كين أو الفوضى والعبقرية، وسجناء التونا، فالممثل بما أوتي من خيال وصناعة فنية فلابد أن يتمرد على ذاتيته وعلى المؤلف. وأن يعكس وعي الممثل لذاته وواقعه وتمزقه، ورغبته الأكيدة في أن نعترف به كإنسان حر. فهذا ألأخير هو الموجود لذاته لكنه موجود للغير، لأن علاقته بالغير هي علاقة أساسية وجوهرية.
مادام وجوده الفعلي مقترن بوجود الغير. فظهور الآخر هو موجود لذاته وهو يكشف لنا مباشرة من خلال التجربة الذاتية التي تنظر إلى العالم، برؤية مفتوحة وغير متناهية. فسارتر دوما يضعنا أمام رؤى فلسفية متنوعة ومختلفة. فحضور هذه الأنا / أمام الأخر هو سقوط الأصلي، وهذا الوجود للغير من حيث هو انهيار وتلاشي وسقوط وجحيم. فلا يعني الانهزام لهذا الإنسان، بل هو اختيار وخلق لفعله وحريته. وقادر على خلق قيمة دون الحاجة إلى الأخر. وهذا ما تراه في مسرحية الذباب[7]. فالعدالة هي من شؤون البشر وليس في حاجة إلى إلاه يقتلني. ذلك، ونظرا للأهمية القصوى لتخصيص حيزا كبيرا يقربنا منه صناعة الوعي بذواتنا وتاريخنا. وبناء ما يميز ذواتنا وتاريخنا، وبناء ما يميز ذواتنا عن الأخرين أيضا.
لذا وجدت مختلف الثورات المعرفية و العلمية مقترحات في الفن لتشكل لنفسها رؤية جمالية لا تعتمد أسطورة التمثل, بل لتتمدد الى المحسوس والملموس. لذا انتقد أصحاب فلسفة الاختلاف والطابع الاختزالي للمعرفة الفلسفية وأنساقها. عارضين براعتهم الفكرية و العقلية و التي تنم عن قوة إبداعية. لذا كانت الصورة مرتبطة بالمعنى الشمولي.
فداخل أنساقها تم اختزال المتعدد والمخفي، والمضمر في شكل معنى واحد بدون فهم هذا الالتباس الجمالي. فرغم هذه النظرة السفسطائية فإنها وضعت الخيال والحقيقة في ميزان الأخلاق والعواطف، ولم تعر أي اهتمام يذكر لهذيان الصورة وتموجاتها الاختبارية. فالصورة تتكون تبعا لسنة التمثل وقانون الفكر، والعقل ثم، قانون الفهم أيضا والتفسير، والتأويل. فالعقل هو المقياس الذي به نقيس الوجود وبه نسعى ونشقى بإلغاء الأحلام والمحظورات وكل أنواع الجنون حسب تعبير أفلاطون.
فالصورة حسب أفلاطون تبقى مثالية ومغرية، لأنها تمثل برهنة عقلانية لا ترتبط بالمادي ولكن هي تمرد على الأقوال وعلى التأويلات. فأساسها ينبني على العملية التخطيطية المتنوعة والخاضعة للعب.
ويقول أيضا ديريدا” إن الفن فكرفيه فقط سلسلة من المتناقضات: حس/شكل، داخلي/ خارجي، دال/مدلول، ممثل /متمثل. سلسلة تهكيل تحديدا التأويل التقليدي للأثار الفنية8. فالانتقال من الواقعي إلى الاستعاري هو ما يمكن أن يقوم بين الدال والمدلول من علاقة علاماتي قد تفضي إلى بناء قاموس بلاغي فني أساسه علم من المترابطة, وفاعلها يتحرك داخلها و قراءتها تتطلب منهجية صارمة حيث تستند إلى طبيعة جذرية مهمتها هي العلاقة الأصيلة بتاريخ الفكر, وهذه الفردية الخاصة بالصورة جعلتنا ندرك أن الاستيعاب السلوكي أصبح جد متشعب على مستوى الخطابات, الشيء الذي يجعل الطبقة المهيمنة تستوعب هذه السلوكيات بشموليتها حتى يصبح الخطاب مشكلا من تداخل عدة أنماط تعبيرية مخصصة للتعبير عن ذات مستلبة. لقد مكنت هذه الطبقة من احتجاز المتخيل، والحلم دون إعادة خصوصيته أو تحريره. وهذا الإرغام والفرض، والصمت هو انتصار للعقل المهيمن. لأن الأمر حسب هذا الطرح يستدعي الكشف عن مواطن الاحتجاز وحدوده بصورة غير نمطية ودون خلق نفايات اجتماعية. فالمطلوب هو تحديد الموقع من أجل تحديد المهمش عن حاله وذاته، وتاريخه. لذا يتطلب منا الحفر في أثرية هذا الفكر المهيمن، وفي كل الثنائيات التي تقسم هذا الإنسان، وهو أمر لم يكن طبيعيا في التاريخ البشرية. لذا أعملت الفئات اللوكوسية بتأسيس النظريات التي تبني الفئة الناجية، والمتعالية قصد النزوح إلى الأسفل، وهذا الأمر يتطلب خطاطة ليست ماركسية، ولا ليبيرالية كما شيدها فوكو ياما في كتابه “نهاية التاريخ”. فالأساس ألان هو إذا كان مشروع ما بعد الحداثة هو مشروع تاريخ أقليات هامشية. فإنه ينبغي أن يقرأ على أنه بالضبط قراءة التاريخ برؤية اختلافية. أي انطلاقا منها هي ذاتها. لقد تحدث الفلاسفة والمفكرين عن هذا المهمش سواء في وطنه، أو في ذاته. أو تاريخه. وهويته جاعلين رغبته مطاردة للكمال. فذلك ليس إلا لأنها تروي واقع الطابع المادي بإلزامية واقعية.
فالتجذر القيمي والدينامي هو مخاطبة للرتابات المهيمنة التي تجعل أسطورة الحداثة هي الأساس، ولكن ما موقع إنسان العالم الثالث من الحداثة؟ وهل هو قادر على الاندماج في سجل العولمة؟ فهذه الأسئلة هي سلوكيات معكوسة. لا تعرف المادية ولا المعرفة، بل تأتي إلى هذا العالم ثم تنخرط بالمعنى البودييري (المشاركة). إذن أليس من الحكمة أن نعيد قراءة مسرحه قراءة عاشقة تلون لنا الطريق بألوان المغايرة والتجربة؟ لأن سارتر لم يكن فيلسوفا فقط بل كان أديبا وشاعرا، مزجت فيه كل القوى ألإبداعية. فراح يغاير المألوف، ويكسر المرايا النسقية من أجل تشكيل مسرح قادر على أن يستوعب الإنسان عبر الإنسان بواسطة الإنسان. إذن وضعنا أمام إشكالية كبرى وهي علاقة الإنسان بالعالم وبذاته.
إن هذه الإشكالية هي مقاربة تحاول ربط التاريخ بهذه التمثلات مع التمييز بين المكتسبات التاريخية، وبين مدلولها المستند إلى مختلف التشكيلات الجماعية المتنازع عنها، وحولها. وكذا حضور الذاكرة المجالية بين الهوية على أن يكون هذا المقترح المسرحي هو التوحد بين التاريخ كمعرفة، وكذاكرة، وبين تمثلات المجتمعات الحداثية والمعاصرة. فالمؤلف في سياقه الواقعي والموضوعي جعله يبني مجموعة من البؤر والأنوية التمثيلة من أجل إبراز التناظر بين الشخصيات التي جعلت منه هذا التوحد أبرز أركانها على الإطلاق، ولكن هذه العقيدة المثالية لم تستطع أن ترتسم في الواقع، بل تتواصل الصراع لدعم التصورات بالقوة والفعل. إذن فمن نحن؟ لا يعني دوما ما نظن أنفسنا به، ما نريده أن نكون ليس طوعا ما نحن عليه حيا، ولكي يحل المعضلة التاريخية. ينصحنا عبد الله العروي بإعادة الفكر بالذات في الجغرافية ومادية التاريخ.
فهيجل، وهابرماس اعتبرا أن التاريخ معركة جدلية بين النماذج والأطروحات الإيديولوجية المتناقضة، وهذه الصيحة الإبيستيمية جعلت العروي يعيد قرأه الواقع قراءة غربانية. لأن الوعي النقدي هو وعي وجودي مرتبط بالذات وبالعالم الخارجي، لأن المسرحي لا يعيش لذاته بل لغير ذاته. وهذا ما شكل منه إرساليات متنوعة سواء في علاقته بذاته أو بالجمهور، أو بالديكور، أو بالمخرج. فهذا الثالوث هو الذي فتح له أفقا جديدا لينضاف إلى التوسعات المجالية الدرامية الحداثية.
فعندما نتحدث عن المسرح كمادة دراسية، تتبادر إلى أذهاننا تساؤلات متنوعة و مختلفة المقاصد. فقد نتساءل عن الهدف من تدريسه لنص أدبي كدرس مؤسسي. وكيف يمكن تجاوز التعارض بين طبيعة التفكير القرائي (النقد – التحليل – التفكيك) وبين الأدب الذي يصاغ من حلال الطرح المفاهيمي أو الموضوعاتي، أو التلقي، أو هل طبيعة القراءة تقتضي الانفتاح على الحقول المعرفية الأخرى؟ وكيف يستجيب لحاجيات و ميولات المتلقي؟ وهل تنتهي القراءة مع المرحلة النهائية من التعليم الثانوي أو الجامعي؟ يبدو لنا من خلال تفحص هذه التساؤلات أن الدارس الديداكتكي للقراءة ينبغي التفكير في الجنس النصي الملازم لتاريخ البيداغوجيا المعاصرة. لقد أصبح جليا أن التلميذ الدارس للمسرح أو الطالب يتوخى من درس القراءة الدرامية اكتساب المهارات السلوكية و القياسية، و التقنيات المنهجية. لأن المرجعية الدرامية التي تدفعه و توجهه هو أن الغرب وجدوا أنفسهم غرب، لأنهم اطلعوا على التاريخ و الحضارة. فظلوا مرتبطين بالماضي و الحاضر مع زرع الأزمنة المعرفية المتغيرة. وبما يستجوبه العصر من تجديد رؤية الإنسان لذاته وبذاته. لذا ينبغي الحفر خارج المدار الماضوي و الجاهز لغرس الإبداع كقراءة باطنية تتناغم مع ما تقتضيه الحداثة من تحولات في التصور و البناء و الفهم. ومن أجل الانخراط في التاريخ من باب الوعي الإبداعي وليس من باب الوهم المهيمن9.
إن تجربة سارتر هي تجربة لها خصوصياتها لأنها لا تدعي الاستسلام، ولا المهادنة. بل تعمل على هدم الأصنام الماضية بمطرقة معرفية من أجل بناء نص جامعي شارك فيه القارئ و الكاتب10. وهذا الجمع بين المختلف و المؤتلف و الإيديولوجي، و الاجتماعي، و الأسطوري، و الشعري. جعل هذه الذات تبحث عن تمايزها سواء على مستوى الشكل الإبداعي أو على مستوى التيمي، موظفا الانزياح كلغة بلاغية، وكذا الغموض ككتابة تتشعب أسئلتها و تنظيراتها. فالكتابة السارترية هي استخراج العسل من باطن النصوص، وهي المدخل إلى تقويض المتعاليات في تكتل الخطابات الغربية، وتحد من قدرات الانسان المحكوم بالانشطار و التشظي، لذا دعا إلى تجاوز هذا الجسد من أجل تأسيس إيقاع جمالي. لأن الإيقاع الجسدي اتخذ ترنيمات و مواقع لا تقتصر على اللغة كما عند البنيويين و الدلاليين، بل يرى هنري ميشونيك إن هذين الاتجاهين قد ألغيا الذات لأن اللغة هي التي تتحكم وليس المؤلف، إنه ذهب إلى حد قطع فيه كل صلة مع الموروث اللغوي والفني. إن الحداثة هي تركيب العلاقة بين الإنسان والعالم. فهي سيرورة إحالات تمس الحياة الإنسانية في كل أبعادها المتنوعة. فهي السؤال المهدم، والمتجدد، وهذا ما جعل كل الفصائل الدرامية الإنسانية أن تنفتح على الفضاءات لجعلها تتمرد على السائد والثابت.
فالحداثة هي خط مستقيم و ليس دائرة مغلقة11 , ومنفتحة على الماضي والمستقبل من أجل إنتاج المعنى حسب بودريار، بعيدة عن اليقين و الحقيقة المطلقة، فهي دعوة إلى المساءلة وممارسة الشك وبناء أفق جديد، يتسع للمتعدد و المتنوع والمختلف. ويعتبر سارتر من بين المفكرين الذين طرحوا قضايا التي تهم الإنسان الغربي، كالهوية و التراث و الاختلاف، والإبداع و الحرية و الكتابة، والشعر، والدراما، و الوجود.
ويرى سارتر أن هذه المفاهيم تنوعت بتنوع التوظيف والممارسة. وأن الإبداع جوهر، فكل شيء موجود بالفعل و ليس بالقوة. فالوجود يسبق الماهية، ويسميه سارتر الوجود في حد ذاته وليس فاعلا ولا منفعلا، ولا تابتا لا منفيا. إنما يقوم الوجود معتمدا على ذاته لا أكثر. فالوجود ليست له علاقة ثبات فهو الموجود ألإنساني على التخصيص، بحيث يرى سارتر أن الموجود لأجل ذاته يظهر حينما ينعدم (الحيوان) الإنسان. فهو يرتبط بالوعي والحرية وبالرغبة في الآخر لا بالوجود.
إن هذا المسرح عبارة عن إنتاجية أدبية مؤطرة بإنتاجات ثقافية واجتماعية مؤطرة كفضاء تشكيلي و دلالي، فهو أيضا لغة مؤلفة من المعنى و المبني، إنه مركب يشتمل على أجزاء تمثل دلالة تفصيلية على قدرة الذات و كفايتها الإبداعية، وذلك ضمن تاريخ الأشكال الأدبية، وتاريخ الأنواع و الأعراض حين تؤطره مجموعة من إستراتيجيات التواصل الدرامي. ومقصديات الإبداع. فالثقة التي وظفت من طرف سارتر فهي ليست بسيطة (لأنها معطى اجتماعي كما يقول بارت)، فهي معطى قبلي و هي أيضا دائرة من الحقائق المجردة. أما الأسلوب فهو العمود الفكري للمسرح، إنه صوت مزخرف يعمل كما تعمل الضرورة (كما يقول بارت في كتابه “لذة النص” ص 13. لأنها أيضا تعمل على بناء قارئ ضمني أو حقيقي دون فهم مرجعيته، فإسكار بيت يصوغ مفاهيم حيث يرى أن كل مؤلف يمتلك لحظة الكتابة، قراء حاضرون في وعيه حتى لو كان هو نفسه بالذات13. فاسكاربت في كتابه “سوسيولوجيا الأدب” يميز بين الجمهور المخاطب المحايث للعملية الإبداعية نفسها بنفسها و الذي يستحضره أثناء الكتابة، وبين الجمهور العمومي الذي يتمكن من اقتناء العمل و قراءته، إن الجمهور الواسع هو الذي ينتمي للمبدع و المخرج، إذن نطرح السؤال التالي: كيف يقرأ سارتر مسرح المواقف؟
يرى سارتر أن النص لا يتموقع بالنسبة إلى واقعه الخارجي الخام, بل يتموقع بالنسبة إلى الأنساق الداخلية الذاتية في عصره, باعتبارها نماذج فكرية و شاعرية لفهم هذا الواقع وتأويله, حيث أن كل نسق إبداعي هو تفسير اختزالي و انتقائي دينامي لتجربة العالم, إذ يعرف مجموعة من التناقضات و الانكسارات غير المعيارية, و سلما خاصا من القيم الاجتماعية و الإنتظارات الممكنة , وسوف تتجلى هذه التناقضات في شكل أنساق من الإمكانيات الدلالية غير الثابتة, في مقابل مجموع الإمكانيات الدلالية الأخرى لفهم الوجود الإنساني و العالم. لأن النسق الوجودي يصبح قابلا للتفكيك عن طريق إعطاء الأولوية لهذه الذات المتسربلة من بداية إلى نهاية (وجود الذات وموت الأب). فالمؤلف هو الذي يفرض شروط إبداعه و فهمه وتأسيس معناه، لأن سيرورة التشتيت لن تكون انعكاسات لإعادة الكتابة الثابتة في الفهم و الإدراك. بقدر ما تكون محورا لهذه العادات السائدة و كشفا عن عجزها. إنها لا تسمح لنا بإدراك الوجود الذاتي المتعالي كوعي به، بل تحكمه الفرصة لتجاوزها في اتجاه بناء تجربة جديدة التي لم يكن الأدمي أن يحياها رغم هيمنة الأفكار الرمزية التي توجه الفهم و الإدراك. هكذا عمل سارتر في نظري على منح هذه الذات المرآوية الفرصة لتجاوز الصورة المنمطة، و تهيئ شروط بناء الذات المخالفة للذات القارئة المحنطة، كما انتقدها أدورنو و أعلام مدرسة فرانكفورت في (نقد الإيديولوجيا). فهذه الأخيرة تفترض في العلوم الإنسانية والأدب والقدرة التأثيرية.
اللغة الدرامية عند سارتر
إذا كانت اللغة هي الأداة، والوظيفة، والرمز، والإشارة، والأسطورة. فهي أخطر نشاط بشري، حيث لا يعاد يتصور أي قارة، أو جماعة بدون لغة سواء كانت مدونة أو شفوية. وقد أدى هذا إلى الاستعانة بعلوم كثيرة منها علم النفس و علم الاجتماعية و التاريخ والجغرافية والاقتصاد، و الإحصاء. فظهر ما يسمى “علم اللغة الاجتماعي”
وظهر هذا العلم في القرن 19, فبدت معه مصطلحات و مفاهيم كالأنثروبولوجيا اللغوية والفيلولوجيا الأنتوغرافية، والإثنولوجيا وغيرها من المصطلحات. فمع التطور العلمي و الفكري اتخذت في عصرنا عدة مفاهيم جديدة نظرا لتعالق العلوم مع هذا الإرث اللغوي الإنساني، فتولد عنه: علم اللغة السوسيولوجيا وعلم اللغة النفسي، وسوسيولوجيا اللغة. فهذا الاختلاف هو عدم استقرار المفاهيم ولا محدوديتها نظرا لتشابك و تداخل بين ما هو مرجعي و ما هو ذاتي و عقلاني و فكري. لذا سأركز على اللغة الاجتماعية التي ظهرت في أوائل الستينيات13 و التي عرفت تطورا على مستوى الممارسة البحثية، حيث تعدد التداخلات كما ذكرت فظهر معها علم النفس اللغوي في الخمسينات. فهذا العلم (المسمى علم اللغة الاجتماعي) ولد نتيجة التطورات الجغرافية والسياسية في المجتمعات المتقدمة والنامية. فكان لا بد من دراسة هذه اللغة داخل المجتمع، والمدرسة و الجامعة. من أجل معرفة كيفية التواصل الاستعاري و كذا بعدها الرمزي، و البراغماتي حسب مفهوم مدرسة شيكاغو).
ولم يعد هذا المنهج “علم اللغة الاجتماعي” تيار له حدود، وأدواته، و خصوصية وظيفية ورمزية. بل هو نشاط اجتماعي يشارك الذات و الجماعة في خلق دينامية رمزية التي تفصح عن البناء الاجتماعي. فمن المؤكد أن هذه اللغة هي عبارة عن سلوك اجتماعي يعكس موقفا سواء في ذاته و أيضا في إطاره، لأن الإنسان مرتبط بالعوامل الذاتية الداخلية والخارجية. إذن فلا مناص من فهم اللغة في ذاتها دون فهم المجتمع. فهذه المعارف كافية لتحديد موضوع علم اللغة الاجتماعي، لأن العلم الذي ارتكز التبادل غير المألوف في أشكاله المتنوعة، باعتبارها صادرة عن المجتمع وعن ثقافته، وفكره14. فهذا التصور للتبادل الاجتماعي، يجعلني لا أقف عند الكلمة كما حددها سوسير في كتابه “دروس في اللسانيات العامة”، ولا عند “الجملة” عند تشومسكي، وإنما سأتحدث عن فعل الكلام كما عند ألشكلانيين الروس، أو جماعة (مو)، أو براغ، وغيرها من التيارات المذهبية، لأن دراسة اللغة إذن تقتضي الارتباط بالبعد الاجتماعي ليس بالمفهوم الأنثروبولوجي، بل تعتمد طريقة التواصل بين المرسل والمرسل إليه، والهدف من كل هذا هو إيصال المعنى المراد. لأن هذا المعنى يتحول طبقا لسنة التطور وقانون التأويل، والتفسير وكذا درجة المتلقي أو المرسل أيضا. فهذه الرؤية الكلية او الانشطارية، جعلت هذا العلم لا يهتم بما هو فردي بل يرتبط بالكليةٍ حسب المفهوم الجيشطالتي، لأن ذات الشخص هي مجرد قناع يأخذ عدة أدوار اجتماعية، وله خاصية المجتمع، والذاتي/ والموضوعي، والثابت البنيوي/ و المتغير التاريخي، وكذا الضرورة و الحرية، والتقابلات والمفارقات. فهوية الذات ثابتة/متغيرة. لأن الإنسان شخص يرتبط بمقومات (الهوية). فهذه الأخيرة تقوم على الثبات و الوحدة، بل أيضا على التغيير و التعدد. والسؤال المطروح: هل هي غاية في ذاتها أم هي وسيلة؟ وهل لديها قانون نسبي، وخارجي وبيئي؟ فهذه الأسئلة تختلف وتتنوع حسب المنهج، والفكر. فديكارت(العقلاني) يرى أن الذات مرتبطة بالفكر, لكن جان لوك يؤكد على أن هذا العقل ألمفكر عبارة عن صفحة بيضاء. لكن عن طريق الاكتساب و التجربة يستطيع أن يؤسس لهذا العقل دلالته. فهذه الرؤية لقيت انتقادا كبيرا من الباحثين، وخاصة المفكر تشومسكي الذي يرى أن الإنسان يولد بالتجربة، لأنه واعي يرتبط بالذاكرة وبالزمن وباللغة. كما يؤكد ذلك جاك لاكان، فهذه الإرادة القوية، لم تمنع علم اللغة الاجتماعي من التطور., والتأثر بهذه المدارس اللغوية والثقافية15. وليس غريب عن أن نهتم بالأنثروبولوجيا لأنها هي البوابة التي تمدنا بما هو جوهري كأصل اللغة، والأسطورة، واللغة القديمة، وكذلك الجنس، أو العرق. كلها ثنائيات تفسر لنا تاريخ المجتمعات، فهذا التصور وإن كان له دور تاريخي وانتقائي. فإنه لقي معارضة كبيرة من طرف الباحثين كأمثال سايس وتايلر و ويتني وغيرهم من المفكرين15. فهذه المواقف اختلفت كما ذكرت، لأن اللغة ليست واحدة موحدة، بل هناك عدة لغات ولهجات. فلا يمكن أن نتكلم لغة واحدة، لأنها تتحول، وتتطور، و تموت وتولد. فهي مؤسسة شعبية ثقافية كما نرى في اللهجات البربرية. و الحق أن هذا الخليط البربري لم يجعل اللغة ذات نسق واحد، بل خلق كلمات وأنساق وظيفية أخرى المتحدث عنها، فهي تحتفظ بالنمط الفكري، ولكن الجنس يختفي بالتخالط مع الأجناس الأخرى كالعرب و اليهود …
الإنسان بين الحرية والوجود في مسرح سارتر
إن الهدف من كتاب “الوجود والعدم”, ومسرحية “الذباب” هو إظهار مواقف من المثالية، والكانطية1. لأن هدفه إنزال الفكر إلى الحياة ليجعل الإنسان ينعم بها وأنه يعرف ماهيته بعد ذلك، فماهيته من خلقه ولا يوجد ما يسمى بالطبيعة الإنسانية، لأن الإنسان هو مشروع يعيش لذاته فماهيته لا تتحدد إلا مما شرعه هوعن طريق عملية الخروج من الذات. ويرى الدكتور زكريا ابراهيم” ليس في استطاعة أن يضطلع بهذه العقلية إلا إذا عمد إلى تحقيق وجوده في عالم المادة2. فالإنسان في هذا الاختيار أن يكون مسؤولا، وهذه المسؤولية لا تخرج عن طبيعة القلق، لأنه يعتريه. و يصبح ذا قيمة ابتداء من اللحظة الاختيارية المرتبطة بالحرية “لا تعني قدرة ذاتية على الإختيار”3. إذن الحرية حسب سارتر لا تكون بدون قيود. لذا عامل على تحديدها من خلال منظورين: فالمنظور الأول يتمثل في وجود الفرد، حيث لا يتوقف على نفسه، وأن إحساسه بالحرية في ألا يكون حرا. والمنظور الثاني يتمثل في الآخر، على اعتبار أن من شأن حرية الآخر أن تأتي و تحد من درجة حريتي 4. فالحقيقة البشرية هي ذلك الشعور أو الموجود لذاته، الذي يخلف العدم، وذلك على اعتبار أن الإمساك بذاته ليس نفيا لوجوده. فسارتر يقف أمام التصورات المذهبية التي تضع الإنسان -كموضوع- دون الارتباط بالذاتية. لأنها ليست بالضرورة فردية كما هو الحال في الكوجيط الديكارتي، حيث نجد اننا نكتشف أنفسنا والآخرين أيضا، كما أن اكتشاف الأخر هو شرط وجودنا نحن، هكذا فمن عالم يبدأ بالذاتية يستطيع الإنسان أن يحدد ماهيته وماهية الآخرين، فالمعرفة هي العلاقة بين الإنسان والعالم. لأن العمل هو نتاج للحاجة، فالإنسان كائن عضوي يتغذى من المادة شأنه شأن الكائنات الأخرى، مما جعله يلغي ثنائية الفكر الوجودي، مسلما بواحدية المادة، لأنها لا تبدأ إلا في عالم الإنسانية. وهذه الروح المادية الجدلية المرتبطة بالإنسان تجعله يعيد النظر في التاريخ و المادة، و الديالكتيك، باعتبارها مفاهيم تنبعث من داخل التاريخ البشري بوضعه علاقة حية للإنسان بالمادة6” و أن الحرية بدورها ترتبط بالمجتمع و التاريخ بسبب الندرة و العنف و تتصف بالضرورة7 “. فسارتر في تعامله مع الحرية لم يكن تعاملا برانيا مرتبطا بالطبيعة بل بالبعد المادي، لأنها القدرة الفاعلة على العمل في موقف لا يمكن رفضه. فالإنسان يعيش دوما الاغتراب، وهذا الأخير يدفعه لكي يعيش وحيدا بعيدا عن القسم الأصلي أو العقد الاجتماعي. فمادام التراث هو وسيلتنا للتعامل مع مؤثرات العالم الخارجي، فهو الذي ينقل إلينا التصورات و الانطباعات، وما يدور حولنا في هذا الوجود، وبما أن عالمنا مادي، فإن الإنسان يحيا، و يستعيد كل الصور المرتبطة بالذاكرة، ويقول أحمد عويز في هذا الصدد: إن الذاكرة مقيدة دائما باستعادة الأصل أو الاقتراب منه. أما المتخيل فهو حر غير مقيد بأصل يعتمد على خلق الجديد وابتداع الصور8.
و يرى جون باهمور في كتابه “مئة سنة من الفلسفة، ص 467” أن الوجوديين عرضة لما يقال على أنهم يضفون صيغة مسرحية عن المألوف فالعقلاء من الناس يقبلون احتمالية العالم، ويواصلون العيش فيه. بينما يصبح الوجوديون في ألم. إنهم يوجدون بلا ثمن في عالم مستحيل “فالوجودية ليست مدرسة لها أتباع و شيوخ، إنما نزعة ترفض الفلسفة التقليدية، و الأنظمة السائدة. وهذا ما دفع كوفمان في كتابه “الوجودية من دوستويفسكي الى سارتر” إلى طرح بعض الثيمات التي اهتمت بها هذه النزعة، كالفشل، و الموت، و الحياة، و اليقين، و المعتقدات، و الرعب، والقلق (ص 21). فالإنسان يواجه العدم، ويعاني الغثيان، وهو عنوان لمسرحية سارتر. فالبطل أنتوان روكانتان الذي كان يعيش القلق، و الهذيان و يخاف من ذاته، مما جعله يعيش الحيرة – نظرا لعيشه في يقين فاسد (الغثيان ص 22). فالوجود كشف عن نفسه أمام رؤية رو كنتال. ويقول سارتر” لم يكن سوى مظهر أو قشرة، وهذه القشرة قد ذابت، تاركة كتلا طرية مريعة و فوضى، عارية عريا مخيفا بذيئا “. ص 183 الغثيان.
فاللغة و العالم منفصلان عن بعضهما دون أمل رجعة، ولا يمكن تجنب هذا الانفصال إلا بوضع الكاتب في وضع متطرف (ما ألأدب) ص 164. فالمسرح في مجمله ليس غريبا عن التجربة البشرية التي عاشها الإنسان منذ بداية نهضته، وما بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، فسارتر طرح لحظة وعي بالذات، هذه اللحظة الدرامية هي التي جعلته يعيد صياغة أسئلة النظام بوصفه قانونا غير ثابت، غير أن واقع هذا المسرح السارتري عرف نوعا من التصدع من حيث الكتابة ومن حيث التمسرح. لأنه نسق لا شعوري يتوغل في الأعماق، ولا يتذكر سوى الديالكتيك (الجدل)، إذن يمكن الاعتراف بوجود مسرح دياليكتيكي.[8]
لا شك أن سارتر يبدأ في متونه الدرامي من الكوجيطي الديكارتي “أنا أفكر إذن أنا موجود” فألانا عند فيلسوفنا الفرنسي هو الفكر، فهو الجوهر، والمبدأ الأول. لكن سارتر يجمع بين ألأنا المفكر وموضوع الفكر، وذلك في علاقة تعبر إلى موضوع الوعي.
ألأنا ألمفكر الموضوع الوعي
فهو إذن، لا يكتفي بوصف الموضوع المعالج كما حددها هوسرل, وإنما يسير إلى ألموضوع من أجل استخلاص النتائج و الغايات. بحيث تقف الذات المفكرة أمام الموضوع المطروح من أجل استنتاج كوجيطي سارتري جديد “أنا أفكر في موضوع ما[9]. فالوعي حسب سارتر لا يوجد منفردا وإنما يوجد بالفعل. لأنه يفكر في الموضوع، فهو إذن ليسا وعيا بنفسه كما عند ديكارت وإنما هو وعي بموضوع خارج الوعي. هكذا يحملنا سارتر إلى قصدية ثم إلى وجودية. فالمعرفة تأتي لنا من الوجود، إذن فهي مرتبطة بالوعي الخارجي وليس بالماهية، إذن فالوجود سابق الماهية أي أن الممارسة المعرفية سابقة على أن تكون طبيعة معرفية. من هنا نستشف أن الوعي الوجودي هو وعي جديد لماهيته، سابق عنها. لأن الممارسة هي التي تحدد الموضوع، الوعي والوجود. إن الوعي متجه دوما إلى ذاته أولا وترك ذاته ثانية[10]. من هنا يقربنا سارتر إلى الوعي في ذاته، و الوعي لغير ذاته، فالأول يبدأ من البعد السلبي، ورغم هذا الوجود لذاته فهو مطروح في العلم الخارجي بشكل مجاني، إنه مجرد واقعة بسيطة و بديهية، قذف في هذا العالم دون علم منه” فهو ليس له إحالة مرتبطة بجوهر ثابت, وليس له أية ثغرة ينفذ منها العدم[11]. إذن نحن أمام تيار فينومينولوجي الذي بناه هوسرل وطبقه هيدجر في مشروعه الفلسفي. إذن فسارتر كما قلت لا يرتبط بالشيء في ذاته بل يجعل هذا البراديكم مرتبطا بالنموذج الخارجي (الوجودي) والذي هو موضوع الوعي. فسارتر إذن يميز بين الوجود والماهية. فالماهي هي الوعي الانفصالي، أما الوجود فهو يحتمل إما الثبات، أو النفي أو العدم. فهذا ألأخير يرتبط كما قلت بالقصدية إما ب “نعم” أو “لا”. لأن المتلقي يحمل في وعيه وفكره صورة الأشياء التي ترتبط إما بالحواس أو بالعدم. لأن بالعدم نلتقي مع الأشياء أو نثبتها، وهذا الفراغ كما يجيب سارتر هو ضروري في وجودنا، لأن العدم دودة الوجودي[12]. فالعدم هو جوهر ولب الوجود، فالحرية هي قماش الوجود[13]. لأن الوجود السارتري كما قلت سابقا عن الماهية. إذن فحريتي تسبق ماهيتي، لأنني موجود فأنا حر في نفس الوقت. فهي متطابقة مع وجودي ومع العدم الذي يسكنني، فعن طريق الوعي يصير الحاضر حرا أيضا، وانفصال الوعي عن ذاته هو انفصال الماضي والمستقبل عن الحاضر النفسي، وهذا الانفصال هو إلغاء وإقصاء لكل الأفكار التي تقول بأن الحاضر من صنع الماضي، وأن الحاضر هو من سيشيد المستقبل. وهذا الإلغاء لتأثير للعلية أو السببية جعل الإنسان مسؤولا عن ذاته وحر في قدرة اتخاذ قرارته دون العودة إلى الآخر، لأن الآخر هو الجحيم. وعن طريق هذا التجاور يصبح للعالم دلالة، ويكون الإنسان صانع ذاته وماهيته. إنه خلق مستمر ومحكوم عليه بالحرية[14]. فالوعي إذن حسب سارتر هو عندما يعي كينونته وحريته يصاب بالزجر والقلق في هذا الوجود، لأن الوعي الذي يحمله لا يساعده على الاختيار، فيحس بالإقصاء مادام بلا ماهية ولا أسس في هذا العالم إذن فهو مسؤول عن هذه الاختيارات وعن كل مآسيه، لذا يجعل الإدراك الوجودي المرتبط بالوعي أنه قادر على تجاوز هذه المحنة، لأن له قدرة الاختيار والحرية دون استحضار سوء النية[15]. ومهما يكن، فإن الكتابة عن جون بول سارتر ليس بالأمر الهين، بل تتطلب الدراية، الممارسة، المعرفة بالفلسفة والعلوم الإنسانية. لأن الطود الذي يخاطب كل التيارات والريح الهوجاء الذي حولت الفكر الفرنسي من سبلته إلى فكر متحرر من كل وصايا ومن كل تقليد يذكر. لذا عمل بجانب المثقف، والمناضل وبجانب الطبقات المهشمة. استنطق الماركسية، والبنيوية والفينومينولوجية[16]. فملأ الدنيا بأفكاره المحرضة وشغل الأقلام بأسئلة تنبثق من مرجعيات مختلفة، لذا أرجو أن أكون موفقا في هذا البحث، ولنا عودة إلى فيلسوفنا الوجودي.
[1] إدموند هوسيل” تأملات ديكارتية أو مدخل الفينوميتولوجيا تر تيسير شيخ الارض بيروت 1958 ص- 133-
[2] كمال فهمي , الفلسفة و المسرح, ص 95
[3] , 96 ص.المرجع نفسه
[4] ألأنا و الآخر والجماعة, دراسة في فلسفة سارتر و مسرحه, دار المنتخب العربي, 1994. ص 181.
[5] د الغزيوي بو علي, إشكالية المتخيل عند نجيب محفوظ, مجلة فكر و نقد, ص 36
[6] المرجع نفسه, ص 36
[7] مسرحية الذباب, ص 111
[8] Sartre j. p. « critique de la raison dialectique» 1960, p 23.
2 زكريا إبراهيم “ دراسات في الفلسفة المعاصرة” ص 529
3 المرجع نفسه ص 521
4 المرجع ذاته ص535
5 sartre J. P. l’imaginaire , Gal, 1940.p 79
6 زكريا إبراهيم”درااسات في الفلسغة المعاصرة” ص 528
7 audrey colttec « Sartre» p 109
8 ذ أحمد عويز “ الذاكرة و المتخل” ط 1 بيروت لبنان 2017 , ص 29.
[9] J. P. sartre : l’être et le néant, p. 19
[10] المرجع ذاته، ص 27
[11] J. P. sartre : l’être et le néant, p. 116.
[12] J. P. sartre : Ibd, p. 56
[13] J. P. sartre : Ibd, p. 507
[14] J. P. sartre : Ibd, p.494
[15] J. P. sartre : Ibd, p. 82
[16] د. نورة بوحناش “الأخلاق والحداثة”, إفريقيا الشرق ص 5-38. (للتوسع).



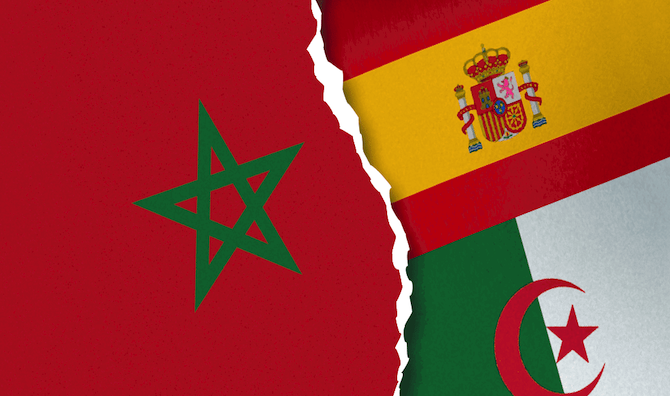











تعليقات الزوار ( 0 )