لست أدري هل بدأت الغيرة تسري في نفوس المذيعات العربيات وهُنّ يرين «زميلاتهن» القادمات من مختبرات الذكاء الاصطناعي يقتحمن شاشة التلفزيون ويقدّمن الأخبار ويحاورنَ الضيوف بجانبهن؛ ومن يدري فقد يَصِرْنَ بديلاً لهنّ يومًا ما؟
بيد أن المذيعات «الافتراضيات» لن يُبدينَ احتجاجًا إذا ما وُوجهن بهجاء، ولن يعتبرن المسألة «تنمُّرًا».
كما أنهنّ لن يتأثّرن بعبارات الغزل مهما كانت مستوياتها، ولن يتابعن أصحابها بدعوى التحرّش، لأنهنّ عديمات الإحساس والتفاعل الإنساني… لسنَ بشرًا ببساطة!
إنهن أشبه ما يَكُنَّ بمرتزقة «فاغنر»، جِيءَ بهنّ أو لنقل جرى «اقتناؤهن» من أجل مهمة محددة، لا مجال عندهن لشيء اسمه «أخلاقيات المهنة» و»بند الضمير» و»مدونة السلوك».
وسترتاح إدارات القنوات التلفزيونية العربية التي «توظّف» مذيعات افتراضيات، لأن هؤلاء لن يفكّرن يومًا في القيام بعمل نقابي أو بحركات احتجاجية على أوضاعهن المادية.
كما أنهن لن يتسبّبن لتلك القنوات في الإحراج بسبب تدوينات وتغريدات، تتضمن مواقف سياسية أو إنسانية أو فكرية… لأن أولئك المذيعات لا مواقف لهن. ألم أقل إنهن أشبه بمُجنَّدي «فاغنر»؟
إنهن يُطبِّقن ما يجري تلقينه لهنّ مسبقًا، ولا مجال لحرية الإبداع ورحابة الخيال ومتعة التفكير.
قد يقول قائل: هُنَّ يعملن بموضوعية وحيادية.
حسنًا، فلنختبرهنّ ـ على سبيل المثال ـ في كيفية التعامل مع جرائم «إسرائيل» في حق الفلسطينيين، أو كيفية محاورة ضيوف من الكيان الصهيوني. أكيد أنهنّ سيلجأن إلى «الحياد السلبي» الذي يساوي بين المجرم والضحية، لأنّ هذه الكائنات هي من إنتاج «الذكاء الاصطناعي»؛ ومختبرات هذا الذكاء مُتحكَّم فيها من طرف «لوبي» معيّن، يفرض توجّهه على كل محتوى يمرّ عبر التقنيات الحديثة، تمامًا مثلما يقع في شبكات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر» و»إنستغرام»… فهذا «اللوبي» يميل إلى الأطروحة الصهيونية المهيمنة، ويرفض أيّ فضح لها عبر هذه الوسائط وأيّ دفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة أو حديث عن معاناته المتواصلة منذ عقود عدة.
فضّة وابتكار ونورا وآني !
لماذا اختيرت الأنثى لبدء تجريب فكرة مذيعي الذكاء الاصطناعي؟ لماذا لم تكن التجربة الأولى بالمذيع الافتراضي وليس بالمذيعة؟ أليس الأمر تكريسًا لفكرة الإغراء التي تلجأ إليها عادة الشركات العالمية، من أجل الترويج لمنتجاتها الجديدة، سواء تعلقت المسألة بالابتكارات التقنية أم بالسيارات أم بالروائح والملابس وهلم جرا؟ ألا يمكن النظر للاختيار المذكور على أنه «تشييءٌ» للمرأة واختزال لها في الجانب الشكلي فقط؟
لكنْ، ليطمئن المذيعون والمذيعات العرب، فتلك الكائنات القادمة من العالم الافتراضي مجرد محاكاة لهم، ولن تستطيع التفوّق عليهم مطلقًا، لأنها تنفّذ عملاً «آليا» مُتحكَّمًا فيه وقائمًا على ذكاء «اصطناعي» وليس طبيعيا. ولن تستطيع إحداث التميّز والفرق. لن يكون أي شيء في «عملها» طبيعيا وتلقائيا ومن وحي اللحظة.
هل تستطيع تلك الكائنات الافتراضية المستعارة للتلفزيون ـ مثلاً ـ أن تكون في مستوى كفاءة خديجة بن قنة وطريقة إلقائها؟
أو فيصل القاسم وهو يتّخذ قرارا جريئا في برنامجه المباشر بطرد ضيفٍ أخلَّ بآداب الحوار من الاستوديو؟ أو أحمد منصور وهو يحاصر ضيوفه بالأسئلة القوية المضبوطة، ولكنه لا يقوى في لحظة إنسانية استثنائية على إخفاء تأثّره وانسيابية دموعه؟
هل تستطيع أن تكون في مستوى موقف عبد الصمد ناصر الذي خُيِّر بين عمله ووطنه، فاختار الثاني، ولم يقبل محو تدوينة يدافع فيها عن شرف نساء بلده؟
لن تستطيع مذيعات الذكاء الاصطناعي إدراك الفرق من تلقاء أنفسهن، لأنهن تابعات للعقل البشري الذي تولّى برمجتهنّ، وبالتالي لن يخلقن التميّز ولن يصرن نجومًا!
وصولُ الدفعة الأولى من خريجات الذكاء الاصطناعي: «فضة» و»ابتكار» و»نورا» و»آني» إلى بعض التلفزيونات العربية… هل يفسح المجال لدفعات لاحقة في قنوات أخرى، من باب المحاكاة؟ أم أن الأمر مجرد «تقليعة» ظرفية، لكنها ذات كلفة مالية باهظة؟
وانقلب السحر على الساحر!
علاقةُ منتجات الذكاء الاصطناعي ـ ومنها المذيعات ـ بمصدر إنتاجها أشبه ما تكون بعلاقة التابع بالمتبوع، والمُريد بالشيخ، والمصنوع بالصانع.
وقصّةُ هذا الصنف من المذيعات تزامنت هذه الأيام مع قصة «تمرّد» قوات «فاغنر» على السلطة المركزية في «الكرملين»، حيث فوجئ العالم وهو يتابع عبر وسائل الإعلام كيف انكسر الكبرياء الروسي مع هذا الحدث المفاجئ، فلم يعد الموضوع هو حرب موسكو مع كييف، وإنما حربها مع مرتزقتها المجنّدين.
انقلب السحر على الساحر، تمامًا كما يقع في الأفلام السينمائية الغربية التي تتناول تمرّد «الروبوتات» عن صنّاعها من البشر. آخرها الفيلم الأمريكي «الأم والآلة» لمخرجه ماتسون توملين (إنتاج 2021) الذي يتحدث عن زوجين هاربين من بلادهما التي وقعت في حرب غير متوقعة مع الذكاء الاصطناعي، بعد أيام من الحمل بطفلهما الأول. ومن ثم، يجد الزوجان نفسيهما في مواجهة معقل انتفاضة «الروبوتات»، على أمل الوصول إلى برّ الأمان قبل ولادة جنينهما.
وقياسًا على هذا المنوال والضرب من الخيال، هل يأتي يوم تتمرّد فيه «مذيعات الذكاء الاصطناعي» على مُبتكريها، أو يتمردن على مسؤولي القنوات التلفزيونية الذين يستعينون بـ»خبرتهن»؟
لنتخيّل ماذا سيحدث إذا وقع خللٌ ما في برمجيات و»لوغاريتمات» هذه الكائنات الافتراضية، وهي تقدّم نشرة إخبارية على الهواء… أيّ هذيان وأي سفسطة، بل أي كلام صادم سيخرج من أفواهها؟
ولنتخيل أيضا ماذا سيحدث لو أن خلافًا سياسيا أو ماليا أو غيره حصل بين مسؤولي القنوات التلفزيونية ومُنتجي «الرّوبوتات» الإعلامية، كيف سيوظّف هؤلاء المتحكمون في هذه الصناعة المذيعات الافتراضيات من أجل الضغط والابتزاز، عبر التهديد بتمرير خطاب إعلامي مُناقض لنشرات الأخبار المبرمجة أو للحوارات التلفزيونية مع ضيوف بعينهم؟
ليس المهمّ أن تمتلك أحدث الابتكارات التكنولوجية، ولكن الأهمّ هو أن تكون قادرًا على إنتاجها والتحكم فيها… مصداقًا للحكمة الصينية الشهيرة: «لا تُعطِني سمكة، ولكنْ علِّمني كيف اصطاد السمك».
وتلك هي معضلة الذهنية العربية المعاصرة!



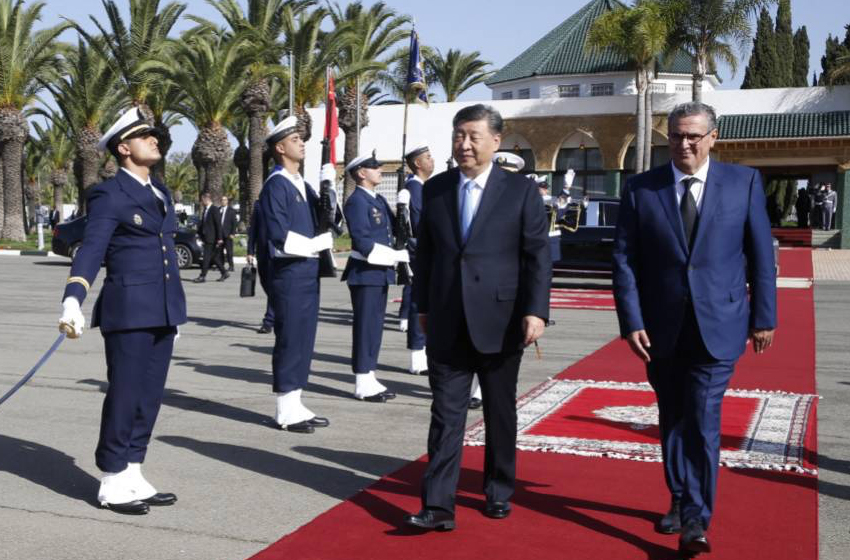











تعليقات الزوار ( 0 )