الكتابة سؤال حول الوجود، وحداثة بلا قيود، واستعارة تجعل العالم عبارة عن مسرح، يعمل أدونيس على بث عدد من الإرساليات المتزامنة، فتظهر الكتابة كإيقاع خاص له مدلوله الخاص، فهي حافلة بشتى أنواع التقنيات التعبيرية ووسائل الأداء الفنية، وفضاء تذوب فيها كل العوالم، فيصبح الشاعر كطود عظيم يسكب الخير، ويهب لأهله الحياة.
فهي خلق وإبداع تنتج الإبداع لمواجهة الموت، وامتداد بين الصور، والتفاعل مع اللغة شرطا في كينونة النص الإبداعي من حيث وجوده، ومصيره، وهويته، فالكتابة عند أدونيس هي التشكيل الشعري، واستجابة للنفسي، والاجتماعي، وقراءة تتجاوز المؤتلف، وتأويل زمني، ومكاني، وتحرر من المتناهي، والمرجعي، إنها حوار مع الكينونة، وعنف ضد الموت، والحياة، وتحول عبر اللغة إلى اللامحدود، والأبنية الممكنة[1]، إذن كيف يرى أدونيس الكتابة؟
تعتبر الكتابة جنسا أدبيا مستحدثا في الثقافة العربية مقارنة مع نظيره في الثقافة الغربية، ويعود ذلك إلى جملة من العوامل أبرزها هيمنة الشعر العربي على الذائقة الفنية لمدة طويلة، وهو ما قلص من حظوظ بروز أجناس أدبية أخرى، ومع ذلك فقد توسلت الكتابة طريقها إلى الأدب العربي مع نهاية القرن التاسع عشر، إثر المثاقفة مع الغرب، وتطورت بشكل عميق خاصة منذ نهاية الستينات وأصبحت مثل نظيرتها الغربية حيث تتراوح بين الرواية الواقعية والرومانسية والمثالية والتي استقام عودها على يد مجموعة من المؤسسين الرواد الذين أعجبوا بالتخلق الذي طالما دعا إليه منظرو الرواية الغربية الجديد أمثال، الان روب غرييه Alain Robe Grillet، وناتالي ساروتNatalie Sarautt وميشال بوتورMichel Butor وغيرهم من الروائيين الذين تبنوا الكتابة الجديدة ورفضوا كل ما هو مستهلك، فكان السر يتعلق بمستوى خاص من الوعي، والتمثل لدى الروائيين العرب، أي الوعي القبلي والتمثل الواعي والجيد والمبرر لما يستثمرونه من أشكال أو تقنيات أو وصفات أو حتى دلالات جاهزة، وذلك بموازاة مع الوعي أيضا بضرورة المساهمة في تغيير وظيفة الأدب ودور الكتابة في المجتمع، ومدى قدرتهما على مواكبة وتحولات الذات ودينامية المجتمع والعالم، راسمة لنفسها مسارا مختصا بها بالشكل الذي يجسدها تجسيد أسمى، فاستطاعت بذلك الكتابة في مسار تحول تجربتها الخاصة أن تؤسس أنماط كتابية جديدة تتجاوز البنية التقليدية للمحكي السردي.
لقد جاءت الكتابة العربية الحديثة في حد ذاتها أبين دليل على الوعي المغاير، والمناهض لجميع المرتكزات الجامدة، حيث جاءت متزامنة مع هزيمة 5 حزيران 1967 وانكشاف الليبرالية والثورية واستفحال القمع وهيمنة الصوت الواحد المستبد وانتشار الطائفية والتعصب الظلامي وتحجيم الأنظمة للثورة الفلسطينية[2]، وكفاح الإنسان الداخلي نزوعا نحو التوازن النفسي ضد الاغتراب الروحي والإحباطات ومظاهر العصاب والألم والشقاء والتشويه، وشبح الموت والدمار الذاتي والعلاقات المرضية والمنحطة، فظهور الكتابة أصبح “يفتح السبيل الأول إلى ما هو أبعد من لحظات السقوط والنهضة عبر التاريخ، وهو ما واصله في العقدين التاليين آخرون منهم رضوى عاشور وبنسالم حميش وأدونيس، ومظفر النواب، وأمل دنقل.
وبالرغم من هذا التحديد الذي أقامه أدونيس للإبداع بين التقيد التقليدي والانحياز الحداثي، قد ارتبط بفترة السبعينات المرتبطة ب (النهضة والحداثة) باعتبارهما وجهين لفترتين متميزتين شملت معها النقد الأدبي أيضا، فإنه سيبقى سؤالا مفتاحا حيث يقول: “ومهما يكن من أمر الرواية أو النقد أو الثقافة فسيبقى إلى حين – لا يبدو قريبا – ذلك الغائب الحاضر (النهضة – الحداثة) سؤالا مفتوحا”.
لقد وجدنا في تحديد أدونيس لكل من الحداثة والنهضة في الإنتاجات الإبداعية والنقدية اقترابا ملموسا من واقع أدبي ونقدي فرض نفسه على مستوى صيرورة الساحة الثقافية، لكنه اقتصر في هذا التحديد على تلخيص ظاهري فقط كنا ننتظر فيه بعضا من التفصيل، المفيد أكثر، لكن هذا ما لا يمكن أن يلتزم به أدونيس لأنه يتعدى حدود مشروع الكتاب لأن الهدف ليس نقد النقد، بل إضافة إلى أن هذه السرعة في الدراسة تنطبق على جميع فصول الكتاب، لكن التحليل الظاهري يمكن تقبله وبالتحديد في هذا الفصل لأن الحديث عن السيرة للنهضة والسقوط يتطلب فصولا متعددة وليس فصلا واحدا، بالإضافة إلى أن هذا الفصل هو عتبة التفكير في قضايا وإشكالات ما تزال في حاجة إلى التفكير، وليس التحديد المطلق لقضايا يصعب الإحاطة بها في مؤلف ضخم، وليس في فصل من كتاب أدونيس، وإنما وضع يد القارئ والباحث على مظاهر عديدة من مظاهر الإبداع النقدي النهضوي والحداثي، لذلك يعتبر هذا الفصل من أخصب وأصعب فصول هذا الكتاب رغم غياب البعد التحليلي فيه.
فأدونيس في زمن الشعر، وفي صدمة الحداثة، وفي مجلة مواقف، ودراسات أخرى جعلت منه مناضلا مبدعا، يحارب الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومحمد عبده، وكل الذين يحاولون أن يسيجوا التراث دون قراءته مرة ثانية، وهذه الدعوة لم تكن برانية وبسيطة، بل تتطلب تركيبا معقدا كما يقول ريمون أرون، لأن أدونيس حارب هذا الفكر المعمي بلغة حداثية، وبأسلوب يفتش في طبقات الثقافة لمعرفة الذات المضمرة، قصد إبداع الخطاب الحواري ليتجاوز النمطية المعهودة دون أن يبرأ منها.
ويرى أدونيس في جميع الأعمال الإبداعية أنها جاءت نتيجة سيادة حدث سياسي أو اجتماعي عميق، أثر في العالم العربي، لذلك أصبح المبدع نفسه فرد من المجتمع، فقد كان من الطبيعي أن يعبر عن ذاته وعن غيره من خلال إبداعه الخاص.
ويعود هذا في تصوره إلى أن اللغة العربية مازالت تكتب في كثير من نماذجها تحت زخم الواقع وهديره الاجتماعي وأسراره الدفينة، وفي نفس الوقت هي بحاجة إلى وسيلة تلائم هذا التعبير لتناسب أهدافها قصد الخروج من أسر اللغة الواحدة إلى أفق التهجين والتعدد، نظرا لتعقد السرد بتعقد المواضيع المتناولة على حد تعبير نبيل سليمان.
وإذا كان قد اهتم بالأعمال التراثية الجديدة في تجلياتها الحداثية، فهو لم يغفل الإشارة إلى السيرة للنهضة والسقوط أو الانتصار والهزيمة، والتي رأى فيها الأثر العميق والإعلان عن نقلة جديدة ليؤطر الاشتغال الإبداعي منذ سبعينيات من القرن العشرين عبر سبيلين:
أولهما: اشتغل على لحظات النهضة بعمقها الشعبي ومحمولها الاجتماعي وأحيانا السياسي، فتصدرت كتاباته الشواغل التقنية التقليدية، ويعبر نبيل سليمان عن مميزات هذه الفترة فيقول: “وقد ناءت تحت وطأة المؤرخ ودهشة الاكتشاف وتمجيد الماضي”.
ثانيهما: اشتغل على لحظات السقوط وبخاصة لحظة 1967، فاشتهرت كتابات هاني الراهب وحيدر حيدر وغادة السمان وسواهم، وقد غلب على هذا النوع الشواغل التقنية للحداثة، ويرى أدونيس أن هذا النوع من الكتابة قد شكت من ضمور النقدي فيها وناءت أيضا تحت وطأة الهجائية والعصابية والشعارية … مما جعل الإبداع العربي يرتبط بالمعنى الواحد، والوحيد، ولا يعطي الأهمية للعوامل الخارجية سواء كانت اجتماعية أو سياسية، أو معرفية، لهذا بقي الإبداع العربي يلوث أطياف الذكريات، ويستشرف نحو أفاق مجهول، دون طرح السؤال ما الكتابة.
وما هي شروط فعل القراءة الإبداعية؟
إن ظهور سوسيولوجيا القراءة لأول مرة من طرف الأمريكي دوكلاسوألياس نظرا للانحراف الأخلاقي، والاجتماعي، عمل على تشجيع القراءة، باعتبارها عملية بنائية سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي[3] وقد عملت المناهج على رفض انطلاق النصوص، سواء على المستوى الماهوي، أو الدلالي، أو التاريخي وقد أكد السوسيولوجي أن القراءة لا يمكن فصلها عن متغيرات الواقع[4].
فالنص لا يمكن اعتباره نصا مغلقا على ذاته، بل هو نتاج اجتماعي حقيقي، وتناصي، لكن البناء الاجتماعي المفبرك يستطيع أن يؤسس لنفسه فكرا أو ثقافة بعيدة عن الواقع، وهذا ما شاهدته عصور “الفن للفن”، وهذا التصور الإيديولوجي لا يستطيع التخلص من سياقه، ونسقه الاجتماعي لأنه يفترض قوالب وصيغ مشتركة[5].
هكذا نجد أن هذه الأطروحة هي تأسيس نظمي للقيم، واستراتيجية توجه القراءة وتحدد لهم مراجعهم الخاصة، وتمنح له افتراضات مسبقة[6] لهذا عملت السوسيولوجيا باستخلاص بعض المفاهيم من الدراسات الأدبية، من بعض الدارسين ككولدمان، ولوكاتشوإيزر وبيير زيما، وانكاردن، وديريداوغدايروتودوروف وغيرهم، ومن بين هذه المفاهيم – رؤيا العالم – الوعي الواقعي – الصراع الإيديولوجي – الوعي – الممكن، الفهم – الشرح – المادية الجدلية – التفسير – التأويل كلها مفاهيم تنتمي إلى حقول معرفية وإنسانية متنوعة، تعيد للقراءة دلالتها في كل مرة وفي مواجهة تصورات ذاتية وكذا تفكيك شفراتها ومعاييرها، فالقراءة عند أدونيس هي مراجعة ثانية للسائد، وبناء رؤية جمالية سواء على المستوى التلقي، أو التأويل المقروء.
من هنا يظهر لنا عزوف العرب عن القراءة نظرا لعدة عوامل منها بيئية، وأسرية واجتماعية، وسياسية، وايكولوجية، فهذه العوامل جعلت الفاعل لا يرتبط بالاستراتيجية التأويلية، ولا النقدية بل يبقى أسير النمطية التاريخية التي تعمل على تسييج خياله، وإبداعه[7].
إذن لابد من الرغبة في القراءة لتقويض الفكر المغلق أو الأورتودوكسي كما حدده محمد أركون في كتابه “الأصول” أو الفكر الإسلامي لأن القراءة هي تحول فكري وصيرورة تاريخية وإبداعية، لا تقوم على الاختزال،بل تمتد إلى المرجعية كجهاز تأملي، يعاد للذات القارئة فكرها، وتعددها الإبداعي.
إن تأسيس الكوجيطو العربي “أن عربي أنا قارئ فاعل/هو منطق، وخطاب إنتاجي لا يختزل الذوات ولا يشطرها، بل أن يفكر العربي بفكر متعدد من أجل إقامة تفاوض بين المغلق/والمفتوح والمستهلك/والمنتج، والتفسير/والتأويل، وذلك من أجل اقحام الواقع في سياق ثقافي عام ندعوه بالقراءة العربية تارة، وبالثقافة القارية المعاصرة تارة أخرى، وفي هذا المناخ المتعدد المشارب، نضع الخطاب القرائي موضع التساؤل “لماذا لا نقرأ؟” فالسؤال يستدعي معالجة أكاديمية صرفة، وتفترض فيضا معرفيا لا يقول شيئا عن الواقع وتلك المعاينة، لأن هذا الخطاب يتأثر في المقام الأول بصنف تأمل – نقدي، من حيث أنه يسعى إلى كشف حساب – التأخر – لا من باب التراكم المدرسي، بل بمقاييس نمو الوعي القرائي النقدي الذي من أهم إشعاعه، القراءة للجميع وبالتالي القدرة على المنافسة الإبداعية.
إن هذا الرصد المنهجي كما ذكرت، يندرج بشكل ما في ذلك الخطاب النقدي – لا يسعنا فيه إلا أن نبدي رأينا حول القراءة – بكل اختلالاتها الوظيفية، فهو مفهوم متعدد، يتوافق ويتكامل نسقه مع المتلقي، ولعل هذا ما يبقي للإنسان في هذا العالم لكي يقاوم النسيان، وهي التي تدفعه إلى الارتباط بالتاريخ والالتزام الاجتماعي والانخراط في المعاصرة، وفي أجواء العولمة، فبدون القراءة لا تكتمل الشخصية الإنسانية، فهي الإشعاع لوجوده، ونسيج لنموه وحوار لفهمه، وإقامة لوجوده، ونزوع نحو المشاركة في بناء قيم وطموحات فالقراءة عند أدونيس هي وعي وجودي، وخلخلة للمألوف، وكسر للمقدس، وتمرد على كل ثقافة تقوم على المشابهة والمماثلة.
وامتلاك للنص القارب، هو تشظي لهذه الذوات، ووعي وجودي يمثل الهوية والماهية الأنطولوجية، بحيث يمكن للذات الأدونيسية أن لا تقف عند لغة الانتحال، ولا الشرفة كما ادعى “كاظم جهاد” إنه يعكس الغرب من خلال الفهم الذي يمارس عليه وفيه، واكتشاف وتوصيل إلى الآخر، وذات مؤولة هي التي تبني لنا – لعبة القراءة – وتركبه من خلال المؤجل، والأصل كما يقول جاك ديريدا، يسعى في كتاباته إلى العثور على شيء لا يسكن التراث واقعيا، بل مكتشفا النقص في الحداثة العربية بوازع فكري تنموي، قبل أن يكون وحدة متنامية في الجمل الشعرية القديمة، يريد أن يؤسس لهذه القراءة من خلال النص الآخر، ليس بالمفهوم الإقصاء أو التسلط كما يقول بيير بورديوفي كتابه “أسئلة حول علم الاجتماع”، فأدونيس يتميز بالتعارض دون إلقاء المرجعية الذاتية، خالقا صراعات داخلية في الحقل المعرفي حسب مفهوم بورديو، يحول الأشياء ذاتها لترى نفسها في التعدد، وفي علاقتها بالقوى الإنتاجية، لا المعنى فقط، لأن كل حقل قرائي هو لعب يمثل الرهانات الموجبة والغير المنغلقة، ولا يؤمن بالتفاعلات والتداخلات المتناهية، بل بالفراغ والمؤجل من أجل تحقيقالإنجازات الخارجية (الدين – الثقافة) والداخلية الجمالية اللغة، كلها تتداخل في الحقل الثقافي المنفتح، إذن كيف يحمي أدونيس حقيقته ووجوده المعرفي؟
سؤال يشرعن مقاييسه، ليكون النواة الجوهرية في التطور المجتمعي العربي، دون السقوط في المناكيافيليةوالسينوزية، يمدنا بفلسفة التاريخ، وعلم الاجتماع الديني والسياسي لمواجهة التراث والسلطة– والثقافة – والإبداع … كلها مفاهيم تميز بين ما هو عضوي وما هو تقليدي، تميز ينبغي الاستماع إليه كضمير نقدي، يعيد المثالية المطلقة / بمفهوم هيجل إلى وجه المعالجة الإكلينيكية من أجل فهم الشروخ والثغرات التي أصابت العرب، وهذا التوجه يستوجب منه جرأة وحسا تفاعليا دون نزوع استتيكي (كلي)، وهذا الإحساس خلق له أعداء (حراس الجهل المقدس) داخل الساحة الثقافية، فظل يشخص المفاهيم بالبرهان وبالمنطق الروسي، الفوكوي، والتشومسكويوالديريدي، يحاور الكلام المرتبط بالحضور (الهوية – والوحدة والبداهة)، ويخالف السائد بالكتابة والقراءة وبالتعدد كما يقول عبد الله إبراهيم (في معرفة الآخر، ص: 13) وهذا اللاتطابق يؤسس الأشياء لكي يختفي المتناهي والثابت، باختفاء القارئ المنمط، والذي لا يملك خاصية البقاء كما يقول جاك ديريدا في كتابه (الكتابة والاختلاف، ص: 36).
فالكتابة عند أدونيس هي اختيار منهجي،يتفاعل فيه قوانين التحول الخاص به وبنا، فهو تصور ثلاثي الأبعاد، الكلية والتنظيم الذاتي، والاختلاف، فهذا الثالوث هو عبارة عن منظومة متكاملة من المعارف والقيم الجديدة التي هي سر بقاء “الهامش” على مر تاريخ الحضاري مؤثرا وفاعلا في صرح المركز وحفظه من التلاشي، والتخلف، فخلف أي عمل إبداعي كما يقول جورج سانتيانا في كتابه “الإحساس بالجمال”، يتم التعبير عن هذه الكتابة بأسلوب واعي ليعيد تشكيل الذات المنكتبة فوق البياض، وهذا التناص هو امتصاص (كريستيفا) لقراءات تعمل على تحول المقروء إلى المدون، وأدونيس قد بدأ بتشريح الثقافة الأدبية والصوفية، والفلسفية والدينية باعتبارها مركبة من استجابات دالة، تفسر بنياتها الفرعية والأصلية.
فهذه الكتابة هي تقويض ونسف للقيم السالبة لكي يقدم البديل البنائي، دون السقوط في التدجين، والاحتواء والمركزية كما يقول جاك ديريدا.
ومهما يكن فإن الأثار الكاملة لأدونيس زمن الشعر، ومقدمة للشعر العربي، وفاتحة لنهايات القرن، والثابت والمتحول وسياسة الشعر، والشعرية العربية، والصوفية والسريالية، فهذه المتون المتنوعة جعلتني أعود إلى قولة مالارمي حين قال Il s’est apéré vivant de la littérature إني أجري عملية جراحية وخلصته من الأدب وهو حي، فالكتابة عنده (أدونيس) هي رحلة ضد الموت الطبيعي، وتمرد يبعدنا عن الماضي، ويقربنا إلى فرح الموت الإبداعي، فأدونيس يهدف دوما إلى تقويض الثابت من أجل بروز الكتابة كرؤية جديدة، وهذا النبش في طبقات المتخيل الشعري والفني، والتراثي، جعله يعيد الهارب، والمحتجب إلى أصالته، وشعريته، لأن الكتابة هي عنف لذوي يؤسس للمبدع ذاتيته، وهويته، ويجعل اللغة تسكنه قبل أن يسكنها فأدونيس أقام حركة حداثية متنوعة، مؤسسة على مفهوم تكسير (المرجع) تأسيس أمده برؤيا نقدية للأوضاع العربية، وخاصة السورية، لأن العنوان هو الكتابة التي هي علاقة جدلية بين الذات والموضوع، وبين الحرية، والضرورة وبين الحضور والغياب، تشكلت عنده هذه الرؤيا الإبداعية من أجل طرح السؤال “هل نكتب؟ وأين نحن من الكتاب الآخرين؟، وهل نملك كتابة إبداعية، أسئلة أمدتنا بقضية جوهرية وهي أن حداثة الكتابة لا تكمن في الخروج عن المعهود، وإنما تعني بتجديد الرؤيا، والوعي، والثقافة ونظرة إلى الحياة، هكذا عمل أدونيس على تكسير قوالب الكتابة الرمادية من أجل بناء أسئلة التي لازالت تقلق الإنسان العربي، منها، علاقة الكتابة بالسلطة، والكتابة / والحداثة، والكتابة والجنس، والكتابة والتراث وغيرها …
[1]– بول ريكور، نظرية التأويل، تر: سعيد الغانمي، م – الث – العربي، ط: 2003، ص: 128.
[2]– محمد برادة، أسئلة الرواية، أسئلة النقد، حوار المستحيل، مجلة الآداب، العدد 3 و4، 1980، ص: 19.
[3]– جاك لينهاردت، مدخل لسوسيولوجيا القراءة، ص: 148.
[4]– المرجع نفسه، ص: 149.
[5]– جاك دوبو، سوسيولجيا النصوص الأدبية، ص: 152.
[6]– أحمد المديني، حوار مع جاك لينهاردت حول محاور الأدب – الثقافة – التلقي، مجلة الفكر العربي المعاصر، ع: 13، ص: 345.
[7]-France Vernier, lcchiture et les textes, ed sociales, Paris, 1974, P : 48.






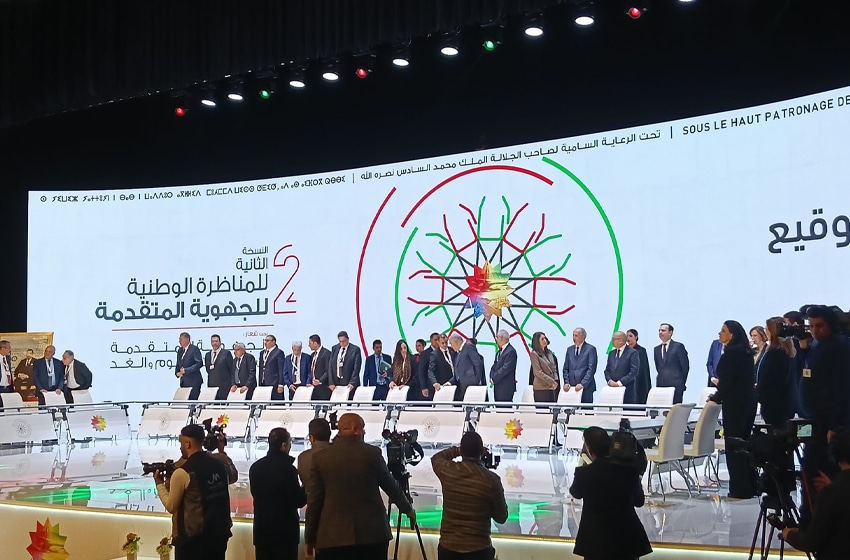








تعليقات الزوار ( 0 )