واجه النظامُ السياسي المغربي منذ “الاستقلال” إلى اليوم أصنافاً من المعارضة متمثّلة في أحزاب وحركات وجمعيات وشخصيات مستقلة، تتباين قوةً وتنظيماً وفكراً وسياسةً وتأثيراً وسط الشعب. وعلى مدى عقودٍ تراوح أسلوبُ المواجهة بين القمع المباشر الشرِس والاحتواء الماكر المتدرّج بالمنصب والمال “النجِس”. وكان من يلجأُ إلى الخارج هرباً من الاغتيال أو السجن أو الاضطهاد كأنه رحل الى جزيرة الواق واق، تنقطعُ أخبارُه بالكلية، فلا تَسمع عنه نمةً في مذياع، ولا تقرأ له أو عنه سطراً في صحيفة. كانت السلطةُ تركضُ وحدها في ساحة الإعلام، وعلى الهامش المتروك دعاية ومناورة تحسبُ صحافةُ المعارضة في الداخل خطواتها كيلا تتعرض للمنع المؤقت أو الدفن المؤبد. وإذا حدث استثناءً أن تُجُووِزَت الخطوطُ الحُمر، يتصدّى للاستثناء “زوارُ الفجر” من المخابرات، فيحجزوا العددَ الذي احتضن بشكل من الأشكال المُعارِضَ الفلاني من منفاه وانتهى الأمر.كانت السلطةُ تنام في بيتها المحروس مِلأ أجفانها لا يكاد يزعجها إطلاقا تحرُّكُ المُناوئين في الخارج. فلم يكن رجل “الشارع” يعرف إبان تلك الفترة أي شيء عن الشخصيات المعارضة في المهجر مثل محمد الفقيه البصري، عبد الكريم مطيع، مومن الديوري، أحمد بناني، إبراهيم أوشلح…
ورغم أنه في بداية السبعينات كان معارضون مغاربة في ليبيا الثورة يَخطُبون عبر برنامج إذاعي يُبَث من هناك يُحاوِلون استنهاضَ الجماهير، فإن تأثيرهم ظل محدودا جدا إن لم يكن منعدما بسبب طبيعة تلك الفترة التاريخية، وظروفها الاجتماعية والسياسية، وإمكاناتها التقنية…
أما المناضل الفذ المهدي بن بركة الذي اختُطف ثم اغتيل ببشاعة في فرنسا سنة 1965، فيكاد يكون المعارض الوحيد في ذلك الوقت الذي قتل من طرف السلطة في الخارج، ليس خوفا على الداخل المغربي منه، بل إذعانا لرغبة بعض القوى الليبرالية الكبرى في التخلص من زعيم اشتراكي شاب ونظيف يُزعِج بكثرة تحرُّكاته على رأس حركة العالم الثالث المُناهِضة لسياساتها. قلتُ “يكاد” لأنه قد يوجد استثناءات مثل المقاوم سعيد بونعيلات الذي سلّمته الفاشية الإسبانية في عهد الجنرال فرانكو إلى السلطة في المغرب سنة 1969، ثم المناضل النقابي الحسين المانوزي الذي اختُطف من قلب مطار تونس سنة 1972 وأُعيد إلى المغرب دون أن يُكشفَ عن مصيره إلى يومنا هذا. على أن قرار تنحيةُ الإثنين لم يكن نابعا من الخوف على تأثيرهما شخصيا على الداخل، بل من رغبة هوجاء في الانتقام، ورغبة طائشة في بث الرعب أكثر في نفوس المُعارضين أينما كانوا.
منذ أواخر السبعينات من القرن الماضي تقريبا بدأ عددُ المهاجرين المغاربة إلى أوروبا يرتفع اطّراداً كل سنة بسبب تدهور الحياة العامة وانسداد الأفق. وقد توسّعت دائرتُهم لتشمل بالإضافة إلى العمال اليدويين الطلبة والأطر العليا والمثقفين. فلم تجد الدولة إزاء هذا الواقع الجديد سوى أن توليه كامل اهتمامها وَفق رؤية خاصة تقوم على ثلاث:
– صون الهوية الدينية للمواطنين في الخارج بالتعبير الرسمي، أي الإسلام السُّني المالكي، أن تتسرب إليها مذاهب أخرى فيصير البلد عرضة للانقسامات والصراع الطائفي.
– الحفاظ على تحويلاتهم المالية نحو المغرب التي تعتبر المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية به، وهو عامل مهم في تقليص العجز التجاري المزمن.
– تطويق أو على الأقل مزاحمة خطاب المعارضة الراديكالية الآخذ في الانتشار التي صارت تشمل إلى جانب اليساريين فئة الإسلاميين.
هكذا عمدت الدولة إلى إعداد أئمة المساجد والخطباء وبعثهم إلى الديار الأوروبية للإشراف على تديُّن المغاربة، وإلى رفع كل الحواجز الإدارية التي تعوق تدفق المال “المُهاجر” نحو الصناديق المحلية، وإلى تأسيس الجمعيات لتأطير الطلاب والعمال، وتنظيم اللقاءات الثقافية والمعارض الفنية تحت مسميات وشعارات مختلفة. ولئن كانت الدولة قد نجحت إلى حد بعيد في بلوغ الغايتين الأوليين، بغض النظر عن ماهية هذا الإسلام المسمى عندها سُنّياً مالِكِيا، فإنها فشلت فشلا ذريعا في تحقيق الهدف الثالث. والسبب ببساطة وجود المهاجرين المغاربة في قلب الديمقراطية الغربية، ومُعايشتهم اليومية للبون الشاسع جدا الذي يفصل العالم الغربي الذي يتملى في بحبوحة الأمن والثراء والحقوق والتكنولوجيا عن بلدهم الأم الغارق في وحل القمع والبؤس والأمية والفقر. وليس أدل على هذا الإخفاق من أنه كلما تسنح فرصة خلال ندوة مثلا لرمز من رموز النظام أو لأحد المتعاونين معه أو إبان أحداث كبرى إلاّ وظهر صوت المعارضة الراديكالية بالخارج تعليقا أو كتابة أو تظاهرا في العواصم الأوروبية الكبرى، مطالبا بالحرية والديموقراطية وثروات الشعب المسروقة. ولئن كانت هذه الصيحات تذهب من ذي قبل أدراج رياح أوروبا أو أمريكا الباردة لا تبلغ سوى مسامع فئة قليلة من المهاجرين، فإن الواقع في السنين الأخيرة – التي لا تصل عشراً في تقديري – قد تغير تماماً وبشكل صادم لم يكن في الحسبان. ففي مغرب اليوم يتردّدُ صوتُ المعارضة المُهاجرة في كل حي، وفي كل قرية، والقناة الجديدة التي لم تكن من قبل ولم تطفْ يوما بخيال النظام هي: وسائط التواصل الاجتماعي.
بلمسة على الهاتف أضحى ذلك القروي المنسي في الجبال الذي لم يكن يعرف فيما مضى موقع عاصمة بلاده، ولا معنى أو مبنى الانتخابات التي يساقُ إليها كما تُساق البعيرُ، حاضراً في قلب باريس أو أمستردام وسط حشد المتظاهرين المغاربة الناقمين على النظام! من هاتفه الذكي صار ذلك الشاب العاطل، الذي كان يقضي سحابة يومه في مقهى الحي يتابع تفاهات التلفزة الرسمية، مُشاركا في ندوة منظمة في نيويورك حول المغرب لا سقف لمناقشاتها، أو مستمعا مباشرة عبر موقع يوتوب إلى الناشط الفلاني في السويد أو كندا وهو يُعري أمام عينيه، أحيانا بالوثائق والحُجج الدامغة، فساد الدولة وخفايا السلطة، ويشرح أسبابَ عطالته وفقره. ثورة إخبارية لا سابق لها في تاريخ البشرية أزالت غمّاضاتِ السلطة الداكنة عن أعين الجميع، وخطاب سياسي “صادق” اللهجة عالي المطامح غير مألوف يُزْري بِسُكونية الأحزاب البرلمانية في اليمين واليسار على السواء، يركُل صباحا ومساءً بل في كل لحظة وجهَ كل نائمٍ ما يزال على ترانيم السلطة التي ما عادت تُدغدِغُ حتى مشاعر العجائز اللائي لا يقرأْن.
إن تأثير معارضة الخارج على الداخل المغربي هائل جدا، سيّما أنها غدت جامعةً لكل الاتجاهات الفكرية خلافاً لفترة الستينات والسبعينات التي كان يُهيمن فيها الإيديولوجيا اليسارية والقومية. يكفي كتابة إسم أحدهم على موقع يوتوب الشهير أو فيسبوك للتحقق من حجم المتابعة ومساحة الانتشار. إن هذا التأثير المرشح لبلوغ مداه بظهور تقنية الجيل الخامس وتطوُّر تكنولوجيا الاتصال عامة أربك السلطة كثيرا. فجعلت تارة تسخر من التدوين على الفيسبوك مُعتبرةً إيّاه صبيانية من مجهولين، وتارة أخرى تتحدث عن وضع قوانين صارمة لضبط النشر على وسائط التواصل الاجتماعي بالنسبة للمتفاعلين مع منشورات المعارضين، وطوْراً تلوذ بالصمت حتى تمُرّ العاصفة.
لا ريب أن السلطة أدركت مبكرا الأخطار السياسية الأمنية لهذه الوسائط المتكاثرة على استقرارها ووجودها. ففد انهارت عُروشٌ ونُظُمٌ سياسية أكثر قمعا في المنطقة العربية بفعل ثورات انطلقت شرارتُها واستمرت عبر الأنترنت “الاجتماعي”. لكنها تردّدت طويلا قبل أن تحسم اختيارها لمواجهة هذا السيْل الإعلامي المُدمِّر لكل ما بَنَتْهُ. وأعتقد أنه صار مكشوفا للمُتابع اليقظ أنها بدأت منذ بضع سنوات استراتيجية الذباب الإلكتروني لنشر تصوُّراتها والتشويش على ما يناقضها، ثم خلق أحداث هامشية لتحويل الأنظار عن القضايا المصيرية، والاعتماد على خلايا تابعة للمخابرات مُهمَّتُها نشر الفيديوهات والمقالات التي تهاجم كلَّ شيء إلاّ مكمن الداء ومنبع الفساد. كما عمدت أخيرا بدهاء إلى تحريك أتباعها في الخارج للنشر على الأنترنت بوجه مكشوف غالبا بطريقة تجعل المواطن البسيط يفهم أن هؤلاء “الهاربين” من ظلم الوطن هم المناضلون حقا المدافعون عن الشعب. ومن الأمثلة الواضحة التي تظهر اعتماد السلطة على تضبيب الرؤية وتمييع المشهد كاستراتيجية للمواجهة، قيام أحد العسكريين قبل ثلاث سنوات تقريبا بمغادرة المغرب وطلب اللجوء السياسي في أوروبا، ثم الشروع عبر موقع يوتوب في مهاجمة النخب الحزبية والفاعلين السياسيين وكل من له صلة بالقرار باستثناء من يملكه فعلا، قبل العودة في السنة المنصرمة إلى دفء الوطن ليقدم خلاصة “سياحته” إلى عموم الشعب، وهي أن البلد سائر في طريق التنمية لا ينقُصه سوى بعض الإصلاحات وإبعاد المُفسدين (منْ هم؟!).
أما على الصعيد الميداني، فيبدو أن السلطة قد وطّدت أركان سياستها الجديدة ضد المعارضة الخارجية على تكثيف حضورها في الخارج فكريا وسياسيا وثقافيا ودينيا، ثم على “البلطجة” كنسف ندوات المعارضين التي تُجرى في بعض الدول “الصديقة”، على شاكلة ما حدث في باريس في فبراير من السنة الماضية، حيث عمد مغاربة إلى شتم المشاركين في الندوة بصوت عال متواصل، وإلى قطع الكهرباء عن القاعة، وإطلاق روائح كريهة (انظر: مقال “ندوة في باريس حول حرية الصحافة في المغرب تتعرض للتشويش” المنشور في صحيفة القدس العربي يوم 17 فبراير 2019)، أو تنظيم مُظاهرات ووقفات مضادة في المكان عينه الذي يقف أو يتظاهر فيه المعارضون.. ولهذا الغرض دعمت السلطة تأسيس جمعيات من طرف ناشطين “مستقلين” يُعلنون الدفاع عن البلاد وعن الملكية في مواجهة من يُسمونهم الخونة وأعداء الوطن، مثل حركة الشباب الملكي، وجمعية حب الوطن أولا، وفيلق الملثَّمات…
من الواضح أن الصراع بين المعسكريْن اللذيْن يقفان على طرفي نقيض يزيد احتداما يوما بعد يوم من جرّاء تدهور الوضع العام في المغرب، وانسداد قنوات الحوار الجاد مع معارضة الداخل الموجودة خارج النسق السياسي الرسمي، وغياب البديل السياسي ذي الامتداد الجماهيري المقبول من طرف السلطة القادر على وقف السقوط وتغيير الوضع. لكن لئن كانت كفة الصراع تميل في السابق لصالح النظام لاحتكاره أولا وقبل كل شيء سلاحَ الإعلام فيما المعارضة عزْلاء، فإنها اليوم تميل إليها بما لا يُقاس للسبب نفسه، خاصة أن هذا السلاح تطوّر بشكل مُذهل قلب ساحة المعركة رأسا على عقب، وصار أشد فتكاً مما كان عليه في الماضي.
mouhcinou20f@gmail.com







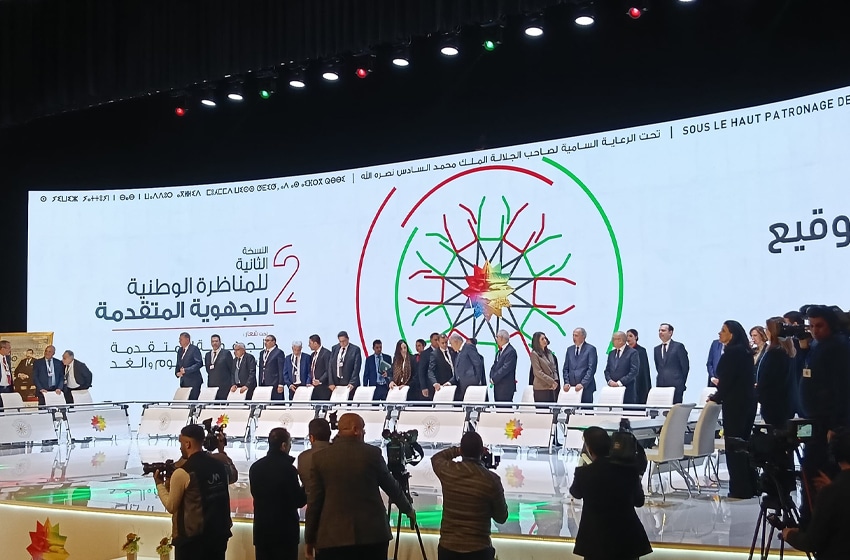







أنا عمري 13 عاما وأحب السياسية، إلا أنني ضعيفة فيها وأنا ضد النظام المغربي، آمل أن نرجع كلنا إلا بلادنا ونبنيها من جديد، و أن يكون دستورنا القرآن وألا يكون هناك أية ملكية أو حكم عسكري من طرف مجموعة من الناس الذين يرثونه من بعضهم،أنا أؤيد المعارضين والناشطين السياسيين،وأريد أن أشارك في بناء بلدي عند رجعتي و أن أدرس جيدا وأتفوق من أجل رفع رأس العرب والمسلمين ومن أجل مساعدة الضعفاء وتأسيس جمعيات للبشرية أين ما كانوا.
قامت ثورات في اغلب الدول العربيه ضد حكامها ماالذي تغير بعدها اصبحت تلك الدول اكثر دكتاتورية واكتر،فسادا لماذا لان الشعب العربي ببساطة همجي والديمقراطية بنسبه له شيئ غريب عنه يثرترون في المواقع بكترة الشعارات وكلام عن الديمقراطية لكن في الواقع شيئ اخر انا مع الحكم الملكي وافضل ان يحكمني ملك ابن ملك ابن ملك شبعان وولد الخير على ان يحكمني جعان لم تنجح اي ثورة عربية حتى الان الا باستبدال ديكتاتور بأسوأ منه، أو بإفقار البلاد والعباد، أو بإنهاك النظام الحاكم وتحويله الى طرطور وتسليمه للغزاة والمحتلين كما هو الوضع في سوريا المعارضه في الخارج لن تحقق شيئ وخصوصا في عصر الانترنيت غير انها ستحرم من دخول هذا البلد الغالي وستظل لاجئ في بلاد ناس ويموت مجهول هناك ومنبود
النظام المغربي آيل إلى السقوط، والسقوط مسألة وقت فقط… وإذا تأخر بعض الوقت ووافت المنية أحد المعارضين في الخارج فلا أقل من كونه يموت حُراً شريفا كريما عزيزا ..