تعتبر فكرة “المواكبة”، أحد أهم الأفكار التي تقود المرحلة وتعلوها كعنوان رئيس في مختلف المجالات التي يصبو الإنسان للارتقاء بها، أو إحداث تقدم يساير معطيات الحياة الواقعية التي يعيش في إطارها ويتفاعل مع محتوياتها.
وفي خضم ما يواجه المجتمعات الإنسانية على اختلافها من مستحدثات متسارعة التغيير والنمو في مختلف المجالات وعلى رأسها على المجال التكنولوجي والتقني، فإن كل أطراف وقضايا الوجود الإنساني التي ارتبط تطورها بالتكنولوجيا المتغيرة تصبح بشكل منطقي معوزة لمواكبة توازيها بالقوة والمتطلبات التي تضمن لها الاستمرارية. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق عن كيفية بناء المنهج الحاكم لطبيعة المواكبة ومستواها وخصائصها، وبخاصة في ظل التنوع الغزير والحاجة الكبيرة لإحداث إصلاحات معمقة وسطحية في كل من المسارات الموضوع تحت عدسة مجهر التغيير والمواكبة التي تحدثنا عنها.
وحتى نستطيع الوصول لنقاط مشتركة جامعة تمكن الإنسان من الابتعاد عن المسافات الضبابية والدلالات غير الواضحة في رحلته نحو “الأفضل”، و “الأكفأ”، لكن لا بد من أن يبنى على إدراك وتفريق بين أنواع المعرفة، وتسليط الضوء بشكل خاص على المعرفة الواضحة، والمعرفة الضمنية، وهذا لا يتداخل مع الخطوات البنيوية الأولى لتطبيق أي مشروع إجرائي، بل يعنى بتلك المساحات “النوعية” حيث يتجاوز الإنسان مستوى الخطط النظرية المجردة، وينتقل ليمعن في طبيعة بنيويتها، وكنه منطلقاتها، الأمر الذي يعني القدرة على توصيف دقيق للحالة المعرفية حول أي من القضايا والمجالات، واستشراف ممنهج يبنى على كل شيء الا العبث أو الصدفة. والقدرة على التطوير في كل مرحلة بما يوفر الكثير من الوقت والجهد لإعادة الفهم والقراءة.
فأما فيما يتعلق بما نمتلكه اليوم من المعرفة الواضحة، فهي تعلو قمة الهرم وبخاصة في عصر التكنولوجيا الإخطبوطية، التي جعلت من المعلومة أكثر “السلع” توافراً وإتاحة، وبالتالي فهي وبالرغم من أهميتها إلا أنها لا تعد محور التمييز والكفاءة، وذلك بسبب سهولة الوصول إليها والقدرة على توفيرها في أقل الإمكانيات من مثل التكلفة، أو الوقت والجهد الذي نحتاجه للحصول عليها، وبالتالي يمكن نعت الوقت الذي نعيش فيه بأنه: (زمن وفرة المعارف الواضحة).
وبالنظر إلى النوع الآخر للمعرفة، وهي المعرفة الضمنية، فيجب الوقوف مطولا عليها حتى نستطيع فهم الماهية التي تمكن العقل الإنساني من تحقيق المواكبة الفعلية فيها، وبخاصة أنها تمثل “سلة الخبرات” التي أضيف لها “اللمسة السحرية” من حيث استحالة تشابهها بين فرد والآخر، فهي تتعلق بكيفية تكوين الاتجاه المعرفي والمسار الفكري، ونتاج التفاعل الادراكي والحسي الذي يختلف بحسب مستوى الخبرة، والمجتمع المحيط، والعوامل والدوافع التنشيئية وغيرها من العمليات والتفاعلات المرتبطة بالتحليل الذهني، فالمعول اليوم ليس على المعرفة الواضحة بقدر ما هو متعطش لمعرفة ضمنية ذات تأثير نوعي وفريد، ولذلك فإنها (المعرفة الضمنية) تتربع على عرش “كنز المستقبل” ومن خلالها يمكن أن يجد الإنسان مفتاح الحل لأحجية طال تفكيره فيها، فكيف يمكن للإنسان تحقيق ذاته بامتياز يجعل منه مختلفاً -بالمعنى الإيجابي- في عصر “زخم المعلومة”، وتعدد مصادرها؟ نعم إن ذلك لا يكون إلا من خلال تكوين معرفة ضمنية ثمينة في خبرتها الواسعة مترامية الأطراف، وقادر على الانتقال من مستوى الوعي إلى مستوى آخر مختلف في الملكة ولا إدراك والمهارات الذهنية مثل التحليل والتفسير والقدرة على تكوين وجهة نظر نقدية متزنة.





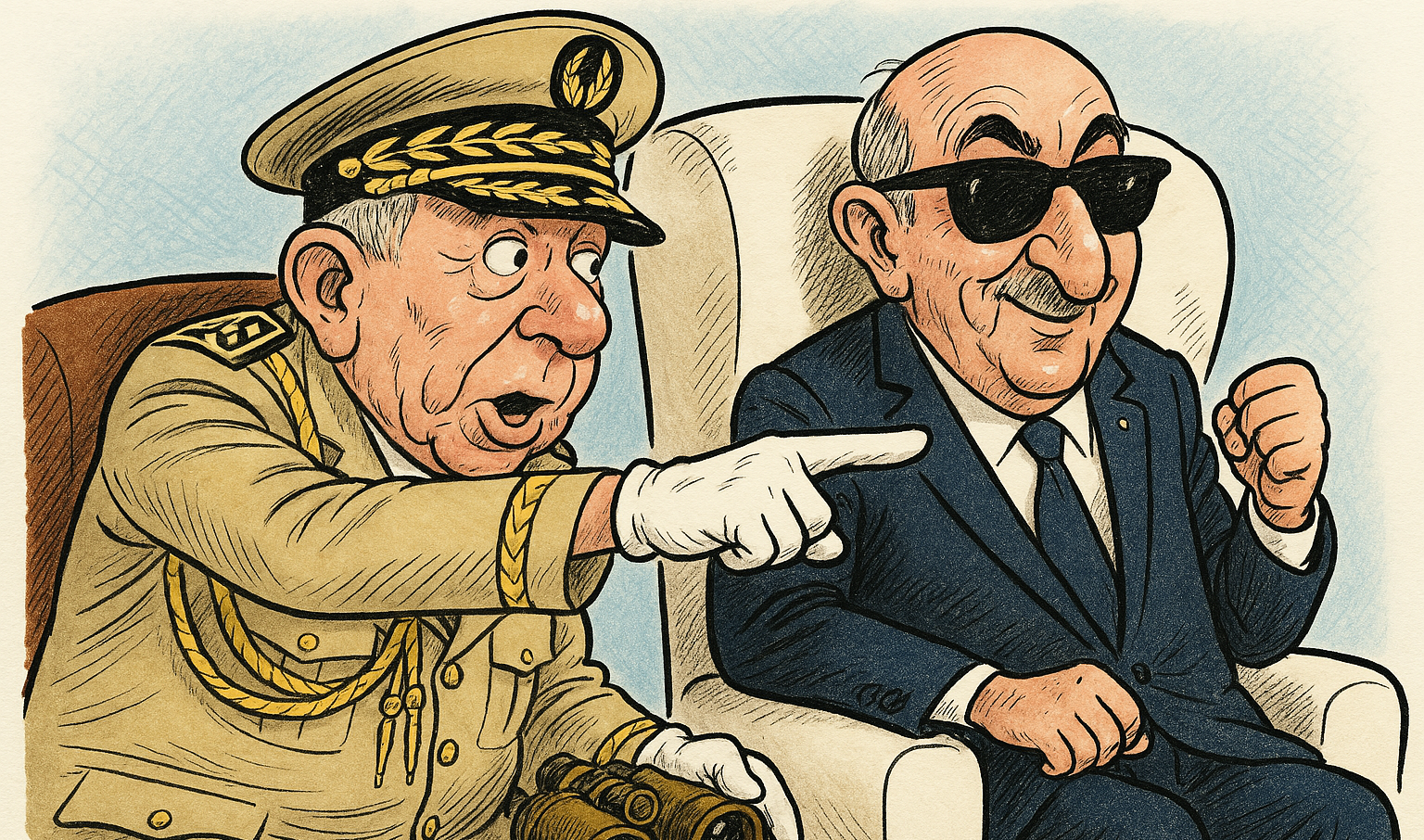









تعليقات الزوار ( 0 )