ما كنت أحسب أن مكالمة هاتفية عادية، مع الصديق الباحث المتميز إدريس جنداري، امتد فيها الحديث، الذي جاء في سياقه بأني تقاعدت، أن تثير لديه ما سماه «كلمة حق» نشرها في صفحته على الفيسبوك، وكانت مدار ردود أفعال كثيرة من طلبة قدامى ومحدثين، وأصدقاء وأكاديميين من المغرب والوطن العربي.
ابتدأت كلمته بما يلي: «وصلني خبر تقاعد الأستاذ سعيد يقطين، مهنيا كأستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط، متأخرا. أثار الخبر في نفسي شجنا لم أقدر على مقاومته إلا بالتدوين». وألهمت تلك الكلمة الباحث عبد الرحمان سعيدي، الذي نشر بدوره كلمة سماها «بوح واعتراف»، جاءت مقدمتها على النحو التالي: «أستاذي العزيز؛ تلقيت منذ قليل خبر تقاعدكم عن مهنة التدريس والإشراف في الجامعة المغربية ( كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الرباط)، وكان بودي أن أتلقى الخبر بكل أسى وأسكت، لكن أحداثا وأزمنة وأمكنة تمارس عليّ ضغوطات لا أستطيع تشخيصها، ولا أقدر على السكوت عنها». وتوالت التعقيبات من كل حدب وصوب.
تشترك كل الكلمات والتعقيبات في التأكيد على أن الأستاذ الجامعي لا يتقاعد، ولا يمكنه أن يتقاعد عن العمل ما دام لديه ما يمكن أن يقدمه لطلبته الذين يبادلهم المحبة والعطاء. إني أتفق مع الاتجاه العام، وأشكر كل الذين عبروا عن مشاعرهم، وذكرياتهم. إني أرى في كل قدموه من عبارات مؤثرة قيودا تكبلني، وتدفعني إلى بذل المزيد من الجهد، رغم كون الظروف العامة التي نعيشها لا يمكن أن تؤدي إلا إلى الإحباط والشعور باليأس. لكن هذا التفاعل الإيجابي يبرز أن الأمل معقود على الأجيال القادمة، رغم مختلف مظاهر التراجع والنكوص في المسيرة الثقافية ـ الاجتماعية العربية العامة.
إن الشجن والأسى اللذين أحس بهما العزيزان حاليا، كان يقابلهما بالنسبة إليّ فرح واغتباط، وأنا أدبج رسالة طلب التقاعد النسبي، التي وقّع عليها رئيس الجامعة آنذاك يوما واحدا قبيل توليه مسؤولية الوزارة. كان لديّ الأمل في أن تكون الأمور اليوم أحسن من الأمس. وكنت مرتاحا مع طلبتي في الماجستير والدكتوراه وفي الإجازة. لكن تحولات طارئة جعلت جيلا من الأساتذة يرى نفسه وحيدا، بعد أن تقاعد من تقاعد، وتوفي من توفي ممن واكب معهم تاريخ تطور الكلية منذ الثمانينيات.
في آخر اجتماع لتشكيل المختبرات والمراكز في الكلية، قال لي التويجري (علم النفس): ألا تحس نفسك غريبا؟ كانت الغربة متعددة: تشمل لغة الخطاب، ولغة التطلع، ولغة التوازنات؟ ميزت في «دراسة حالة» جامعة محمد الخامس بين الجامعي والأكاديمي والعلمي (2018)، أكدت فيها أن الجانب العلمي غير متوفر، وأن الأكاديمي يقتصر على ما يقدم في مناقشة الرسائل من أخطاء لغوية، وغياب «المنهجية»؟ والخلط في كتابة الهوامش، وترتيب المراجع. أما الجامعي فيحضر في الدروس التي تملى على الطلبة الذين يطالبون بإرجاع البضاعة إلى صاحبها.
من حق الجامعي أن يتقاعد لأن علاقته بما هو أكاديمي حقيقي، وعلمي دقيق، غير متوفرة. لكن من يحمل مشروعا ثقافيا وعلميا، حتى إن تقاعد يظل عطاؤه مفيدا للقراء والطلبة، لأنهم جميعا سيظلون على اتصال به «عن بعد» (والشكر لكورونا التي دفعت إلى ميلاد هذا الخيار). وإني أتفق مع ما ذهبت إليه الجامعة الأردنية، في إعفاء الأساتذة الذين لم ينشروا في مدة معينة كتبا ودراسات، من مناصبهم. إن الأستاذ الجامعي الجدير بهذه الصفة هو الأستاذ الباحث، وحين نتلفظ بكلمة «الباحث» علينا أن نعطيها حمولتها الحقيقية. للأسف لا تحمل هذه الكلمة «أستاذ باحث» أي دلالة في ثقافتنا؟ في علاقتي مع عدة باحثين أجانب، كان تعارفهم معي يتم من خلال سؤالين لا ثالث لهما: السؤال الأول: ما هي الخلفية الفلسفية التي تنطلق منها في دراسة الأدب؟ والسؤال الثاني: ما هو المشروع الذي تشتغل به الآن؟ وما علاقته بما أنجزته سابقا؟ وما هو مستقبله؟ هل يمكننا تصور أستاذ باحث، بدون خلفية فلسفية ومشروع بحث مفتوح على المستقبل؟ كيف يمكن لأستاذ جامعي ألا يكون له اختصاص محدد يشتغل به؟ وكيف يمكن لأستاذ لم يقرأ رواية، أن يدرّس مادة «الرواية»؟ وهلم جرا. لقد فرطنا في الاختصاص عكس الجيل الذي درّسنا (أمجد الطرابلسي: نقد قديم)، (محمد برادة واليبوري: رواية)، (محمد بنشريفة: أدب أندلسي)… وفرطنا في الموسوعية التي كانت عند القدامى. هل يتحدد اختصاص الجامعي من أطروحته للدكتوراه؟ أم من المشروع الذي يشتغل فيه؟ أسئلة كثيرة جعلتني أفكر في الانسحاب، ونحن نعمل على تجديد بنيات البحث والمختبرات والمراكز، لأنني رأيت أنها لا تتشكل على قاعدة الاختصاص، ولا على الرغبة في أن تكون منطلقا لإعادة التكوين الذاتي والجماعي في نطاق محدد. كان تشكيل هذه البنيات ينبني على العلاقات الشخصية، وليس على مشاريع بحثية صرفة. وكل الهدف من ذلك هو: إضافة صفة ما إلى «السيرة الشخصية» للأستاذ؟
كل الكلمات والمشاعر الصادقة، وقود لمزيد من العمل الجاد والمتجدد، لأنها تؤكد على أن المجهودات الحقيقية لا تذهب سدى.



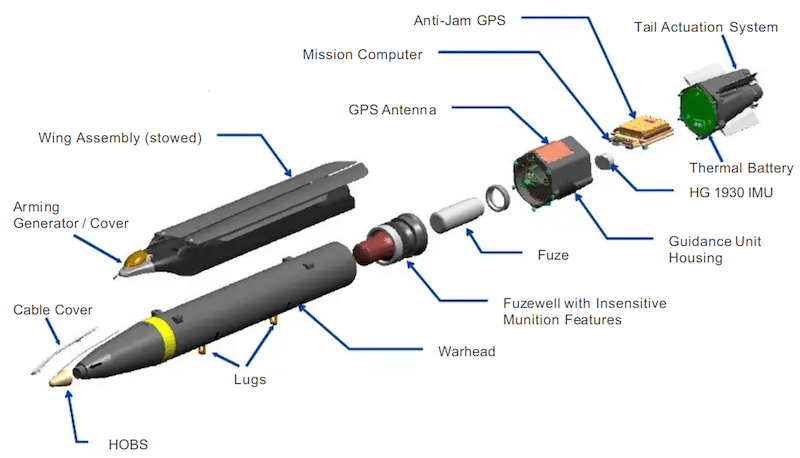











تعليقات الزوار ( 0 )