أثبتت جائحة فيروس كورونا المستجد بما لا يدع مجالا للشك أن العلم لا غنى عنه لكل الدول، كما أثبتت أن للفكر والفن والأدب دورا مهما في فهم ومواجهة هذه الجائحة.
وفي هذا الصدد، أجرت جريدة بناصا، حوارا شاملا مع الدكتور رشيد الإدريسي، أستاذ السيميائيات ومناهج النقد الحديث كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك/جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء، حول دور العلوم الاجتماعية وأهميتها في إيجاد حلول لتدبير الأزمات الوبائية، وعن أدوار المناج والنظريات في العلوم الاجتماعية لمقاربة هذه الظواهر المجتمعية، ومن بينها الأوبئة.
كما تطرق الحوار إلى أدوار النخبة والمثقفين عموما في رسم معالم التعاطي مع المسارات الصحيحة في التعامل مع الأوبئة والجوائح بشكل عام.
إليكم الحوار كاملا مع الدكتور رشيد الإدريسي.
كيف يمكن للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية أن يساعد الدول على إيجاد حلول ناجعة في تدبير الأزمات الوبائية؟
يجب أن نشير في البداية إلى أن هذا الوباء مر بمجموعة مراحل، ففي البدء لم يؤخذ مأخذ الجد من طرف عامة الناس وكذا من طرف بعض النخب، وقد كان الخطاب الغالب في البداية هو خطاب يدعو إلى عدم الخوف وعدم المبالغة في تقدير أخطاره، لكن بمجرد أن بدأت تصل الصور الأولى لآثاره على الصحة وتصل أعداد المصابين والموتى، تغيرت النظرة لهذه الجائحة غير المسبوقة، وبدأت فكرة ضرورة العلم للتغلب عليه تفرض نفسها.
والعلم المقصود هنا هو العلم التجريبي أو ما نسميه بالعلوم الحقة أو الطبيعية وتحديدا علوم الوبائيات، وذلك على اعتبار أن هذا النوع هو الكفيل بأن يمكن البشرية من القضاء على هذا الفيروس الذي غطى الكرة الأرضية في ظرف وجيز جدا ولم يستثن أي بلد، سواء أكان متقدما أم غير متقدم بل لربما الدول المتقدمة كانت هي الأكثر تضررا بسببه.
وللعلوم الإنسانية والاجتماعية هي الأخرى دور هام في هذه الحرب التي تخوضها البشرية ضد هذا الوباء. العلوم بمختلف تخصصاتها، بما في ذلك الفلسفة والأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع والتاريخ وعلم النفس… فكل هذه التخصصات وغيرها يمكنها أن تسهم وتساعد في التغلب على هذا الداء، وإن بشكل غير مباشر. فالتاريخ مثلا يضعنا أمام تجارب عرفتها البشرية في محطات سابقة، وقد لاحظنا كيف أن كتب التاريخ المتعلقة بالأمراض والأوبئة تم تقاسمها بين مرتادي الشبكات الاجتماعية بشكل مكثف بمجرد أن تم تصنيف كورونا باعتباره وباء من طرف منظمة الصحة العالمية. وقيمة التاريخ أنه يخفف من حدة من الرعب الذي تشيعه الأرقام، وذلك بإطلاعنا على ما عرفته البشرية من أوبئة والتي لم تمنع من استمرار الحياة. فالتاريخ بطريقة غير مباشرة ينزع طابع الأسطرة التي تحاول بعض الخطابات إضفاءه على هذه الجائحة، كما أنه يدحض تلك الخطابات القيامية apocalyptique التي تنشر الرعب بين الناس وتلجئهم إلى بعض السلوكيات الوسواسية القهرية التي لا تخضع للعقل والتفكير.
ويمكن قول الشيء ذاته عن علم النفس الذي يمكن أن يساعد في فهم نفسية الإنسان وتجاوز ما أحدثته هذه الجائحة لدى من فقدوا عزيزا أو تعرضوا للعدوى، وهو ما قد يؤدي بهم إلى نوع من الإحساس بالفراغ الوجودي بمستويات مختلفة، حسب قوة شخصية المرء ذات العلاقة بما هو بيولوجي واجتماعي. فعلم النفس له دوره في استكشاف الجوانب التي يمكن أن يكون لها معنى في حياة الأشخاص الذين تعرضوا لصدمة من هذا النوع ومساعدتهم في تجميع هذه الجوانب لتتحول لديهم إلى مصدر من مصادر الإقبال على الحياة والفعالية والحيوية والتوازن، وهذا ما يعتني به اليوم الكثير من العلماء تحت مسمى la résilience، مستندين إلى كم هائل من الاكتشافات في مجال علوم الدماغ، بحيث هدفهم الأول هو كيف يمكن تجاوز الجروح النفسية الناتجة عن الحروب والاضطهادات والأمراض…
وقل مثل ذلك بالنسبة إلى الأنثروبولوجيا التي تضع الظواهر وتحاول فهمها في إطارها الثقافي وكذا الفلسفة التي قد يكون هدفها استشكال الموضوع لا غير (Problématisation) وقد تستهدف الفهم والتغيير، حسب زاوية نظر كل الفيلسوف. فهذه الجائحة إن كان لها أية فضيلة، فهي أنها نبهتنا إلى قيمة العلوم بمختلف أنواعها صلبة أو مرنة، كما نبهتنا إلى مدى سطوة الاهتمامات التافهة والعابرة، وإهمالنا للمؤسسات التي عليها المعول في إنتاج العلماء، وهي المؤسسات التعليمية التي للأسف خللها نسقي راجع لغياب رؤية ولخضوعها للمصالح والجشع. ولذلك يمكنني أن أقول دون مبالغة بأن كورونا نبهتنا إلى قيمة المعرفة ككل والعلم المرتبط بالمختبر تحديدا، لكنه للأسف مسيرة العلم في محيطنا ستظل متعثرة لأن علماء النوابغ والمتميزين سيضطرون للنزوح إلى الدول الأخرى التي توفر لهم المحضن والمؤسسات العلمية التي تليق بمستوياتهم.
جائحة كورونا أظهرت أن للمبادئ الإنسانية كالتعاون والتكافل ولحمة الدول ضرورة لمكافحة الفيروس، كما أظهرت أن للعلوم الإنسانيه دورا في رسم مسار العلوم الدقيقة.
هل يمكن أن نتوقع بعد نهاية أزمة كورونا أن تحظى العلوم الإنسانية والفنون بأهمية؟
لا يدرك قيمة العلوم الإنسانية إلا من تشبع بها، ونحن نعلم أن هناك رغبة في تقليص حيز وجودها في الجامعات وتغليب “ما يطلبه السوق”، مع العلم أن الاهتمام بالتكوينات التي تتوافق مع سوق العمل لا تقصي بالضرورة التكوين الموازي في مجال العلوم الإنسانية، التي هي قبل أن تكون معلومات ومعطيات نظرية، هي أفكار تعمق فهمنا لذواتنا وفهمنا للآخرين وللعالم الذي يحيط بنا، كما تؤهلنا لاتخاذ قرارات متوازنة في مجالات قد تكون لها علاقة بالاقتصاد والسياسة وكذا بحياتنا الخاصة… فالعلوم الإنسانية يجب النظر إليها في ارتباطها بالمجالات التي قد تظهر للوهلة الأولى بعيدة عنها، يجب النظر إليها من زاوية مركبة دائمة الاستحضار للجزء والكل في تعاطيها مع الظواهر والتصورات، يجب النظر إليها بوصفها إغناء لفكرنا وترشيدا لقراراتنا.
إن كورونا بقدر ما كشفت عن ضرورة التعاون والتكافل، كشفت عن الأنانية المتأصلة في الكائن البشري، وعن ضرورة تصالح الإنسان مع القيم الإنسانية التي هي الشيء الذي يشترك فيه البشر جميعا والذي لا يختلف من مجتمع إلى آخر. لاحظنا كيف كان البعض يعترض مساعدات دون وجه حق ويغير اتجاهها لصالحه، ولحسن الحظ أن الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة فضحت هذه السلوكيات فأوقفتها، وإلا لأصبحنا إزاء قرصنة من نوع جديد. مثل هذه الشدائد تكشف عن المعدن الحقيقي لهذا الشخص أو ذاك وتميز من لديه المبادئ عبارة عن قشرة رقيقة بمجرد تعرضها لأول اختبار تتطاير كصباغة رديئة، ومن ترسخت لديه فأصبحت جزأ من هويته، ولذلك يجب عدم الحلم وانتظار تغيير الإنسان بعد كورونا بحيث نجد أنفسنا إزاء نموذج إنساني جديد.
فيما يتعلق بالفنون وسؤال إن كانت ستحظى بأهمية بعد نهاية كورونا، أشير إلى أنه في مجال الإبداع، سواء أكان أدبيا أم فنيا، نحن إزاء سيرورة، بمعنى أن الإبداع لا نتحدث عنه بشكل رياضي حدي، فهو يمتد في التاريخ ويتطلب مسافة زمنية لكي يتعرض لما يسميه دارسو الأدب بالإغراب (Estrangement) وهذا لا ينفي أن الأحداث الكبرى التي قد تأتي بشكل فجائي أو متدرج قد يظهر أثرها واضحا على الفنون والآداب، وقد تكون الأحداث سياسية كما قد تكون ذات علاقة بالاقتصاد أو بالأوبئة أو بسيادة تصورات بعينها ودعمها من طرف سلطة … وربما لهذا السبب عمل النقاد على تحقيب الأدب سياسيا، وذلك لوعيهم بمدى ما تحدثه السياسة في الأدب من تغيير، وهذا ما نلاحظه حتى قبل تدشيننا لما بعد كورونا، نحن ما زلنا في صراع مع الوباء، ومع ذلك هناك حديث عن أدب قصصي وروائي وفني يتخذ كورونا موضوعا له، ساعد على ذلك الحجر الصحي ورموز كورونا (الكمامة، النظافة، البيئة، الحظر، الرعب، العدوى، الخفاش، الفيروس، الموت، الصين…) أو ما يمكن تسميته بمُتَخَيَّل كوفيد 19 أو كورونا.
كيف يمكن لآراء ونظريات العلماء والفلاسفة والمفكرين أن توجهنا نحو المسار الصحيح في التعاطي مع هذه الجائحة؟
يجب الإشارة أولا إلى أن هذه الجائحة كانت مناسبة لتجديد التفكير في الكثير من القضايا، وأنها أعادت ترتيب الأولويات لدى العديد من المفكرين، وكانت فرصة لإعادة طرح أفكارهم التي سبق لهم أن عرضوها في سياقات غير هذا السياق، وهو ما فرض عليهم تجديد النظر فيها. ومعنى هذا أن الفكر دائم التجدد، أو هذا ما يفترض أن يكون عليه الوضع. فالفكر إن كان فاعلا في الواقع فكذلك الواقع يفعل فعله في المفكر والفيلسوف. ولذلك فإنه قبل استحضارنا لآراء الفلاسفة يجب أن نستحضر معطى منهجيا أساسيا، وهو أننا إزاء أفكار أصحابها ترهنهم الشروط الموضوعية التي ينطلقون منها، والهدف هو تنسيب كل ما يتم استحضاره من رؤى وتصورات وترك الباب مفتوحا لإغنائها وتهذيبها وتشذيبها والتخلي عنها إن دعت الضرورة لذلك، والهدف هو استئناف قول جديد له علاقة بواقع جديد وبمعطيات علمية جديدة قد تفرض تغيير نظرتنا للإنسان والمجتمع والعالم. إن آراء الفلاسفة مهمة لأنها كما قلنا تستشكل المواضيع وتتجاوز الطرح السطحي الذي يفرضه التناول السريع الذي هو من طبيعة الكثير من الوسائط، مع الوعي بأننا إزاء ما هو نسبي دون الوقوع في النسبية المتطرفة التي تجعل التواصل حول أي موضوع مستحيلا.
ما الرهان الموكول للنخب المثقفة تحقيقه والدعوة إليه أو هل سيعيد المثقف والمفكر صياغة معالم حضارة جديدة وما يتفرع عنها بعد جائحة كورونا؟
الحديث عن صياغة معالم حضارة جديدة أو حضارة ما بعدية، مسألة طرحت في محطات مختلفة وبتسميات مختلفة. هناك من يتحدث عن الحضارة وهناك من يتحدث عن تعاقد جديد ومن يتحدث عن إصلاح الفكر والإنسان… وغالبا ما تطرح هذه الاقتراحات بعد تأزم أوضاع العالم أو تأزم أوضاع رقعة من هذا العالم. فيما يتعلق بالحضارة، نعلم أن هذا المصطلح اختفى لمدة طويلة من الدراسات الأكاديمية لأنه ارتبط في فترة من الفترات بالاستعمار الغربي، لكون هذا الاستعمار كان يحاول كسب الشرعية من خلال الحديث عن نقل الحضارة للشعوب المتخلفة أو ما كان يسميه منظرو الاستعمار بـ La mission civilisatrice)) المهمة الحضارية للكولونيالية. وقد عاد هذا المصطلح بعد انهيار المعسكر الشرقي لأن الحضارة، وهي بمعنى من المعاني مرادفة للفظة الثقافة، “أقصت” الاقتصاد بوصفه استبدالا لتحليل الواقع وأخذت مكانه، خاصة مع صامويل هونتينتون الذي يمثل الاستعمال السلبي لهذا المفهوم.
وصياغة معالم هذه الحضارة الجديدة تطرح بحدة في الوقت الراهن مع كورونا وإن كانت سابقة عليه، حيث يتحدث بعض الفلاسفة، وعلى رأسهم إدگار موران، عن التطور الذي يهدد أسس الحضارة في الزمن الحاضر، وذلك بسبب تغليب الكم على الكيف والفردانية المفرطة وتغول الدولة وعدم الاعتناء بالبيئة وتحويل كل الأشياء إلى سلع وتأزيم علاقة الفرد بذاته وأسرته ومجتمعه، وكذا تحويل التقنية إلى أداة ضارة من نتائجها استنزاف الطاقات الطبيعية واستعباد الإنسان، مع العلم أن التقنية ليست ضارة بطبيعتها كما تذهب إلى ذلك بعض التيارات المحافظة واللاعقلانية، بل يمكن لها أن تكون آداة للتحرر، بشرط أن تكون مصحوبة بتغيير اجتماعي.
فهذا التوصيف السابق عل تجربة كورونا يتأكد اليوم أكثر ويجعلنا في حاجة إلى اعتماد خطة مقاومة أو ما سماه موران بسياسة للحضارة وما سماه آخرون تسميات مختلفة، وهو ما يتجسد في تشجيع الحرية والتضامن والإخاء وتحسين مستوى العيش بالمعنى الوجودي وليس فقط بالمعنى المادي، وإيلاء العلم ما يستحقه من مكانة، وهذا بالضبط ما كشف عنه وباء كورونا، وذلك لأنه بدون علم سيحكم على البشرية بالتخلف. وهنا يجب التمييز بين العلم الذي يجيب عن سؤال “كيف” والذي غَّير وضع البشرية للأحسن، والنزعة العلموية ( (Scientisme المغالية التي تعتبر العلم بديلا عن كل شيء، فتعيد ارتكاب خطأ الإديولوجيات الإطلاقية.
“طبيعة الفيروس” طرحت العديد من التساؤلات والتصورات بين من يقول إنه ليس طبيعيا ومن يقول إنه من صنع الإنسان. ويوما بعد يوم الإنسانية تنتظر والعلماء يبحثون عن علاج فعال ضد الفيروس. ما تعليقكم بهذا الشأن؟
هذا السؤال يطرح قضية المؤامرة، وقد سبق لي أن تناولت هذه المسألة فأوضحت أن فجائية هذا الحدث وخطورته وتغطيته للعالم بأسره، يجعل الذهن يميل إلى أن الأمر ظهر بفعل فاعل، وأن هناك من يقف وراء هذا الفيروس، ومن مصلحته أن ينتشر بهذا الشكل.
وليس من المستبعد إمكانية أن يكون هذا الفيروس قد تعرض للتمعدل والتركيب، ولا يستبعد أن يكون قد تسرب من مختبر نتيجة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وهذا ما ردده بعض العلماء. لكن احتمال أن يكون طبيعيا وارد هو الآخر، وقد سبق للكثير من الباحثين أن تحدثوا عن تحدي الفيروسات التي تهدد البشرية، والتي تنتقل من الحيوانات ذات المناعة العالية إلى الإنسان الذي لا قبل له بها.
الانشغال بمن يقف خلف ما نعيشه مع هذا الكائن الدقيق قد لا يجدي نفعا إلا بالنسبة إلى الدول المتقدمة التي ترغب في تغريم الدولة التي كانت سببا في انتشاره، والمقصود بذلك الولايات المتحدة الأمريكية الدولة المُتَهِمة في علاقة بالصين الدولة المُتَهَمة. والحقيقة أنه يصعب الذهاب إلى أن ذلك كان مقصودا ومخططا له، على اعتبار أن من أكبر الدول تضررا الصين التي هي مصنع العالم والتي تعرضت صناعتها وتجارتها لأضرار كبيرة.
من يخطط ويقصد الإضرار بالعالم لتحقيق أهداف كيفما كان نوعها، عليه أن يضمن حماية نفسه أولا، أو على الأقل جعل خسائره في مستوى أدنى ومتحكم فيها بهدف إبعاد الشبهة عنه. يبقى التوجه إلى الأسباب الموضوعية والبحث فيها هو السبيل الأنفع للبشرية وللعلم، إذ ظهور هذا النوع من الأوبئة ليس بالشيء الجديد، وللعلماء معرفة سابقة بما يشبهه، ولمن يريد أن يأخذ فكرة من كاتب عارف بهذا المجال عليه بالرجوع إلى كتاب “الفيض: أمراض الحيوانات المعدية وجائحة الوباء التالية بين البشر” لديفيد كوامن David Quammen، وقد صدر باللغة الإنجليزية سنة 2012 وفي ترجمته العربيىة سنة 2014، ففيه يوضح بأسلوب سهل كيف تنتقل الجراثيم المرضية من الحيوانات المضيفة لها لتصل إلى الإنسان وتصيبه بالأمراض المعدية غير مسبوقة.
في نظركم الأستاذ رشيد، كيف يمكن أن تؤثر هذه الجائحة على السلوك الاجتماعي للإنسان المغربي لغويا ونفسيا ما بعد الجائحة؟
البعدان النفسي واللغوي هما من بين الأبعاد الأساسية التي تكشف عن مدى تأثير هذه التجربة في الإنسان، فالمرض مس صحة الإنسان وانتقل ليطال ما هو اقتصادي واجتماعي وسياسي، بل مس ما هو حميمي في الإنسان وهو الجانب النفسي، وذلك على اعتبار أن الحجر الصحي الذي خضع له كل المجتمع، كانت له عواقب على نفسية البعض إن سلبا أو إيجابا.
فهناك من شكل لديه الحجر ضيقا وهناك من شكل لديه نوعا من القرب والدفء الأسري، نقول ذلك دون الوقوع في التعميم، ففضاء المنزل سعة وضيقا وموقعا… له دوره في ترجمة الإحساس، بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة وأعمارهم ونوع عمل الأب ومستواه الاجتماعي، واستحضار إن كانت الأم تعمل أم لا، وغير ذلك من العناصر الأخرى التي بدون أخذها بعين الاعتبار تكون نتائج التحليل مجرد رأي غير قائم على أبحاث وبالتالي مؤهل ليوقع في الخطأ. وتحليل آثار كورونا نفسيا يجب ألا يوقعنا في التفاؤل المفرط الذي يتبناه البعض في تحليلاتهم والذين يتحدثون عن إنسان ما بعد كورونا وعن التغيير الإيجابي الذي قد يلحقه نتيجة إدراكه لهشاشة الحياة وقيمة التكافل والتآزر…، فالإنسان قبل كل ذلك هو كومة من الغرائز وهو برنامج جيني قابل للتعديل وهو كذلك رواية عائلية، أي أنه سلسل أسرة وبيئة تسمه بالكثير من الطباع التي يصعب عليه التخلص منها.
فيما يتعلق باللغة من المؤكد أنها هي الأخرى تأثرت بما نعيشه، وتأثرها يبرز واضحا إذا ما علمنا أن مكتب تنسيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قد أصدر مؤخرا، ونحن ما زلنا لم ننتقل إلى ما بعد كورونا، معجما يحمل عنوان “معجم مصطلحات كوفيد 19»، وهو معجم ثلاثي اللغة عربي إنجليزي وفرنسي.
وهذا وحده يثبت أن اللغة العربية قادرة على مواكبة المستجدات وعلى توليد الألفاظ للمعاني الجديدة، وأنها لغة حية وقوية، إذ عندما تتوفر لها الشروط وتتم إزالة العقبات من طريقها ويُفك عنها الحصار…، يصبح بإمكانها الابتكار وتقديم مقابلات لكل المصطلحات المستعملة في اللغات الأخرى ترجمة وتعريبا، وهذا درس من تجربة كورونا، يخرس بعض من يناصبون اللغة العربية العداء بنوع من الهياج والسعار.
هذا المعطى يدخل في إطار ما يسمى بتخطيط المتن اللغوي الذي هو جزء من السياسة اللغوية، وهناك بعد آخر يمكن ان نسميه بالبعد الدلالي السيميائي. فتجربة كورونا أحدثت نوعا من الخلخلة في العلامات اللغوية، فعدلت في تراتبية دلالاتها، إذ اليوم بالإضافة إلى اغتناء لغة تداولنا الإعلامي واليومي بألفاظ من قبيل: التباعد، الحجر الصحي، الجائحة، الوباء، التعقيم، البؤرة، القناع، الكمامة، الحضانة، المُخَالِط … وهي ألفاظ كان يندر أن تستعمل حتى من طرف الأكاديميين، فبعد هذه التجربة، هي الآن تستعمل من طرف عامة الناس، وعندما تُستعمل فإنه، إن أردنا التعبير سيميائيا، يتم تعقيم الكثير من دلالاتها ولا يُنَشَّط منها إلا ما كان له علاقة بهذا الوباء، وهذا مرة أخرى يكشف أن اللغة العربية تحيا بالاستعمال ويتم إخراج ألفاظها من المعاجم إلى الحياة عندما تكون هناك حاجة لذلك، لهذا السبب يجب أن نخلق الحاجة دائما لإدخال اللغة العربية في حياتنا وفي معيشنا حتى لا نترك الفرصة للغات الأخرى المنافسة والمفترسة لتأخذ مكان الألفاظ العربية وتبقيها سجينة المعاجم.


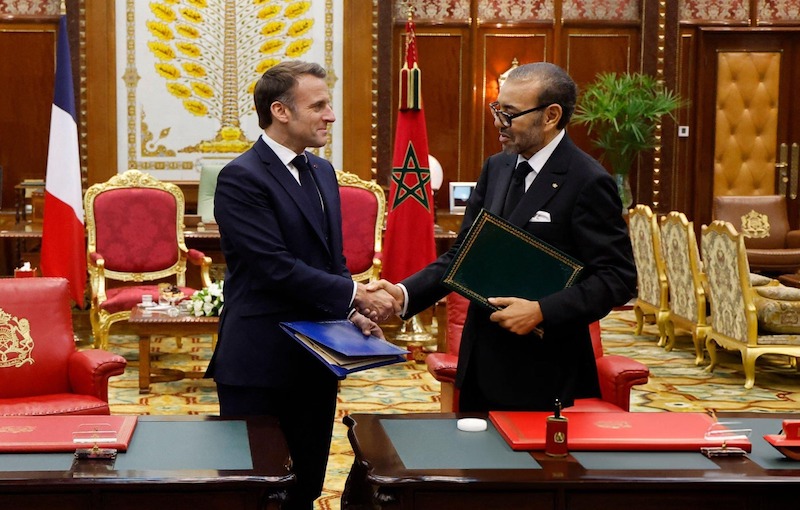












تعليقات الزوار ( 0 )