دراسة طبيعة مبادئ وقيم الدولة وانعكاساتها على الافراد والجماعات وعلى السياسات العامة والعمومية والقطاعية، يدفعنا الى التفكير في طرح السؤال كيف السبيل الى مفاتيح أبواب الغيث وتجاوز وسائل الامتصاص المختلفة الحالية للمبادئ وللقيم لما بعد جائحة كورونا؟ هل لدينا من النخب والكفاءات الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية، المؤهلة تاريخيا وتكوينا وفكريا وايديولوجيا لمواجهة التحديات المستقبلية؟
الوضع المستقبلي للعالم يجعل ويبقى العقل البشري والمواطنات والمواطنين دائما في موضع ريبة وشك وحيرة من أمرهم، يصعب على الفرد توجيهه بشكل سليم خاصة؛ إذا فكر في الانفراد بأفكاره بمعزل عن المجتمع. فهل الاقتصاد الوطني يتضمن من المرونة ما يجعله قارا على التنافسية والتعافي بعد هذا الوضع المتأزم؟
في حديث الرسول ﷺ: “يولد المولود على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”. لكن لماذا لم يذكر الرسول ﷺ الإسلام في هذا الحديث؟ انه يولد عبارة عن صفحة بيضاء أي فطرة الاسلام؛ حيث المحيط والمجتمع هما من يعملان ويساهمان في تأطيره ثقافيا واجتماعيا وايديولوجيا وفكريا؛ سواء بشكل إيجابي أو سلبي؛ بحكم انه من طبع الإنسان نزعة البحت عن التميز وحب الذات.
وبالتالي فالدولة هي المتحكمة في طبيعة الشك واليقين داخل مجتمعاتها التي تؤثر فيها من خلال درجة الانفتاح والانغلاق داخل المجتمع. لنأخذ على سبيل المثال الصين او كوريا الشمالية؛ فقيمها جد منغلقة على نفسها داخل الدولة؛ بحيث لا تسمح لأية دولة أجنبية أخرى او منظمة حقوقية؛ بتسييرها أو التأثير فيها وفي مجتمعها بأي شكل من الأشكال، وفي المقابل نعقد المقارنة مثلا ببلد عربي، نجد أن منظومة القيم لديه ذات بعد معقد لا يمكن القول بالتحديد؛ هل هو بلد إسلامي أو غربي؛ إد أن القيم تختلف وتتصارع داخل المجتمع الواحد.
فمن خلال هذه الأمثلة نخلص إلى أن الدولة هي المسؤولة الوحيدة عن ترسيخ القيم في المجتمعات المتطورة وهي من تعمل على حماية وتطوير قيمها وأبرزها الشعب الصيني الذي اعتمد على سد كل الثغرات التي قد تؤثر في قيم المجتمع من خلال فكرة السيطرة المجهولة اجتماعيا او على الاقل يستفاد منها ذلك من خلال الخبز والتعليم.
كيف تؤثر تركيبة المجتمع في طبيعة الدولة؟ هل طبيعة الدولة تسمح بالفعل بلعب دور الشريك ام دور التابع؟
هناك بعض الشعوب التي آمنت بالقيم كأسلوب حياة؛ قد تحسن استعمال المبادئ والقيم؛ لكن لن يكون بارزة داخل المجتمع بشكل موثر؛ حيث المجتمع تحكمه أساليب تقليدية. هذه الاساليب التقليدية قد يتحول بموجبها إلى قطيع أو ضحية لمبدأ امتصاص القيم. بالإضافة إلى أن المؤسسات ووسائل التواصل الاجتماعي كلما ازدادت تطورا؛ كلما ازداد تقييد حرية الفرد داخل المجتمع مما سيجعل الإنسان مجرد بنيات مكشوفة للعدو أو للآخر. وهذا ما قد يشكل فخا له ليصبح فريسة سهلة لآلية امتصاص القيم المختلفة.
ونضرب مثلا بالمدرسة كوسيلة لامتصاص القيم وتوجيه التنشئة؛ سنجد أن المجتمع الأمريكي أصبح يشهد صراعا للقيم والانتماءات بين أفراد مجتمعه داخل المدرسة، وبالتالي انقلب دور المدرسة كوسيلة لامتصاص القيم الإنسانية وتم استبدالها بوسيلة لتكريس العنصرية العرقية. وهذا مع الاسف ما تسعى اليه أيادي خفية لتطبيقه على المجتمع المغربي. وكذلك عندما نأخذ الفن كوسيلة لامتصاص القيم؛ لأن الفن بكل أنواعه يعتبر شكلا من أشكال تطبيق نظرية الهندسة الاجتماعية. فمثلا هناك أغاني وأفلام ومسلسلات؛ بالنظر لطبيعة محتوياتها؛ ووفقا لقانون الاحتمالات؛ قد تفسد قيم وتشتت أفكار الأجيال الصاعدة. وأخطر من دالك قد تعمل على نفي حتى الهوية الوطنية والمواطنة بأساليب مخادعة ومكرة. بل قد تخلق لنا مرضى نفسانيين في المستقبل؛ لأن العقل البشري قد يخضع لعمليات تأثير وتأثر متبادل.
هذا ولكي تتضح لنا الصورة أكثر في أسلوب توجيه وتأطير الدولة للأجيال التي ستتولى قيادتها إلى التطور؛ بحيث أن كل خلل أو غلط أو غفلة، قد يؤدي بها إلى عدم مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل العالم. لتصبح الدولة بذألك ضحية مجتمعاتها.
وبالتالي يرجع السبب إلى سوء تسير الأجيال السابقة للدولة فتنعكس بسلبياته على الأجيال اللاحقة وغالبا ما يرجع هذا إلى عملية خارجة عن إرادة وأراضي الدولة من خلال محاولة إفساد مؤسساتها ومسيريها من طرف أيادي خفية وخارجية ألا وهي العولمة. وهذا ما يجعلنا نعتبر أن الفكر الإنساني داخل مجتمع معين ينطبق على منهج الدولة في تسيير شؤنها.
تطور علاقة الدولة بالمحلي وتنامي دور الجهوي؛ اديا الى تراجع دور الدولة في العديد من مجالات التدخل؛ بل اصبح يطرح التساؤل حول مفهوم السيادة والدور الذي ستلعبه الدولة في ظل تنامي دور هذا المحلي والجهوي والاقليمي.
فما هو الدور الذي اصبحت تلعبه الدولة من خلال ممثليها؟ وما هي انعكاسات طبيعة الدولة على السياسات العامة والعمومية؟ حينما نتحدث عن المركزي لابد من استحضار المحيط أو الجهوي والاقليمي والمحلي. فماذا نقصد بهذا الجهوي والاقليمي والمحلي اذن في ارتباطه بالدولة او المركزي؟ وكيف تطورت علاقة الدولة بالمحلي وبالجهود والاقليمي؟ وكيف تنعكس طبيعة تركيبة نظام الدولة على السياسات العمومية الترابية؟
لتفكيك هذا الاشكال لابد من استحضار النقاش الذي كان محور جلسات مجلس المستشارين في الستينيات، حيث كانت تسود نوع من الشجاعة والجرأة في تناول القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ والذي كان يصب في اتجاه أن يتم إقرار ديمقراطية تقوم على التدبير المحلي لشؤون السكان بأنفسهم، من خلال تقسيم ترابي يتم تعريفه وتحديده وتنميطه من منطلق أن كل دوار أو مدشر أو حي يجب أن يكون موضوع جماعة ترابية، تضم مجموعة من السكان لهم حدود معروفة ومضبوطة، و لهم خصوصيات ومميزات، وقيم اجتماعية وعادات وتقاليد وأعراف وأمجاد، أفرزتها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، تميزهم عن الآخرين، ينتخبون فئة من الناس يشكلون مجلسا جهويا واقليميا ومحليا يتولى نيابة عنهم تدبير شؤونهم ومتطلباتهم وقضاياهم وتحقيق وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في حدود المتاح من الموارد وفي تناغم مع السياسة العامة للدولة.
لكن هذا التصور الذي طالبت به أحزاب المعارضة آنذاك لم يتم العمل به، حيث جاء التقطيع الإداري ليفرز وحدات إدارية لا علاقة لها بالخصوصيات الطبيعة والبشرية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، ولا يراعي التقاليد والعادات والأعراف لهذه الجماعة أو تلك؛ وبالتالي تم تطبيق وإقرار قانون موحد وهياكل إدارية تسير حسب متوالية هندسية تراعي المراهنة على مصالح الأعيان، كمصدر لاستمرار مشروعية الدولة من خلال إقرار وسيلة وجود تقليدية متجاوزة تفرز خريطة سياسية تقليدية غير قابلة للانفتاح ولا الاستنبات ولا التوطين للديمقراطية والتدبير الحر. حيث سيطرة الجهلة دوي المال والجاه والنفوذ وإقصاء الشباب المثقف وتهميشه وإبعاده من تدبير الشأن العام.
وبالتالي فمفهوم الجهوي والاقليمي والمحلي؛ هو ما تمليه السلطة المركزية من فوق وما تصبغه به؛ أي صياغة عمودية وليس صياغة أفقية.
إن تواجد الدولة لتغطية جميع القطاعات، اقتصادية كانت أو اجتماعية، فرض عليها لزاما بعد عهد الاستعمار مباشرة تطوير الفرد والمجتمع وكذا ضبطه ومحاولة القضاء على التنافر؛ من خلال العمل على ربط علاقة تستهدف خدمته ونماءه بالأساس.
ومن خصوصيات المجتمعات الأكثر تخلفا، طبيعة التركيبة الاجتماعية المتنافرة. والمغرب لا يخرج عن هذه الخصوصية، إلا أنه مع ذلك يتميز بنوع من التعايش التنازعي. فهل استطاعت الدولة تجاوز إيقاف الصيرورة التاريخية عند حدود مؤسسة تقليدية ألا وهي القبيلة؟ بمعنى آخر ألم يحن الوقت لتجاوز تقوية وسيلة وجود متجاوزة تختزل في القبيلة والغنيمة؟ أم أنها بالعكس من ذلك تعمل على تنميتها كآلية أخرى لضبط “النسق” الاجتماعي والسياسي وحتى الثقافي؟ فالدولة بصفة عامة تعاني من قضايا وأزمات في سعيها لتطوير وتغيير افراد مجتمعاتها. ومظاهر هذه الأزمات يمكن اختزالها في بعض العناصر الأولية كما يلي:
أولا أزمة هوية: بحيث من خلال قراءة بسيطة وسريعة في الثقافة الشفوية الشعبية نجد سيادة مفاهيم تحيل إلى التنافر والتباعد والتشرذم؛ ونضرب مثلا هذه المفاهيم القدحية: العروبي نسبة للعروبية، الشلح، نسبة للشلوح الضراوي، نسبة إلى وادي درعه، الريفي نسبة لمنطقة الريف في الشمال، الدكالي نسبة لدكالة، الصحراوي نسبة للصحراء… الى غير ذلك من التنضيدات الاجتماعية المتنافرة.
ثانيا أزمة مشروعيات: وتتجلى في صعوبة، بل غياب الحوار بين الدولة ومكونات فئات المجتمع؛ والأخطر من ذلك منع وعدم القدرة على إنتاج مجتمع مدني أو حتى تركه يستمر إن كانت هناك إرهاصات لوجوده، مما يفضي إلى التساؤل عن شكل الدولة الوطنية التي نريد؟ هل الدولة الجهوية؟ أم الدولة – القبيلة؟
ثالثا أزمة مشاركة: أي غياب مشاركة جميع الفاعلين وفئات المجتمع وسيادة سياسة الإقصاء والتهميش والابعاد والتجاهل والنسيان في عملية صنع السياسات العامة والعمومية واتخاذ القرار.
رابعا أزمة توزيع: نلاحظ ان هناك سوء توزيع للساكنة على المستوى المجالي أو الترابي؛ حيث حدة التركيز للساكنة النشيطة بالمناطق الصناعية؛ من خلال الشريط الساحلي الممتد من مدينة القنيطرة حتى مدينة اكادير؛ مما يؤدي إلى تفاقم الهجرة من البوادي والقرى نحو المدن وما يترتب على ذلك من نتائج كأحزمة دور الصفيح والانحراف بشتى صوره والارتزاق وتجارة الدراويش (الباعة المتجولين، حرف بسيطة ،ماسحي الاحدية وغيرها…)؛ واختلال في جدلية الاعتماد المتبادل في معادلة القرية والمدينة. ومن نتائج هذه الأزمات أن أدت إلى تعقيد الفهم في وضعية المجتمع التنضيدي وتركيبته الاجتماعية. والمجتمع التنضيدي او التركيبي او التمازجي او التنافري هي مقولة بلورها كل من “بول باسكون” ونجيب بودر بالة في بحثهما عن مصادر إنتاج القاعدة القانونية في المغرب وفي اطار بحث سوسيولوجي مشترك في طبيعة تركيبة المجتمعات، حيث استنتجا وجود فسيفساء وتراتبية اجتماعية تطبع المجتمع المغربي. بحيث على الرغم من وجود منطق داخلي يوحد هذه التراتبية؛ إلا أنه في كثير من الأحيان يظهر على السطح التنافر السياسي والاجتماعي، خاصة بمناسبة الانتخابات، حيث بينت الدراسات حول سوسيولوجيا الانتخابات بالمغرب، التعايش التنازعي وذوبان الفرد داخل الجماعة – القبيلة، وما يصاحب ذلك من نزاع بمناسبة الحملات الانتخابية وتأثير البنى الثقافية والدينية والاجتماعية. مما أفضى إلى أزمة في مفهومي الدولة والسيادة.
مبدأ السيادة المتضمن بالدساتير من خلا التنصيص على ان السيادة للشعب يمارسها من خلال مؤسسات تمثيلية تنبثق عن الانتخاب والاستفتاء؛ يفتح المجال للغموض في ارتباطه بمفهوم الدولة. نحن لن ندخل في الجدال والنظريات الفقهية لروسو وديفيرجي وغيرهما… التي تناولت السيادة الوطنية كما درسنا في سنوات الاجازة بكليات الحقوق؛ ولكن سنخضع المفهوم لتحليل آخر لارتباط مفهوم الدولة والسيادة بالتدبير الجهوي والاقليمي والمحلي؛ لمعرفة العلاقة بين المركزي والمحيط في ظل تنامي دور هذا الأخير.
لقد بدأ الجدل الفكري حول نهاية “مقاولة” الدولة بمناسبة محاضرة ألقاها العام 1989(فرنسيس فوكوياما) بجامعة شيكاغو تحت عنوان: “نهاية التاريخ” والتي تناقلتها وسائل الإعلام من مجلات وجرائد، حين دافع عن نظرية الدولة الليبرالية التي اعتبرها الحد الأقصى الذي بلغ اوجه والسوق للجميع.
فهل يمكن الحديث عن نهاية التأمين الاجتماعي؟ أي التخلي لفائدة الجهوي والاقليمي والمحلي لتدبير شؤونه بنفسه دون تدخل من الدولة؟ هل مختلف جوانب التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإداري وغيرها؛ تحيل إلى نهاية “مقاولة” الدولة، أم أن لا يزال هناك حتمية الدولة؟
فالحرب لم تعد بالسلاح؛ بل أصبح الامر يتطلب التحكم بهندسة الفكر لخدمة سلاح التبعية بكل أنواعها. فهناك عدة نماذج في تأمين الحياة الفردية والجماعية؛ كالنموذج الأوروبي، النموذج الأسيوي، النموذج الأمريكي، النموذج الإسلامي، وحتى النموذج الدكتاتوري… إلى غير ذلك من النماذج المتبعة. وقد احتد الصراع على أشده بين النموذج الرأسمالي والنموذج الاشتراكي، الذي انتهى بتلاشي هذا الأخير، وربما يأتي مقال فوكوياما تتويجا أو إعلانا لهذا التفوق أو التلاشي، وإقرار امتياز النمط الديمقراطي الليبرالي الأمريكي والحد الأقصى وقوانين السوق، وبالتالي فصل مجال السياسة عن مجال الاقتصاد.
لكن هل يمكن الحديث عن نهاية الدولة كآخر مقاولة وتطلع وأفق وصل إليه الإنسان؟ ان أزمة الدولة في أوربا الغربية والشرقية، تجلت في تفكك الدول، السوفيتية، واليوغسلافية والتشيكوسلوفاكية، مما أدى بالعديد من الباحثين إلى التساؤل حول حتمية الدولة من عدمها، أو اعتبار المرحلة مجرد انتقال إلى اللا- دولة، أي مدى غياب أو حضور الدولة بحكم تنامي السياسات العمومية المحلية والجهوية، في ظل العولمة.
فقوانين السوق وإدارة الاقتصاد وتنامي وسائط التواصل الاجتماعي؛ جعلت من العالم ككل مجرد قرية صغيرة جدا؛ بينما المجال السياسي والاجتماعي والثقافي أصبح ينحصر في الدولة، سواء كانت متجانسة أو غير متجانسة. لذا أصبحت الدولة تفتقد لفعاليتها، بحيث فقدت الانسجام الذي كان بين مجال إدارة الاقتصاد وإدارة الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. وهنا كانت تجد شرعيتها، أي من خلال عملية التنسيق الذي تتولاه. إلا أنها فقدت هذا التواؤم بين هذين العنصرين.
فقد حصل تناقض كبير، حيث أن الدولة التي قامت سابقا على أسس ونظم بورجوازية وطنية، قد أنجزت فعلا اقتصادا برجوازيا رأسماليا متمركزا على الذات. لكن هذه النظم الإنتاجية الوطنية والجهوية والاقليمية والمحلية؛ قد تفككت في الوقت الحالي وأعيد تركيبها في إطار منظومة إنتاجية معولمة، مما أدى إلى أزمة في مفهوم الدولة وذلك ما نلاحظه في بعض الدول الأوربية؛ بحيث سواء تعلق الأمر باليمين أو باليسار؛ لا يستطيع اتخاذ أي قرار لا يتماشى ومنطق قوانين السوق الأوربية المشتركة، بينما الوعي السياسي والثقافي والاجتماعي، لا يسمح بإقامة دولة أوربية موحدة وفرض إدارة سياسية موحدة بشكل أو بآخر، وبالتالي لا تزال مستقلة بعضها عن بعض على المستوى السياسي؛ بينما على المستوى الاقتصادي تمثل أجزاء من منظومة اقتصادية أوربية مندمجة.
فقد شاهدنا كيف بنائب رئيس مجلس النواب الإيطالي؛ يزيل العلم الأوروبي لسبب عدم مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيطاليا في محنة جائحة كورونا. وكيف انسحبت بريطانيا. وكيف ادرجت اسبانيا نقطة بجدول أعمال دراسة ما بعد كورونا؛ تتعلق بالموقف من الاتحاد الاوروبي او موقع اسبانيا داخل الاتحاد.
وهذا ما يفسر على أنه ليس هناك نمط وحيد للديمقراطية، بل هناك أنماط عديدة من الديمقراطيات الغربية.
فالغرب صحيح يتمتع بديمقراطية سياسية؛ احترام حقيقي لحقوق الإنسان وحتى الحيوانات وممارسة ديمقراطية في المجال السياسي، وتعددية حزبية، وحرية الرأي، وحرية التعبير، وانتخابات غير مزورة على الأقل، وكذا الحرية في الاختيار وإرادة غير معيبة عن طريق شراء الأصوات… إلى غير ذلك.
فهل ينطبق الأمر على المغرب؛ بحيث سواء تعلق الأمر بحكومة التكنوقراط أو الكتلة أو الوسط أو الوفاق أو حتى في إطار الائتلاف، يكون ليس بالإمكان اتخاذ أي قرار يهم الحياة الاقتصادية خارج إطار قوانين السوق والمؤسسات المالية الدولية والبنكية، حيث سياسة التقويم الهيكلي، وفي انتظار الشراكة مع المجموعة الأوروبية، في حين يبقى اتخاذ القرارات التي تهم الحياة السياسية والاجتماعية من اختصاص المجالس تتمتع فيه بالحرية الكاملة؟
هل يمكن التمييز بين قرارات تهم الحياة السياسية والاجتماعية وأخرى تهم الحياة الاقتصادية؟
من خلال استنتاجات اولية، يمكن القول أن هناك تلازما وتداخلا وجدلية اعتماد متبادل بين القرار السياسي والاجتماعي والقرار الاقتصادي؛ كيف ذلك؟ لنأخذ على سبيل المثال، خيار الخوصصة الذي اتبعه المغرب. فهو قرار سياسي، حيث يحيل إلى تخلي الدولة عن تغطية بعض المجالات والتواجد في كل شيء كما هو في السابق، وفتح المجال للمبادرة الفردية، وبالتالي نهاية إيديولوجية الصالح العام. كما أنه قرار اجتماعي، بحيث نهاية وسيلة قانونية كانت تسمح بالوصول إلى المرفق العام، وهي المجانية وحماية الدولة الاجتماعية من خلال توظيف العائدات الضريبية في مجالات اجتماعية أخرى، والاكتفاء بدور المنسق في هذا الاتجاه. وهو أيضا قرار اقتصادي من خلال التأثير على السياسة المالية والنقدية وتعبئة المتاح من والمزيد من الموارد.
المغرب ومن خلال مصادقته على اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة، ومن خلال العمل على تطوير سياسة اللامركزية والإنتاجية المحلية والجهوية، يكون بذلك يعيش حالة أو مرحلة انتقالية لتجاوز تلك الدولة الرؤوم، إلى تفويت وسيلة أداء في يد المحلي والجهوي لخدمة متطلبات التنمية بنفسه.
لكن ما هو الدور الذي سيبقى معترفا به للدولة في ظل هذه التحولات؟ يمكن تصور لعب دور المنسق، وهنا فقط يمكن تصور شرعية ومشروعية وجود الدولة، أي التنسيق بين عمل عدة قوى تعمل داخل المجمع، ولكن هذا التصور يبقى على المدى الطويل، بعد أن تكون قد قامت فعلا بمختلف الإصلاحات الشمولية.
لكن حينما نتحدث عن الإصلاح والتغيير، فهل بالضرورة يفترض طرح فكرة غياب أو حضور الدولة؟ هل تغيير الإدارة رهين بتغيير الدولة نفسها من خلال إدخال قيم ومثل جديدة؟ هل الإدارة الترابية من خلال النخب الجهوية والاقليمية والمحلية؛ وبحكم ثقافتها وقدراتها وإمكاناتها، قادرة على الاندماج في محيطها والتحكم وضبط المجال الترابي؟ كيف يمكن إعادة تحديد العلاقة بين الدولة وهذا الترابي؟ هل بقيام الدولة بما لا يستطيع الخواص القيام به، من تنمية ثقافة الصالح العام والسهر على مختلف التوازنات الاجتماعية والاستمرارية الترابية والوحدة والتضامن، أو من خلال لعب دور الضابط للنسق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي؟
هنا يمكن رسم صورة لهذه الحالة التي تعيشها الدولة في المغرب في علاقتها بالجماعات الترابية، من خلال ثلاثة سيناريوهات: إما قبول المجازفة بالتخلي لفائدة الجهوي والاقليمي والمحلي عن الاختصاصات في تدبير شؤونه بنفسه. أو اتباع سياسة التقويم الهيكلي او القطاعي، وذلك من خلال إعادة النظر في علاقة المركز بالمحيط؛ أو القطيعة مع كل هذه السياسات المتبعة والتخلي عن التدخل، وذلك بإقرار سياسة جهوية ولامركزية حقيقية موسعة لفائدة الاقليمي والمحلي والجهوي .
فإذن هناك مخاض تعيشه الدولة من خلال تحديد الدور الذي يجب أن تلعبه الإدارة والجماعات الترابية في المجتمع وفي إطار المتاح من الإمكانيات وملاءمتها حتى تلعب دورها التنموي، من خلال إرادة القوى الفاعلة وأطراف اللعبة السياسية بما في ذلك المحاورين الاقتصاديين والمواطن. لكن هل يمكن الحديث عن استقلالية الدولة عن المجال الاقتصادي؟
ان تطور الدول الأكثر تقدما في جميع المجالات، أصبح يفرض عليها فقط البحث عن التوازنات التنموية، بحيث وصلت إلى درجة من التضخم والاشباع في كل شيء، في الإنتاج، في التكنولوجيا، في مختلف الخدمات، وأيضا حتى في أزمة الوعي السياسي والثقافي… إلى غير ذلك، أي أنها أصبحت تحتضن مجتمعات متعايشة سياسيا واجتماعيا مقابل أخرى تنافسية اقتصاديا.
وعلى الرغم من كونها مهيأة من خلال بناها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لاستيعاب قوانين السوق، وبالتالي فاللحاق بها من طرف الدول الأكثر تخلفا يبقى مجرد لغة دبلوماسية؛ ستبحث لها على مزيد من الاستقطاب لهذه الأخيرة، ويتبين ذلك من خلال سياساتها المتبعة في المجال الاقتصادي.
فالولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى البند301 من مدونة التجارة للعام 1974؛ والذي يخول لوزير التجارة الأمريكي ردع كل ما من شأنه المس بالمصالح الاقتصادية والمنتجات والسلع لأمريكا. وقد شاهدنا الحرب الطاحنة حول منافسة منتوج التكنولوجيا “هواوي” ومنتوج التكنولوجيا “آبل” وقبل ذلك مع منتوج التكنولوجيا “سامسونغ”.
اما اليابان فتعتبر النموذج الفعلي لحماية أسواقها، وذلك من خلال فرض مساطير وإجراءات إدارية جد معقدة؛ كاشتراط نسبة معينة في الجانب التقني والصحي في السلع والمنتجات المراد بيعها بالسوق اليابانية، وهذه الإجراءات والمساطير تتغير بسرعة فائقة يصعب ضبطها من قبل المستثمر الاجنبي، وكذا اشتراط بيع هذه السلع الأجنبية في محلات تجارية خاصة، بل وتمون في ملكية مواطن ياباني، مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة، وبالتالي الانسحاب بمحض الإرادة من السوق اليابانية.
أيضا من الأسواق المغلقة في وجه السلع الأجنبية، بالرغم من حرية التجارة العالمية، أسواق دول أوربا الموحدة على الرغم من مصادقتها على قوانين المنظمة العالمية للتجارة، إلا أنها مع ذلك تلجأ إلى طرق حمائية لحماية اقتصادياتها وسلعها؛ من خلال السياسات الموحدة لحماية منتجاتها من المنافسة، وكذا سياسة الدعم والاحتكار… إلى غير ذلك من الإجراءات الحمائية المتخذة.
ان الرأسمالية العالمية لا تسمح باللحاق بهذه المراكز من لدن دول العالم الأكثر تخلفا التي لم تدخل بعد مرحلة الإنتاج التنافسي، وبالتالي فصناعتها غير قادرة على المنافسة على المستوى العالمي. فالعلاقات في إطار الاعتماد المتبادل تبقى غير ممكنة، لأن روح الرأسمالية وقوانين السوق تقوم ويحكمها الاستقطاب، فالسيطرة المجهولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على العالم، وجعله تحت نسق واحد، حسب توماس فريدمان الذي يرى أن العولمة الحالية ما هي الا نوع من الهيمنة التي تقوم الاستقطاب، بحيث أن لها تأثيرا كبيرا على حياتنا الاجتماعية والدينية والثقافية والاقتصادية والسياسية. وهذا ما يساعد في تشتيت وطمس المبادئ والقيم التي بنيت عليها الدولة. فبدلا من تطويرها؛ تعمل العولمة على تشتيتها من أجل سهولة استغلال الدول وخلق تبعيتها من خلال تغييب دور المجتمع داخل الدولة. وبالتالي فمشروع العولمة وانفتاح الأسواق سيؤدي إلى مزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من التهميش للحالة الاجتماعية في الدول المتخلفة.
فكيف نلبي الالتزام بالاتفاق الدولي ونوفق بين متطلبات الجانب الاجتماعي ادن؟ هناك عدة اصلاحات قامت بها الدولة من اجل تجاوز الأزمة وخلق حركية في مجال السياسات العامة؛ شملت عدة ميادين يمكن حصرها في عدة متغيرات؛ كالعمل على تشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية، من خلال الدعوة إلى تبسيط المساطير والإجراءات الإدارية التي وإن كانت مهمة إلا أنها تؤدي إلى نزوع المستثمر وتثبيط هممه، وصدور مدونة الاستثمارات، وإحداث المحاكم التجارية، والتي جاءت بدل مشروع محاكم الأعمال. كما تم خلق منطقة للتبادل الحر بميناء طنجة المتوسط، وكذا التأثير على السياسة الضريبية كإلغاء الضريبة الازدواجية والاتفاق بين الأطراف حول ضمان الاستثمار، وبالموازاة مع ذلك قبل المغرب خضوعه للمادة 8 من مدونة صندوق النقد الدولي حول تحويل وتعويم الدرهم والمعاملات الجارية في التسديد والاستمرار في نهج سياسة الخوصصة وفتح المجال أمام المبادرة الحرة. وكذا تشجيع سياسة الجهوية واللامركزية، وذلك بإبعاد القرار المركزي شيئا فشيئا.
وهنا نتساءل هل هناك ما يخسره هذا المحلي أو الجهوي من خلال هذا الإبعاد، أم لابد من استراتيجية هذا القرار المركزي؟ وبعبارة ادق نقول هل وصلنا فعلا إلى مرحلة عدم تدخل الدولة؟ دولة أقل تدخلا أو دولة أكثر تدخلا؟
إن شرعية ومشروعية الدولة في تنمية المجتمع والأفراد وخدمة الصالح العام تبقى محل نقاش وتساؤل؛ بحيث ان سياسة الجهوية واللامركزية تحيل إلى الاقتصاد غير المتمركزة، ويعني المنافسة واقتصاد السوق، بحيث يطرح التساؤل حول الاختيارات والبرامج وخطط العمل وعلاقة الجهوية واللامركزية ونوع التنمية الاقتصادية المراد الوصول إليها؟ إذ كيف تستطيع أن تراهن على نماذج تنموية تمكنها امتياز الدخول إلى السوق العالمية؟ وما هو المعيار المعتمد او الذي يجب اعتماده في توزيع الاختصاص؟ على أي مبدأ وأساس سيحدد الدور الجديد الذي ستلعبه الدولة؛ هل دولة وصية؟ ام دولة مراقبة؟ ام دولة منسقة؟ ام دولة استراتيجية؟ وكيف سيتم الحسم في التقطيعات الإدارية؛ هل على أساس تجانس البنيات الاقتصادية والاجتماعية، أم على أسس ديمغرافية وعرقية والذي يتنافى بطبيعة الحال والمعطى الاقتصادي؟
ان المحلي والاقليمي والجهوي؛ ينتظر دائما من الدولة أن تقدم له الوصفات الجاهزة حول برامج ومخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مع ان إدارة اليومي الجهوي والاقليمي والمحلي؛ يعني المشاركة، ويحيل الى المنشط الاقتصادي القادر على توجيه الاستثمارات ووضع الخطط التي تتلاءم وواقعه الاجتماعي والاقتصادي والجهوي والاقليمي والمحلي، وبالتالي فالذي يتوصل بالرسالة هو الذي عليه تحديد صندوق البريد.
ان العالم يعيش مرحلة انتقالية حول فصل مجال السياسة عن مجال الاقتصاد، إلا أن ذلك ينطبق على الدول الأكثر تقدما، أما الدول الأكثر تخلفا ومن ضمنها المغرب، فالاستقلالية ممكنة، لكن مع وقف التنفيذ وإلى إشعار آخر، بحيث لازلنا نحتاج إلى مزيد من تطوير الفرد والمجتمع والحماية الاقتصادية والاجتماعية للدولة. فإذا كانت ندوة “بريتن وودس” سنة 1944، انبثق عنها ميلاد مؤسسات مالية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقابلية الدولار للتعويم سنة 1971، إلا أن الحرب الاقتصادية للتسعينات تتجاوز بكثير حرب العشرينات والثلاثينات، وبالتالي أصبح التساؤل يفرض نفسه بحده حول مدى مرونة اقتصاديات البلدان الأكثر تخلفا لما بعد هذه الجائحة؟
فإذا كانت دول جنوب شرق آسيا استطاعت اللحاق بالمراكز العالمية الاقتصادية الضخمة، فإن العديد من البلدان الأكثر تخلفا لازالت التنمية فيها متعثرة ومن ضمنها المغرب حيث لم تستطع الدولة تعبئة مواردها المادية والبشرية، رغم المحاولات المحتشمة. من خلال انتاج يعتمد على الذات؛ لكن ليس اقتصاد الكمامات.
إن متطلبات التنمية، تستدعي التحكم في السياسة المالية والنقدية، وذلك بالتأثير على مجموعة من المتغيرات، وعملية مفاضلة بين عدة خيارات، كسياسة الاقتراض الأجنبي أو الداخلي أو بنوعيه، السياسة الضريبية، سياسة التمويل بالعجز، الإصدار النقدي، سياسة الادخار الإجباري أو الاختياري، سياسة الخوصصة، سياسة اللامركزية والجهوية، والتحكم يفترض أيضا طرح التساؤل عن سبب إتباع هذا الخيار؟ ما هي نتائجه؟ وما هي آثاره على وفي تعبئة المتاح من الموارد؟
على مستوى النظريات والأدبيات الاقتصادية، والنقاشات التي تخللت التحليل والتطور الاقتصادي، نجد النموذج الكينزي الذي يعطي الأهمية لمحدد الصادرات لمضاعفة الإنتاج من خلال مؤشر الطلب، في حين النموذج التطوري للاقتصاديين الجدد يركز على شروط العرض والتكويم الرأسمالي ومؤشرات التوزيع والإتقان والتقدم التقني.
أما النظريات الحديثة فتدخل عنصر الرأسمال البشري من خلال تراكم وحشد المعرفة في وظائف الإنتاج على مستوى الاستراتيجية الصناعية، والتحكم في السياسة المالية والنقدية، ونوع وطبيعة الاستثمارات وقوتها من خلال التطور المنسجم والمتوازي وكذلك طبيعة الأسواق والتوجهات والتخصص من خلال التصنيع وإنعاش الصادرات.
فإذا كانت الدول الأكثر تقدما، تبحث الآن فقط عن التوازن التنموي، فإن الدول الأكثر تخلفا لا يزال أمامها تحدي الوصول إلى أحسن حال؛ أي بلوغ الأفضل وتعرف أكثر وأن يكون لها وجود أحسن.
وإجمالا فإن متطلبات التنمية تبقى مسار تحولات في البنيات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية والثقافية، ونسق منسجم من الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية كأساس في كل خطة منظمة لعمليات التنمية في الدولة، من خلال الجماعات الترابية والمقاولات العمومية والشبه عمومية أو الخاصة، وذلك بإرادة نخبة سياسية، واقتصادية واجتماعية، وتكنقراطيه شجاعة، وفوضوية وجريئة؛ تحرك عمليات الإنتاج ورأس المال وتضبط السياسات المالية والنقدية وتواجه تحديات الظرفية العالمية المتغيرة باستمرار، في إطار جهاز إداري فعال.
ولعل الندرة والتخلف التنموي، ليس هيكليا في المغرب، وقد تكون متطلبات المنافسة حافزا على تحريك بعض الأنشطة غير المستخدمة، ولعل البديل يكمن في الجماعات الترابية في قيادة مسار التنمية في البلاد. فرهان السوق والمنافسة للمراكز الاقتصادية العالمية يتنافى كليا وسوء توزيع الاستثمارات والاختلالات الإدارية وسخف المؤسسات والفوضى في الشؤون المالية للدولة والإدارة وغياب سياسة مالية ونقدية ناجعة ومحكمة.
صحيح أن المنافسة وحرية المبادرة الفردية تتنافى والتوجيه، لكن يمكن تصور ذلك في البلدان الأكثر تقدما، أما في البلدان الأكثر تخلفا فالمبادرة الفردية وحرية المنافسة تبقى مشروطة بالخطة التنموية العامة ومستويات الرخاء في البلاد.
فتراجع الاهتمام بدور المرافق العامة يدخل ضمن استراتيجية تسعى إلى تقوية الرأسمالية، وحرية المبادرة، وبالتالي تراجع الدور المعترف به للدولة في العديد من الأنشطة الاقتصادية على الخصوص، على أن تحتفظ بدور الحماية الاجتماعية، لكن كيف تستطيع القيام بهذا الدور؟ أي دور المنسق الاقتصادي وتطوير الفرد والمجتمع في نفس الوقت؟
فالتطور السريع الذي تعرفه الظرفية الاقتصادية على المستوى العالمي والتغييرات الداخلية، منذ عقد الثمانينات وسياسة التقويم الهيكلي، لم يقف فقط عند حدود مس الأسس التقليدية لبنيات الدولة، بل تجاوزته إلى تعرية الوجه المقنع للبنيات والهياكل التحتية التقليدية والهشة للاقتصاد الوطني، والتي كانت وراءه بطبيعة الحال السياسات العامة المنتهجة كأساس تقوم عليه هذه البني. فالاقتصاد العائلي، أصبح متلاشيا أمام قوة المراكز العالمية وغير قادر على اللحاق بها.
فكيف يمكن مواجهة استقطاب هذه المراكز الضخمة؟ إن تشجيع الاستثمارات رهين بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، ووجود قوانين وأنظمة قضائية تؤمن أموال المستثمرين، وأيضا إصلاح وإعادة النظر في القوانين المنظمة للبنية العقارية في المغرب.
صحيح أن الإجراءات والمساطر الإدارية مرتبطة أحيانا بمشكل البنية العقارية بالمغرب؛ حيث تنوعها وتعددها وخضوعها للعديد من المتدخلين، لكن أيضا تبقى ضرورة تواجد جهاز قضائي فعال يضمن حقوق وحريات الأفراد، من خلال نظام قانوني ونظام قضائي منسجم من اجل تحقيق الامن القضائي والقانوني.
وآنذاك تجد الدولة مشروعيتها، في توجيه وتوزيع الاستثمارات عبر التراب الوطني، بحيث أن معظم الاستثمارات لا تتجاوز المنطقة الصناعية الساحلية، والتي تضم أزيد من 75% من الاستثمارات، مما أدى إلى تهميش باقي المناطق، التي تعاني من ضعف البنيات التحتية والبطالة والهجرة نحو المدن الكبرى الصناعية. وبالرغم من محاولات الإدارة العمل على تشجيع الاستثمارات بالمناطق النائية، من خلال التسهيلات الضريبية، إلا ان غياب الوجود الفعلي للرقابة، أدى بالمستثمرين إلى إحداث المقر بالمنطقة النائية للتحايل على دفع الضريبة، في حين الوحدة الإنتاجية يوجد مقرها بالمنطقة الصناعية. وأيضا غياب توجيه الاستثمارات أدى إلى تنامي مجتمع استهلاكي، حيث اقتصر الاستثمار على المنتوجات الغذائية الاستهلاكية.
في اتجاه آخر، عملت الإدارة على محاولة امتصاص البطالة في صفوف الشباب من خلال مقاولات الشباب أو الشباب المقاولين، إلا أن هذه التجربة على الرغم من أهميتها، إلا أنها تعاني من مشاكل تتمثل بالأساس في عدم القدرة على مواجهة المقاولات القديمة، التي تستطيع أمام غياب مراقبة الإدارة أن تتملص من الضريبة من خلال الإنتاج غير المنظم والمعاملة في التهريب، فكيف يتساوى من يعمل في إطار القانون والذي يعمل في إطار الفوضى؟ فالمنافسة من المفروض أن تكون مشروعة، أما أن يسمح لهذا بما يمنع لذاك، فتلك مفارقة كبرى!
ان التكويم الرأسمالي، أمام ضعف الدولة في توجيه وحصر الالتزام بالقطاع العام، وضعف الخوصصة التي يبقى لها أثر هامشي على مجموع النشاط الاقتصادي، يتعارض وخلق سوق كبيرة لجلب الرساميل من خلال الاستثمارات. فمقولة المغرب “التنين” المقبل، لكن يقابلها أيضا “المستهلك المتوحش وليبراليته المتوحشة الذي يجعل من المقولة مجرد لغة دبلوماسية أو شعار التفاهة في غياب إصلاح وتغيير اقتصادي واحتكار تنظيمي للمجالات والأنشطة الاقتصادية من خلال التحكم في السياسة المالية والنقدية.
نستنتج ان المشهد الغربي للديمقراطية يفصل بين نمط الديمقراطية السياسية وقوانين السوق التي لا علاقة لها بالديمقراطية والسياسة والحماية والعدالة الاجتماعية. لكن نحن في البلدان المتخلفة؛ نحتاج إلى ديمقراطية تكون وسيلة أداء في يد المواطن من خلال النظم الجهوية والاقليمية والمحلية والإنتاجية للقيام بالإصلاحات اللازمة والضرورية، وبالتالي الاستجابة لمتطلبات التنمية المحلية.






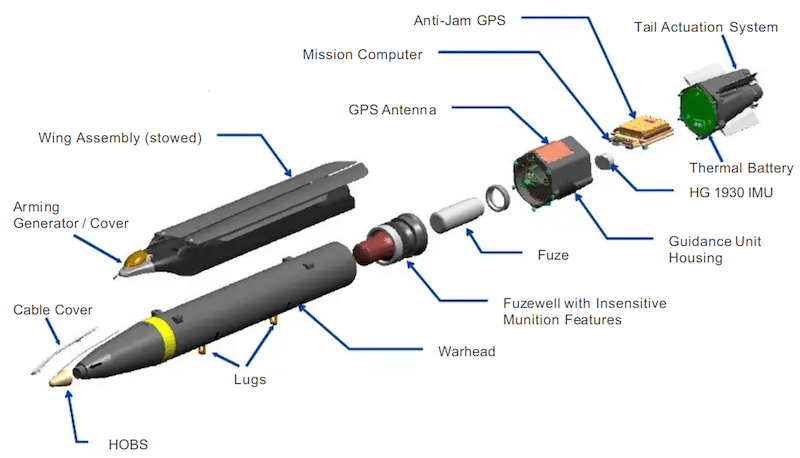








تعليقات الزوار ( 0 )