صباح يوم الثلاثاء الفاتح من سبتمبر اتصلت بمحمود معروف كي نلتقي، على قهوة، مثلما دأبنا عليه، ويُسلمني نسخة من كتاب كان فرغ من تحريره، من أجل أن أطلع عليه، وأبدي رأيي فيه، مثلما طلب مني قبلها. اعتذر لانشغالات طارئة، ووعد بأن نلتقي الأسبوع المقبل، لم يكن صوته يبدي الوهن، كان آخرَ مرة التقيت به عقب انفجار مرفأ بيروت، في بيته، على قهوة شامية، مع زوجته بَحرية، وابني وقد عرفه وليدا، وكان يسألني عنه دوما، وقد انتقل للدراسة في بريطانيا.
ذهب الحديث كل مذهب، وكان مما أذكره قوله إن هناك أحداثا لا يمكن دفعها وهي ضرورية لمسيرة التاريخ. كان محمود في تحليله ذاك يصدُر من رؤية هيغيلية، وأن الأشخاص أفكار يحيون مادامت تحيا أفكارهم، وينتهون إن ذوت الأفكار التي تسكنهم. ثم انتقل الحديث إلى ما يعرفه العالم العربي من انقسام، ورأى أن في ذلك مزية الوضوح حتى لا يبقى هناك غموض، إذ الحلال منذ اليوم بيّن، والحرام بيّن، ولم يعد هناك مكان للمتشابهات. لم أكن أقدّر أن ذلك الحديث العفوي والعابر سيكون آخرَ لقاء. وكأنما أراد محمود أن يسفر عن هويته العميقة، لاتجاه كان متوهجا في فترة، وهي أن تحرير فلسطين يبدأ من تحرير البلدان العربية.
لم يُتح لصحافي غير مغربي في المغرب أن يعرف سدى الجسم الإعلامي والسياسي والثقافي، كما أتيح لمحمود معروف، عدا الراحل واصف منصور. كان كلاهما يعرفان كل واحد، ويعرفهم كل واحد. وكان محمود يتميز عن سلفه الفلسطيني منصور، بقوة التحليل الموضوعي. كان يحمل ميسم الثورة الثقافية التي رفعتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في تحرير اللغة، وفي القدرة على التحليل الموضوعي، والنأي عن الخطابة والعنتريات. كان محمود معروف القضية الفلسطينية في المغرب تمشي على الأرض، بتعبير هيغل. يحملها في تجربته الشخصية، في أسرته المشردة من فلسطيني 48، من دير القاسي من أعمال عكا، إلى مخيم في بعلبك فيه سيرى النور، يحملها في دراسته في بغداد، وفي استقرار أسرته لفترة في ليبيا، ويحملها في شظايا الصراع والتمزق، من هزيمة 67، وأيلول الأسود، والحرب الأهلية اللبنانية، وكامب ديفيد، والمقاومة الفلسطينية للقوات الإسرائيلية في بيروت، وصبرا وشاتيلا… كان يحملها، من دون أن يسفر عنها لأنها مقترنة به. وكان على خلاف الصورة الشائعة عن الفلسطينيين، مقلا في الكلام، لا يجنح للخطابة، ويستعيض عنها بالتحليل، وبالثقافة السياسية لليسار العربي. كان إلى ذلك منضبطا في مواعيده، وفي التزاماته.
أقف في علاقتي به، على مرحلتين من حياتي، مرحلة كنت فيها في رحم السلطة، وزارني في نهاية أغسطس 1999، ليخبرني خشية القيادة الفلسطينية من تحركات تنازع المغرب رئاسة لجنة القدس، بدعوى أنها كانت مقترنة بشخص الملك الراحل الحسن الثاني، وبالفعل أكد المغرب حرصه على رئاسة لجنة القدس في شخص الملك محمد السادس، دفعا لأي لبس، وعبّر الرئيس ياسر عرفات بمجرد حلوله في المغرب في ذكرى وفاة الملك الحسن الثاني عن سعادته للقاء بأخيه الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، ورُفعت الأقلام وجفّت الصحف.
في تلك الفترة خامر محمود الأمل، في أن تطبع جريدة «القدس العربي» في المغرب، ورغم أنها كانت تصل متأخرة لأربع وعشرين ساعة، فقد كانت واسعة الانتشار. غير أن ذلك المشروع الذي حمّلني إياه محمود معروف، وحمّل بعدها وزراء الاتصال المتعاقبين من المرحوم العربي المساري، ومحمد الأشعري، ونبيل بن عبد الله، لم ير النور، لاتجاهات لم تكن تخص محمود بالود، وتصدر في الغالب من أحكام جاهزة، ويقترن لديها شخص محمود ومرجعيته الفكرية وتوجه الجريدة. ما أذكره أننا التقينا سنة 2004 بعد عشاء في بيتي في شاطئ الهرهورة إلى شقته في شارع باتريس لومبا، مع الشاعر محمود درويش، ولفيف من السفراء العرب، وزوجاتهم، ولم يسلم ذلك اللقاء من تنطع البعض، ممن أراد أن يلقي شعرا، بحضور درويش، مما أضجره.
بدأت مرحلة جديدة، في علاقتي بمحمود معروف، منذ أن اخترت لنفسي خيارا بعيدا عن «غواية الرُّتب، واصطناع الملوك» كما يقول ابن خلدون في سيرته التعريف، وكان أن استضافني لإفطار في شهر رمضان سنة 2014، حضَرَته رئيسة تحرير جريدة «القدس العربي» السيدة سناء العالول، ولفيف من الشخصيات المغربية، منهم محمد اليازغي ومصطفى الخلفي، وكان حينها وزيرا للاتصال، وبقيت في جلسة جانبية مع محمود وسناء العالول. بعد أيام عرض عليّ محمود أن أكتب في «القدس العربي» فاعتذرت. لم يكن من السهل الانغمار في الكتابة في جريدة «القدس العربي» لمن كان إلى عهد قريب في دائرة المخزن، ولمن يحمل، عن صواب أو خطأ، تهمة الاتجاهات الأمازيغية المتطرفة، أو عُتاتها كما كان يشاع. في سنة 2013، تلقيت دعوة من قِبل السلطة الفلسطينية، لحضور معرض الكتاب الفلسطيني في رام الله، وزرت محمود للاستشارة، حتى لا أكون غرضا لتهجمات مناهضي التطبيع، واشترطت أن نذهب معا، وطمأنني أن مشاركتي ليست من قبيل التطبيع. اعترضت السلطات الإسرائيلية على مشاركتي، ولم أذهب لرام الله. وكان مما أخبرني به محمود معروف بعدها الاحتفاء الذي عرفته روايتي «الموريسكي» في معرض الكتاب في رام الله، رغم أني كتبته بالفرنسية، وتُرجم إلى العربية، وسرّني ذلك لأنني كنت أجريت ضمنيا تقاطعا ما بين مأساة الموريسكيين ومأساة الفلسطينيين، وسرّني أن القارئ الفلسطيني أدرك ذلك. وعاودني محمود من أجل الكتابة في جريدة «القدس العربي» وكان التنصل هذه المرة يعني موقفا من الجريدة، ومن القضية الفلسطينية، فركبت غمار تجربة أنا بها فخور، ومَدين فيها لروح محمود معروف.
لم يكن خيارا سهلا بالنسبة لي، لأني ظللت موزعا بين مسار سرته في حياتي، أحمل ميسمه، ويغلب عليه مقتضى الواقعية والبراغماتية، وشبكة علاقات مع إغراء «النجاح» وتوجه عميق ظل يسكنني، ذلك الذي أخذته عن أهلي، في بساطته وعفويته. وانتصرت في نهاية المطاف لما أستمده من أهلي. لم أكن في النظرة الميتافيزقية ذاتها، كما استخلص البعض، ولكن كانت رؤية تنبع من دواعي العدالة، ومن الانتماء لحضارة. حضارة جمعها سدى مشتركا، وتعرضت لقرون لما يسميه سمير قصير بلعنة الجغرافية، من احتلال وتقطيع، وقولبة وتشكيك في الذات. لم تكن فلسطين رقعة جغرافية فقط، ولكن فكرة وساحة لمعركة حضارية. حين كان يُشْكل عليّ أمر في شأن القضية الفلسطينية، كنت أتصل بمحمود حول فهم ما يجري، أو استدراك ما فاتني من أحداث.
كنت أتناول الفطور في مقهى إفران في أصيلا حين نعى الناعي محمودا. لم أصدق أن يتخلف عن الموعد الذي ضربه. أوقفت عطلتي ويممت الرباط. غاب محمود بجسمه ولم يغب بروحه. «لم يمت أحد تماما. تلك أرواح تُغيّر شكلها ومُقامها» كما يقول محمود درويش. السنة المقبلة يا محمود في القدس أو أور شليم، مدينة السلام، باللغة الأرامية، لغة المسيح. جزء من المعركة هو انتشال سلاح الآخر، وسلاحُه المَضّاء هو الذاكرة.


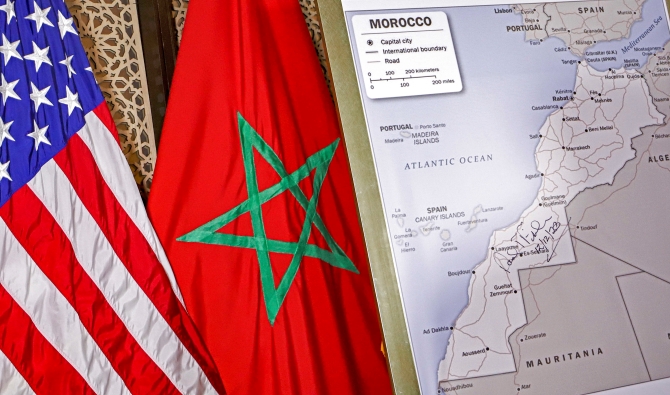












تعليقات الزوار ( 0 )