اِعلم، أخي أختي، أنه كل مرة يثير ملف إشراك النساء في العمل السياسي نقاشا سياسيا وقانونيا، حتى أمسى العديد من الفاعلين والفاعلات من رواد هذا النقاش، بل أصبح فرصة لتصفية حسابات سياسية بين الأطراف بعدما جعلوا من مخالفة هذا التوجه تهمة تستوجب التحقير والاستبعاد، ولما لا الإدانة إن أمكن؛ غير أن العاقل لا ينبغي له أن يسير مع أي تيار مهما بدا متوغلا، ولا أن يشذ برأي بدعوى أن أصحاب الحق دائما هم القلة والغرباء في هذا العالم الظالم؛ وعليه، من خلال هذه الفقرات المختصرة، سنحاول مناقشة أمر إشراك المرأة أو مشاركتها في الساحة السياسية في ضوء ما تم إقراره من نصوص قانونية، لكن دون إغفال الواقع السياسي في بلادنا عموما، وعلى مستوى الجماعات الترابية خصوصا.
لقد نص الدستور المغربي، وهو أسمى قانون في المملكة، في الفصل 19، على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،… وتسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء”؛ بل أكد الدستور من خلال الفصل 164 على أن الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز، تسهر بصفة خاصة على احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل السابق؛ كما أن مجموعة من القوانين، بمختلف درجاتها، أكدت على ذلك وعملت على التدقيق في التفاصيل أكثر؛ لذلك نجد على مستوى مختلف المنظمات ذات الطابع السياسي، سواء المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، قد ألزمها القانون بإشراك المرأة في تدبير شؤونها؛ ويتجلى ذلك في فرض وجود نسبة معينة على مستوى تأليفها، وكل منظمة بصيغة تناسبها.
وعليه، فإن قوانين الجماعات الترابية، على مستوياتها الثلاث، تم تضمينها مواد تنص على تخصيص نسبة من مجموع الأعضاء المنتخبة، كما ألزمت على هذه المجالس، عند انتخاب مكاتبها، ضرورة تضمين نسبة الثلث، على الأقل، من نواب الرئيس عند تقديم لائحة ترشيحات نواب الرئيس، وذلك بغية السعي نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الدستور حسب ما تم الإفصاح عنه بشكل واضح في القانونين التنظيميين رقم 111.14 ورقم 112.14؛ إلا أن تنزيل ذلك على أرض الواقع لم يكن سهلا ولا نعتقد أنه سيكون بالأمر اليسير فيما سيأتي من المحطات، لاسيما على مستوى مجالس الجماعات ومجالس العملات والأقاليم.
عند الرجوع إلى المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة الفقرة السادسة منها، نجدها تنص على ضرورة العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس؛ وفي نفس القانون نجده يحدد عدد نواب رؤساء الجماعات، حيث يحددون بين ثلاثة نواب في أقل تقدير وعشرة نواب في أقصى حالة (انظر المادة 16 من القانون التنظيمي 113.14)؛ وفي حالة جماعة إمزورن، فإن عدد أعضاء مجلسها يبلغ 30 عضوا من بينها 6 عضوات، وأما عدد نواب الرئيس فيبلغ 6 نواب، بمعنى أنه على الأقل وجود عضوتين في لائحة نواب الرئيس المقدمة للترشيح حسب ما يقتضيه صريح المادة 17؛ إلا أن هذا المجلس عندما أعاد انتخاب رئيسه ونوابه يوم 30 نوفمبر 2024 لم يلتزم بمقتضيات هذه المادة، كما لم يلتزم بها عندما انتخب الرئيس بعد انتخابات 2021، حيث اكتفى بنائبة واحدة فقط؛ لكن هذه المرة أثارت هذه القضية النقاش لما عرفه التنافس بين المرشحين للرئاسة من شراسة، حيث فاز الرئيس احتكاما لعامل السن بعدما تعادل عدد الأصوات المحصل عليها وهي 13 صوتا لكل واحد منهما.
وعليه، إن التزم من اعترضوا على هذه اللائحة بوعودهم، فإن النزاع قد يعرض على القضاء الإداري، وسيحسم فيه؛ لكن بعيدا عما سيسفر عنه قرار المحكمة إن حكمت في النزاع، لابد من تسجيل بعض الملاحظات التي تخص نازلتنا هذه، لاسيما ذات البعد السياسي.
للتذكير فقط، فإن نسبة النساء في مجلس جماعة إمزورن هي الخمس (6/30)، وهي النسبة التي لا تتناسب مع الثلث التي ينص عليها القانون في عدد نواب الرئيس، بل قد تطرح تساؤلات قانونية بخصوصها وتفتح نقاشا كبيرا؛ فكيف تم جعل نسبة نواب الرئيس من النساء تكبر نسبة عضوات المجلس مع أعضاء المجلس، بينما المنطق السليم يقتضي جعل النسبتين منسجمتين؛ وكل هذا طبعا، إن تم التسليم بما نص عليه من النسبة أو الكوطة المخصصة للنساء، لاسيما أن مبدأ المساواة في الحقوق والحريات المنصوص عليه والمعمول به في المغرب لم يترك منفذا لأي شخص منع مواطن أو مواطنة من حق الترشح بشكل عام، أو من حق الترشح للمسؤولية على مستوى مجالس الجماعات بشكل خاص؛ بل إنه مع هذه المواد التي تمنح للنساء حق الكوطة تنتصر للتمييز الإيجابي للنساء ضد الرجال، ما يجعل إمكانية التفوق عليهم وليس التساوي وتحقيق المناصفة فقط.
وعليه، بالرجوع إلى الحالة المدروسة، وما هو متاح من المعطيات، فإن الأغلبية التي أعادت تنصيب الرئيس بعد عزل الرئيس الأول من طرف المحكمة الإدارية بفاس، قد صوتت على لائحة نواب الرئيس بوجود امرأة واحدة فقط، وذلك لتمكنهم في هذه الأغلبية من ضمهم عضويتين فقط لتحالفهم، الأولى تقدمت للترشح ضمن اللائحة والثانية اعتذرت وبشكل كتابي؛ ما يعني أن وجود عضوات أخرى في المجلس في ضوء هذا المعطى يجعل ترشيحهن ضمن لائحة الرئيس غير ممكن سياسيا لاصطفافهن في المعارضة، بل صوتن ضد الرئيس الفائز، أي كيف يعقل أن يتقدم الرئيس وأغلبيته بلائحة تضم من هو ضدهم؛ وبالتالي، فإن أي مطالبة للرئيس وأغلبيته بمخالفة ذلك لا معنى له، وإنما سيزيد ذلك تمييعا أكثر للفعل السياسي إن حدث، علما أنه في كلا التحالفين أعضاء صوتوا ضد مرشح حزبهم.
ومن زاوية أخرى، ودائما في ضوء النصوص القانونية والواقع المعيش، فإن أحزاب كثيرة لم تستطع في مجموعة من الجماعات، لاسيما في العالم القروي وحتى في المجال الحضري، ترشيح النساء لعدم إبدائهن الرغبة، بل في كثير من الأحيان البحث عن امرأة تقدم ترشيحها في دائرة ما أصعب من التنقيب على الكنوز؛ لذلك نشهد تراجع المترشحين في تقديم ملفهم لغياب العنصر النسوي؛ بل إن هناك حالات كثيرة يقدم فيهن النساء لمجرد توفير شرط تمثيلية النساء وفقط، حتى أنه لا يُعرف عن تلك المرشحة إلا الاسم في غياب تام للفاعلية، وإن حضرن فحضورهن لإكمال النصاب القانوني أو التصويت لصالح قرار معين أو ضده حسب ما تدعيه مصلحة الزعيم، ما يعني أن حضورهن يكون للتأثيث أكثر مما يكون للمشاركة في التدبير.
وعليه، باستحضار الفلسفة التي يقوم عليها الحكم، أو الفعل السياسي، المتمثل في التدافع، رغم طغيان التنافس والصراع من أجل السلطة أو بل حتى الاقتتال، وفي كثير من الأحيان يصعب على الفاعلين، من الرجال الذين خبروا العمل السياسي، الخروج بسلام من الصراع على السلطة؛ لذلك ينبغي على الداخل إلى عالم السياسة، والمشارك في تدبير الشأن العام، أن يكون على درجة عالية من اليقظة والحذر، فضلا القدرة على العمل في ظروف مشحونة لا يمكن الانتهاء منها، ما دام الفاعل السياسي يتقلب بين السعي لتحقيق المصالح تارة، والمطامع الشخصية تارة أخرى، دون نسيان إكراهات الواقع الأخرى؛ وعليه، من يُؤتى به إلى عالم السياسة دون أن يكون مستعدا، كما هو واقع الكثير من الرجال، فضلا عن غالبية النساء، لن يستطيع التأثير في صنع القرار، وإنما سيكون ورقة تُستعمل بغية الاستشهاد بوجود شيء اسمه الديموقراطية وإشراك مختلف فئات المجتمع كالنساء والشباب مثلا.
وبكلمة أخيرة، يمكن القول أن التنصيص على ضرورة منح النساء كوطة خاصة، والدفاع عنه قانونيا، لا يخدم المصلحة العامة، ما دام هناك ثقافة سائدة تهتم بالشكل، وليس بالجوهر، ويؤتى فيها بالمرأة لتأثيث المشهد السياسي، دون أن تفرض نفسها في عالم كله تدافع وصراع واقتتال، يستعصي على القوي المتمكن التأثير، وبالأحرى من يُستدعى بنصوص قانونية، ويُشبه حاله المستدعى إلى حفلة شاي بمناسبة عرس دون أن يكون له دخل إلا باعتباره ضيفا وشاهدا على إقامة العرس وفقط؛ لذلك، قبل الدفاع عن كوطة للنساء، بل حتى الشباب، من خلال النصوص القانونية أو رفع الشعارات في التظاهرات، هل تسائلنا يوما ماذا قدمنا لتأهيل النساء أو تأهيل الشباب لدخول عالم السياسة الذي قيل فيه: السياسة أن تقتل رجلا وتشيع جنازته؟
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.






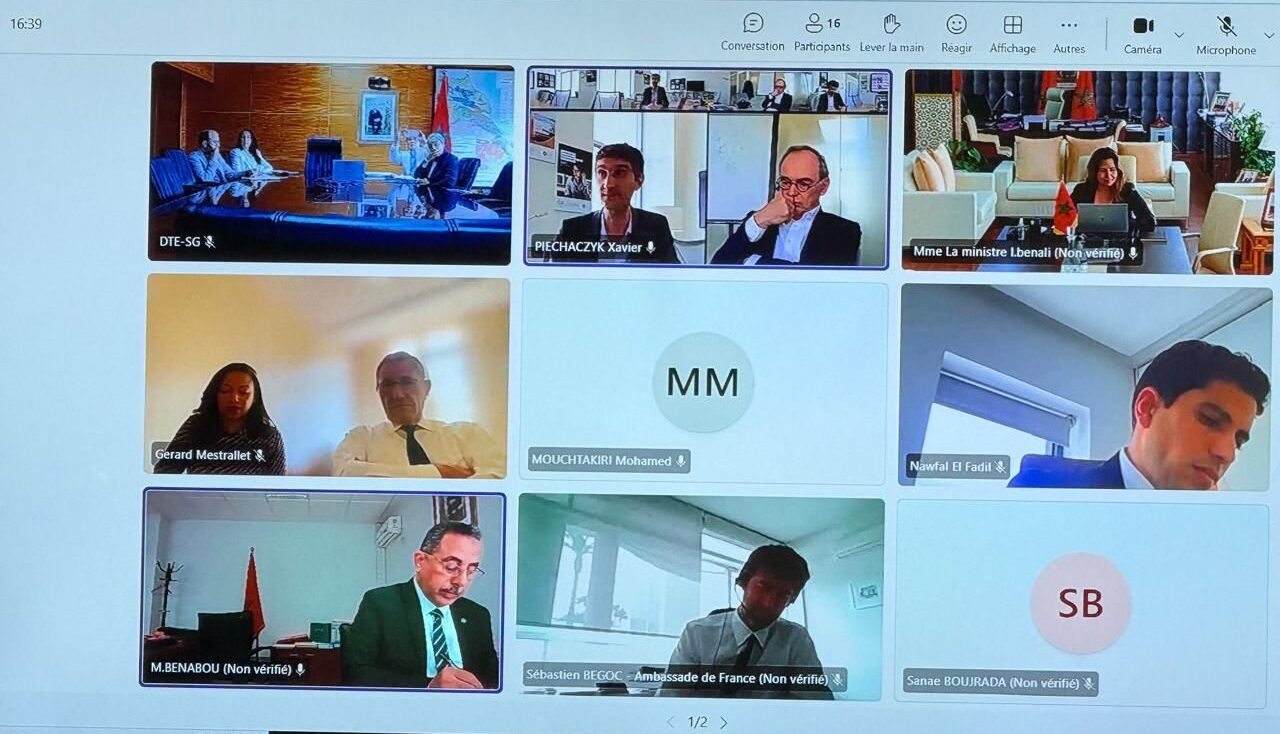








تعليقات الزوار ( 0 )