تندرج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في سياق الإصلاحات المهيكلة التي عرفها المغرب إبان العشرية الأولى من القرن 21، الرامية إلى إيجاد حلول واقعية لعجوزات التنمية البشرية، التي تفاقمت سنة بعد أخرى تحت تأثير عدة عوامل؛ منها غياب الإرادة لدى جزء مهم من مدبري الشأن العام بأهمية التنمية البشرية في تحقيق الاندماج الكلي والسليم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، مما نتج عنه نسيج مجتمعي مفكك، من معالمه الأساسية انتشار الأحياء الهامشية، والسكن العشوائي، وشيوع مظاهر الفقر والحرمان، و أساسا البؤس داخل هذه المجالات. فضلا عن التأخر الكبير والمقلق المسجل بالعالم القروي، الذي يفتقد في جزء منه إلى خدمات الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب والكهربة، وفي أحيان كثيرة يعاني عزلة شبة مطلقة. وهي اختلالات جذرية توضح أن فرضية الاستبعاد الاجتماعي حاضرة وبقوة في جوهر تحديات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خصوصا في مجالات محاربة الإقصاء الاجتماعي، والهشاشة والتأهيل الترابي. وهي ليست مشروعا مرحليا ولا برنامجا ظرفيا عابرا، وإنما هي ورش مفتوح باستمرار.
وبالرجوع إلى النموذج التنموي الجديد، يلاحظ أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية صنفت ضمن خانة الإصلاحات المهمة التي ميزت بداية الألفية الثالثة، حيث مكنت إلى جانب برامج أخرى كنظام المساعدة الطبية، وتعميم التعليم، وفك العزلة عن العالم القروي وربطه بالشبكة الكهربائية، وكذا محاربة السكن غير اللائق، من تقليص العجز في المجال الاجتماعي وتسجيل انخفاض ملموس في معدل الفقر.
وهكذا، وأمام النتائج المهمة التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في المرحلتين الأولى والثانية، بادرت السلطات العمومية إلى الانخراط في مرحلة ثالثة “2023-2019” الهدف منها فتح أفاق جديدة لتجاوز معضلة الاستبعاد الاجتماعي، وهي المرحلة التي أعطيت انطلاقتها من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم 19 شتنبر2018، استنادا إلى توجيهاته الواردة في خطاب العرش ل 29 يوليوز2018، وعلى ضوء نتائج وتوصيات وتقييمات مختلف الشركاء.
فمما لا شك فيه أن الاستثمار في التنمية البشرية، يعتبر الملاذ الآمن لإيجاد أجوبة نوعية عن أسئلة التنمية البشرية. وهذه الفلسفة العامة هي التي تحكمت في المراجعات المتتالية التي طبعت برامج ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولاسيما مع التعديلات الأخيرة التي قام بها المشرع على هذا المستوى، والتي تعكس رؤية جديدة في معالجة مختلف مظاهر الاستبعاد الاجتماعي.
ومن خلال استقراء مضمون و محتوى برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يتبين أن مفهوم التنمية البشرية يحتفظ بجدواه، إذا استحضرنا المستوى الحالي للتنمية البشرية في المغرب حسب ما هو ثابت من خلال الرتبة 121 من بين 189 دولة التي تحتلها المملكة المغربية وفق ترتيب المؤشر الدولي للتنمية البشرية واستدامة التباينات الصادر في بداية دجنبر 2019. لذلك يبدو من الطبيعي أن تسعى المرحلة الثالثة إلى التأسيس لمفهوم جديد للتنمية البشرية يؤمن بأهمية الانتقال من الحكامة إلى الالتقائية في تدبير برامج ومشاريع هذه الأخيرة، من خلال الحرص على تناغم برامجها مع برامج التنمية الترابية، والقطاعية، وكذلك البرامج الوطنية التي تستهدف الساكنة المعوزة، وذلك انطلاقا من التراكمات التي ميزت المرحلتين الأولى والثانية، وانسجاما مع التطلعات الكبرى التي ترى في التنمية البشرية استثمارا مستداما وضروريا للحد من مظاهر عدم تكافؤ الفرص في الولوج إلى التنمية في تجلياتها المجالية والإنسانية. فالواقع المغربي يعيش على إيقاع تناقضات صارخة بين المجالين الحضري والقروي، وحتى بين مجموعة من الأحياء داخل المجال الحضري. لذلك نسجل، أن هذه المرحلة ترمي إلى إتباع نهج جديد إزاء التنمية البشرية، هو بمثابة خطوة هامة نحو هيكلة برامج طموحة لتوفر حوافز للإصلاح من خلال تخصيص مستويات كافية من المساعدات الإنمائية تتناسب مع طبيعة الخصاص المسجل بالنسبة لكل مجال من مجالات التنمية البشرية.
وهذا ما يتجلى في الدعامة الأولى المتعلقة بتدارك الخصاص في مجال البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، التي تسعى إلى سد الفراغ الناجم عن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية الموجه إلى المجال القروي والمناطق الجبلية، بما يضمن معالجة تكاملية لمسببات ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي القهري التي صاحبت المجالات القروية والمناطق الجبلية بمستويات صارخة في ميادين الماء الصالح للشرب والكهرباء والتعليم والطرق والصحة. فقد تم تسجيل تفاوتات فئوية و مجالية هامة. ففي المناطق القروية بلغ معدل متوسط الالتحاق بالتعليم الأولي 35 بالمائة، فضلا عن فوارق بين الجنسين بلغت نسبة 70 بالمائة من الفتيات في سن التعليم الأولي غير متمدرسات.
كما كشف تحليل هذه الوضعية، عن وجود تفاوتات مرتبطة بعوامل اقتصادية، وأخرى اجتماعية وثقافية تتعلق بمكانة المرأة ودورها في المجتمع، ومستوى تعليمها. وهذه التفاوتات تختلف بحسب الأوساط الاجتماعية والمناطق الجغرافية، فعلى سبيل المثال، فإن معدل وفيات الأمهات أكبر مرتين ونصف بالمجال القروي 111.1 حالة وفاة مقابل 44.6 حالة وفاة بالوسط الحضري. وهي تفاوتات حالت دون إمكانية الاستفادة من ثمار التنمية الوطنية، كما ساهمت في عرقلة مساهمة هذه المجالات في العملية التنموية سواء محليا أو وطنيا. ولعل هذه البرامج أحد المداخل الوظيفية لتجاوز مظاهر التأخر وعدم المساواة في فرص التنمية البشرية التي يتيحها الوطن للجميع، من خلال اعتماد مشاريع حقيقية تتلاءم مع الخصاص المسجل في هذا الباب، عبر تقييمها وفقا للحاجيات والأولويات المحددة في إطار برامج متعددة السنوات.
بيد أن هذه الالتقائية، لا تقتصر فقط على البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، بل تطال التنمية البشرية المرتبطة بالأجيال الصاعدة، والأشخاص في وضعية هشة، و بتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب على مستوى المشاركة الدائمة للقطاعات الوزارية المعنية في جميع المشاريع سواء في مرحلة إعداد التشخيص ألتشاركي، و التي هي مناسبة لتقديم مقترحات، والقيام بالتعديلات المناسبة في إطار تشاركي ومؤسساتي ومالي يمكن من تهيئ الظروف المواتية لتوفير تنمية بشرية حقيقية، وفق مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
وتبعا لذلك، يتبين من خلال هذه البرامج أن منظومة التنمية البشرية باتت تتمتع بخيارات واسعة تطال جميع تمظهرات معضلة الاستبعاد الاجتماعي سواء المجالي أو الإنساني، الطوعي أو القهري من بنيات تحتية و صحة الأم والطفل، والتعليم الأولي، فالمرضى المصابون بمرض الايدز… وهي خيارات تنسجم مع أهداف الألفية من أجل التنمية، للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية. وقد جاء هذا المسعى ليرسم لأول مرة في تاريخنا سياسة تخطيطية تصاعدية من القاعدة إلى القمة في أفق إقرار دينامية مستدامة تساعد على الرفع من مؤشر التنمية البشرية.
ومن المهم أن نلاحظ، أن مقاربة الدولة في إطار هذه المرحلة الثالثة تتجاوز المنظور الكلاسيكي في معالجة آفة الفقر، والدليل على ذلك عدم الإشارة في البرامج الأربعة المؤطرة لها إلى مصطلح الفقر، حيث تم استهداف الفئات المعنية بالفقر مباشرة دون تحديد تصنيف معين، مراعاة لكرامة الفئات المستهدفة من جهة، ومن جهة أخرى لأن التمييز المرتبط بالفقر قد لا يطال كل الفئات المتضررة من ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي ولاسيما الطوعي.
وعلى صعيد أخر، نشير إلى أن المرحلة الثالثة فيها نوع من التفصيل فيما يخص مؤشرات التنمية البشرية، من حيث تحديد المؤشرات الخاصة بكل برنامج دون النزوح إلى اعتماد مؤشرات موحدة،لأن عملية التقييم اعتمادا على نفس المؤشرات طرحت في المرحلتين السابقتين صعوبات كثيرة، لذلك، قرن المشرع بين كل برنامج ومؤشرات خاصة به، وهذا إيجابي من أجل قياس درجة تأثير كل برنامج، وتحديد مكامن الخلل، وبالتالي نصل إلى نتائج موضوعية، تعطينا صورة واضحة حول درجة تقدم كل برنامج.
ومما يزيد من أهمية هذه المرحلة، التركيز على أهمية الحكامة الجيدة في تدبير المشاريع المنبثقة عن برامجها، من خلال اعتماد التشخيص التشاركي والتخطيط الاستراتيجي، فهذا الأخير يهم ترجمة الحاجيات المرصودة في إطار التشخيص التشاركي إلى مشاريع وإجراءات يتم رفعها إلى نظر اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي تتولى تقييمها وفقا للحاجيات والأولويات المحددة، ثم بلورة البرنامج المتعدد السنوات، مع تحديد الشراكات ولاسيما مع هيئات وفعاليات المجتمع المدني شريطة مراعاة معايير الجدية والمصداقية والكفاءة والفاعلية في مجال التنمية البشرية.
وإذا كانت هذه المرحلة تتسم بنوع من القيمة المضافة فيما يخص المحتوى والآليات والمرامي الساعية إلى التصدي لإشكالية الاستبعاد الاجتماعي، فإن ثمة بعض الملاحظات التي لابد من إبدائها في هذا الإطار:
الملاحظة الأولى:نسجل أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما زالت عبارة عن برنامج تكميلي لسياسات حكومية أخرى، دون إمكانية الحديث عن سياسة حكومية شاملة، علما أنه كان من المفروض الارتقاء بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة، وبعد كل هذا الكم من المكتسبات، إلى سياسية عمومية حكومية شاملة، فهي لا زالت إلى حدود الآن برنامجا إضافيا للحد من الفقر والإقصاء.
الملاحظة الثانية : من المستجدات التي جاءت بها المرحلة الثالثة سحب رئاسة اللجان المحلية للتنمية البشرية من رؤساء الجماعات الترابية، وتخويلها إلى الإدارة الترابية، الباشا على مستوى المجال الحضري، ورئيس الدائرة على مستوى المجال القروي، في الوقت الذي كان من الممكن الاجتهاد في ابتكار آليات تضمن استمرار مساهمة الفاعل السياسي المحلي في عملية التنمية البشرية كقوة اقتراحية حقيقية بفعل درايته بالمجال الترابي، وثانيا كشريك فعلي في التنمية البشرية.
الملاحظة الثالثة: من المؤكد أن حجم الخصاص المسجل في مجال التنمية البشرية كبير، ويزداد اتساعا في المجال القروي والمناطق الجبلية، ومن ثم، فإن تجاوزه رهين بتوفير الموارد والإمكانات المالية اللازمة، لكن الملاحظ أن حجم الموارد المالية المرصودة لهذه المرحلة يبقى متواضعا. ذلك أن قيمة وأهمية البرامج والمشاريع المعتمدة في إطار المرحلة الثالثة تتوقف في تقييمها على قيمة الموارد المالية المتوفرة. ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالطرق أو الكهربة أو الماء الصالح للشرب. كما نشير إلى أن هذا التخصيص المالي المتواضع قد يعطي الانطباع بأن المرحلة الثالثة ستلعب دور الميسر والمحفز، في حين أن مستوى الخصاص في التنمية البشرية يبقى كبيرا، يستدعي مقاربات تتجاوز التحفيز والتيسير إلى البناء الكامل والكلي للمشاريع والبرامج .
الملاحظة الرابعة: تكمن في استمرار تنزيل هذا الورش من قبل أقسام العمل الاجتماعي بالعمالات والأقاليم والولايات، وهذا يفيد بأن المسألة لم ترق بعد إلى مستوى سياسة عمومية حقيقية تدبر من قبل مؤسسات قائمة الذات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، بعيدا عن هامش التصرف المعترف به حاليا لفائدة الإدارة الترابية من خلال أقسام العمل الاجتماعي، لكن هذا لا يعني الفصل بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والإدارة الترابية نظرا للخبرات التي راكمتها هذه الإدارة في مجال تدبير مشاريع وبرامج التنمية البشرية، ولمقدرتها على تحقيق الالتقائية بين القطاعات الوزارية المتدخلة في هذا الإطار، بل نطمح إلى تعويض أقسام العمل الاجتماعي بمراكز إقليمية للتنمية البشرية تحت إشراف السلطة الإقليمية، تدبر من قبل مدير تتوافر فيه معايير الكفاءة والتخصص على غرار المراكز الجهوية للاستثمار.
وفي الختام، ينبغي التأكيد على أن التنمية البشرية تعبير جديد وبراق، وربما حتى بمنزلة حصان طروادة يشجع على إعادة التفكير في القضايا والمشكلات الاجتماعية بعيدا عن المفاهيم المحدودة للفقر والحرمان، ولاشك أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي قيمة مضافة حقيقية في مسلسل المجهودات العمومية المبذولة من طرف الدولة المغربية في مجال معالجة ظاهرة الاستبعاد الاجتماعي المرتبطة بكل أشكال اللامساواة التي تطبع التنمية البشرية في المجالين القروي والحضري، وهي مرحلة تتسم بانفتاحها على نوافذ جديدة من التنمية البشرية كصحة الأم والطفل والتعليم الأولي، ومنصات التفاعل الخاصة بالإدماج الاقتصادي للشباب، وهي نوافذ جديدة لم تكن حاضرة في المرحلتين السابقتين، من هنا تأتي أهميتها المحورية في تعزيز النهوض بالرأسمال البشري، إلا أنها يمكن أن تبقى دون قيمة ما لم تساهم في تصحيح عدم المساواة في التنمية البشرية على الأقل من خلال الرهان على تحديين اثنين: أما التحدي الأول فيتعلق بتقليص الفجوة وتسريع التقارب بين الإمكانات الأساسية( فك العزلة، الكهربة، الماء، التعليم الأولي، صحة الأم والطفل، تجاوز مشكلة سوء التغذية، ضمان مأوى ……) والإمكانات المعززة (الاستمرارية في التعليم، الحصول على الخدمات الصحية الجيدة، خدمات التعليم الجيدة على جميع المستويات، الحصول بفعالية على التكنولوجيات الجديدة…..). في حين يتعلق التحدي الثاني بتعزيز العدالة والفعالية في ضمان تحسين حقيقي وواقعي للدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ورفع هذه التحديات كفيل بوضع الإنسان في صميم صنع القرار المرتبط بالتنمية البشرية.

دكتور في القانون العام /إطار بوزارة الداخلية







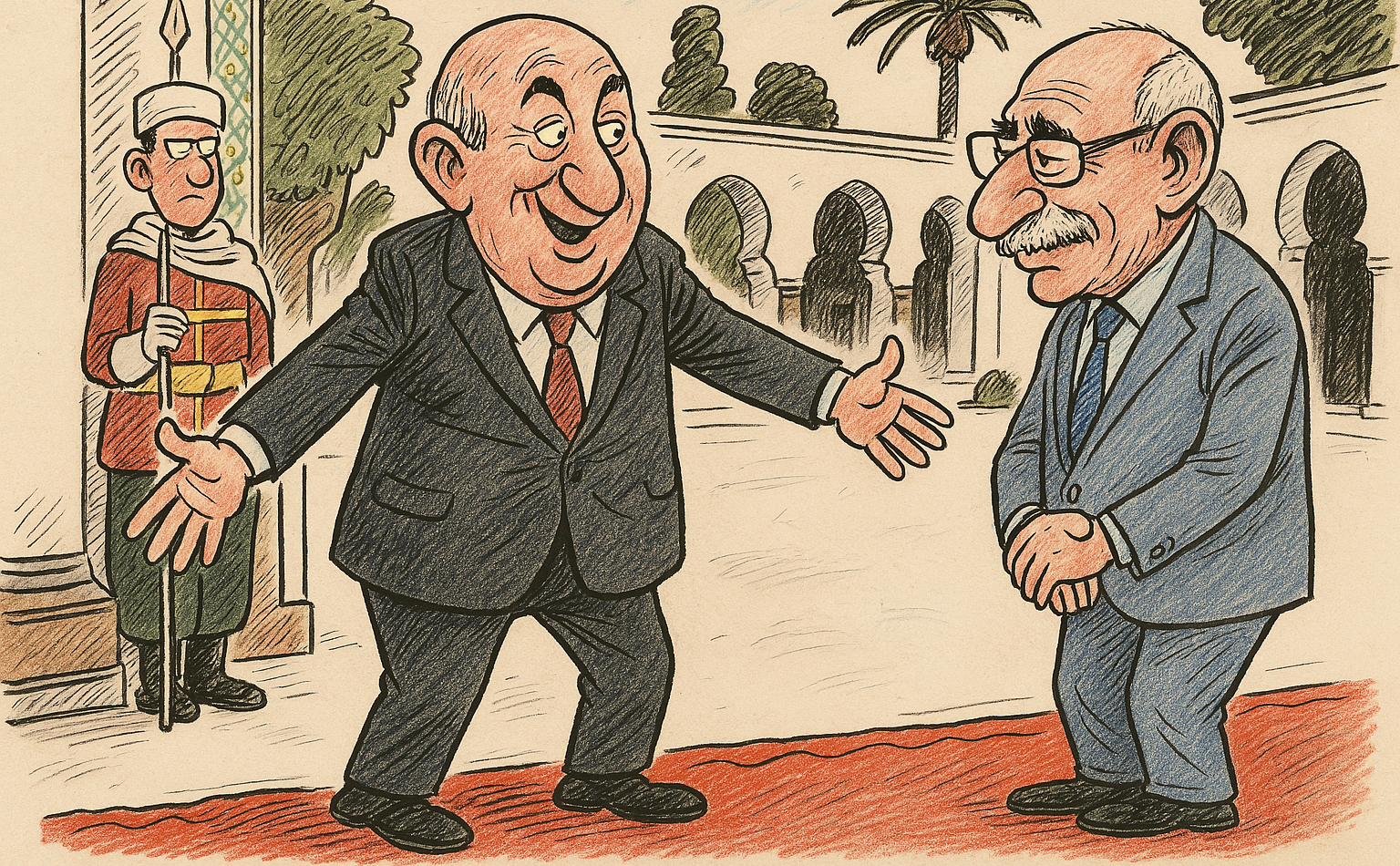







تعليقات الزوار ( 0 )