لقد كاد يُجمع الكل على اعتبار دستور 2011 دستور الحريات والحقوق، بل الكثير منهم يقول بأنه أحدث نقطة فاصلة بين مرحلتين؛ وعليه نجد، في هذا السياق، أن الدستور مكن لمبدأ مهم جدا ذا علاقة بممارسة الحقوق والحريات وهو مبدأ التشاركية؛ حيث باسمه يحق لأي مواطن المشاركة في القرارات منذ بدايتها إلى غاية تنفيذها وتقييمها؛ بل نجد أن المشرع المغربي حاول من خلال عدة قوانين، لاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، التمكين لهذا المبدأ والفصل في طريقة ممارسته؛ رغم وجود ملاحظات بخصوص ذلك إلا أنه لن نسجلها هنا، بل سنحاول أن نرى مدى تطبيقها على أرض الواقع من طرف الفاعل السياسي، وكذلك الفاعل المدني.
لقد نصت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على إحداث آليات مختلفة لتنزيل مبدأ التشاركية؛ لذلك نجد أن أهم هذه الآليات هي: الهيئات الاستشارية، العرائض وعقد لقاءات تشاورية مع العموم والخواص وغيرها؛ بمعنى آخر، فإن كل آلية من هذه الآليات يمكن الالتجاء إليها، غير أن كل طرف قد يؤولها بما يصاحبها من ظروف، حتى إن كانت جلها تسعى إلى تنزيل مبدأ التشاركية وتحقيق الديمقراطية عموما، كما يُنَظّر إليها في الكتب، وحاول المشرع المغربي دسترتها؛ حتى يتضح المعنى أكثر، نورد على سبيل المثال ما يلي:
إن تقديم العرائض حق تم التنصيص عليه، لكن قد يعتبره السياسي حق أريد به باطل، وربما سيفعل المستحيل من أجل عدم تحقيق ما تم المطالبة به حتى لا يقال أنه استسلم لفلان أو علان، وهذا بدوره يتخذ مثل هذه الآليات وسيلة انتقام من الخصوم السياسيين بعدما فشل في حصد الأغلبية في الانتخابات؛ وللتذكير، فإن المنظمات المدنية أصبحت في كثير من الأحيان غير مستقلة، بل صارت تخدم أجندة سياسية بشكل فاضح؛ وربما جاز لنا تسجيل انطباع حول تقديم العرائض، لاسيما في بعض الظروف، على أنها دليل غياب التواصل، لأن من يقود جمع التوقيعات يملك أكثر من قناة تواصل لإقناع المسؤول.
وعلاقة بمبدأ التشاركية، نجد أيضا أن المشرع المغربي أصدر قانونا في غاية الأهمية، وهو حق الحصول على المعلومة، ولو أنه جاء في سياق معين وتحت الضغط، إلا أنه يبقى نصا قانونيا مساعدا في تحقيق مبدأ التشاركية، فضلا عن الهدف الأساسي الذي يتمثل في مشاركة المعلومة مع المواطن؛ وبالتالي، قد يتبادر السؤال: كيف لهذا القانون أن يساعد في تحقيق مبدأ التشاركية كما بدأنا الحديث عليه أعلاه؟
كما يقال: “الحكم عن الشيء فرع عن تصوره”؛ بمعنى أن إصدار حكم ما بخصوص قضية معينة لابد من محاولة الإحاطة بها قدر الإمكان، بل كلما تم إغفال جانب ما صار الحكم الصادر بخصوصها يشوبه النقصان؛ لذلك، حتى يشارك المرء في صناعة قرار صادر من مؤسسة ما لابد له من معرفة كثير من الأشياء، فنجد منها ما هو متاح بشكل دائم ومنها الخفي، لأن ذلك يساعد على أن يكون الرأي المدلى به مبنيا على دلائل مقنعة، وبعيدا عن لغة التمني والأحلام؛ وإلا أصبح مشاركة المرء، بالآراء دون علم، نوعا من الترف السياسي وهدر للزمن.
وعند النظر في حال الآليات التشاركية المعتمدة قانونيا نجد مختلف أنواعها في أمس الحاجة لتوفر المعلومة حتى تحقق الهدف المنشود منها؛ بل إن الواقع يفرض على الجهات المعنية توفير كل المعطيات والوثائق للهيئات التي تشتغل معها في هذا الإطار، مثل الهيئات الاستشارية بأنواعها الثلاثة المتواجدة على مستوى الجهات أو هيئات تكافؤ الفرص التي توجد على مستوى الأقاليم والجماعات، سواء باسم قانون حق الحصول على المعلومة أو بدونه؛ لأن أهم ما يميز الاستشارة كيفما كان نوعها هو اطلاع المستشار على جميع المعطيات وتزويده بكل ما يطلبه إن كان ممكنا؛ وهنا يمكن تذكر المثل القائل: معرفة الداء نصف الدواء.
وبالتالي، فإن حق الحصول على المعلومة يخدم مبدأ التشاركية والديمقراطية عموما؛ إلا أن فلسفة هذا القانون لا يمكن الحديث عن نجاحها إلا بتوفير الظروف المناسبة لها؛ ومن المؤكد أن توفيرها ليس بالأمر السهل في مجتمع سياسي ألف اللعب في الغموض؛ ونحن نعلم أن تسيير المجالس المنتخبة يتم في تغييب معظم أعضائها، بالأحرى من هم خارجها؛ بل إن تشكيلها يكون سرا دون الإعلان عن المبادئ المؤطرة لتحالف مكوناته؛ دون أن ننسى ضعف التواصل الداخلي وغيابه في بعض الحالات؛ لذلك من المنطقي جدا أن لا يتم التواصل مع المواطنين، ومنظمات المجتمع المدني بشكل أخص، إلا في إطار ما يُرى أنه ضروري وغالبا ما يكون تواصلا شكليا.
وفي الجانب المتعلق بالفاعل المدني، نجد تلك الآليات التشاركية لا يستقيم حالها، لأن هناك من القائمين بشأنها من يعتبرها فرصة لإثبات الذات والانتصار لتوجهه السياسي، إن تصفيقا لكل ما يقوم به المسؤول أو معارضة له، بعيدا عن فلسفة التشاور والمشاركة الفعالة في إعداد السياسات وإصدار القرارات؛ ما يجعله في غنى للبحث عن المعلومة أو الالتجاء إلى القانون انتصارا لمبدأ التشاركية؛ وبالتالي، يبقى تفعيل حق الحصول على المعلومة جامدا، لأن هناك ضعف في استيعاب فلسفة مبدأ التشاركية والديمقراطية عموما.
وخلاصة القول: إن ممارسة الفعل السياسي، سواء عن طريق الديمقراطية التمثيلية أو التشاركية، يقتضي امتلاك ثقافة ديمقراطية سليمة، بعيدا عن كل الهواجس التي تداعب مشاعر السياسي تارة، وتجعله يرى في الفاعل المدني منافسا؛ أو في مرات عديدة، نجد أن الطموح السياسي الذي يشوش على الفاعل المدني ولا يرى في تحقيقه إلا المرور عبر الآليات التشاركية؛ وإنما وجب علينا، قبل الحديث عن تفعيل مقتضيات النصوص القانونية أو سن قوانين أخرى جديدة، نشر ثقافة تقبل الآخر، وأن الحياة بدون تعدد وجهات النظر لن تستقيم، وأن الإبداع والرقي يُستبعد تحققه في مجتمع يرى الغير عدوا وجب القضاء عليه وليس جزءا مكملا له.
اللهم ارزقنا المنطق والعمل به.





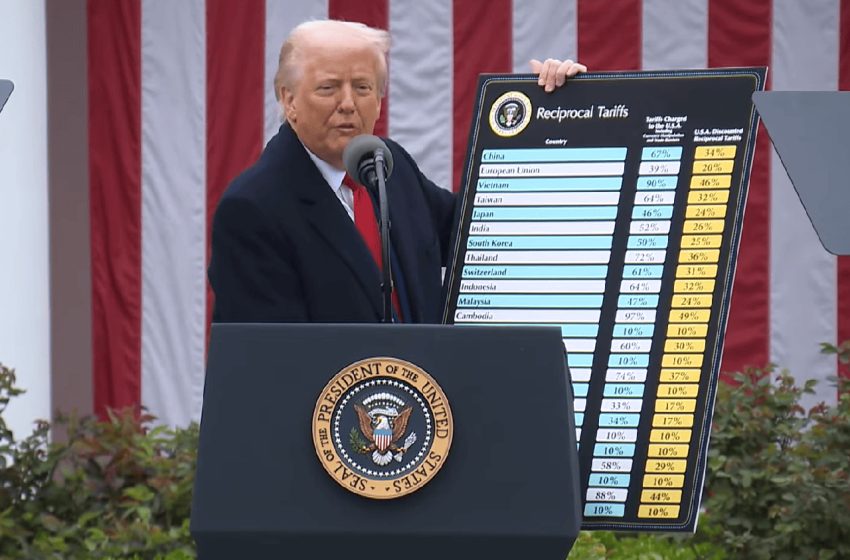









تعليقات الزوار ( 0 )