مكرهين على الانحياز مؤقتا إلى رؤية نرجسية للأشياء، سنشير إلى ظاهرة تنامى الوعي، ولعدة عقود خلت، بتفاقم أعراض التخمة المعرفية في المشهد الثقافي العربي، وهي المتعلقة تحديدا، بتقديس رموز ممثلي الثقافات الغربية، والناطقين بلسان جغرافياتها وأنحائها. ولعل أحد أهم العوامل الأساسية التي ساهمت في استشراء الظاهرة، هوس أغلب المثقفين العرب باستحضار هذه الرموز في معرض كتاباتهم، وسجالاتهم، بدون أن تكون ثمة أي ضرورة منهجية تدعو لذلك. خاصة حينما يتمحور الكلام، حول إشكالات فلسفة الحداثة، وما بعدها، حيث أن كلا من الكاتب والمتحدث، يجدان نفسيهما مجبرين على القيام بجرد واف ومسهب، لمجموع الأسماء، التي كان لها دورها المباشر أو غير المباشر، في نحت المفاهيم، وهيكلة الخطابات.
وهي وضعية/ظاهرة، كرست بشكل مهول مأساوية القصور العقلي، الذي يشكو منه الفكر العربي، إذ أن أقصى ما يمكن أن يطاله من نبوغ، هو اجتراره الآلي لمقولات الآخر، بدون أن يعنى بتأكيد قدرته الذاتية على الاجتهاد، وإعمال الفكر.
وبقوة هذه الوتيرة الرعناء، أمست الرموز ذاتها، بمثابة شبكة متعالية من الأجداد والآباء القسريين، الذين نستمد رضا العالمين من مبايعتنا لهم. وبفعل تجذر تعاليمهم في حياتنا، أمسوا متوجين بتلك الهالة التي تتجاوز هيبتها، هالات الأولياء والقديسين. بهذا المعنى تحديدا، سيكون المثقف العربي قد أقر صاغرا وطائعا، بقابليته المطلقة واللامشروطة لإمحائه الذاتي، إجلالا واعترافا بالسلطة السرمدية، التي تمتلكها الرموز الغربية، سواء في حياته الخاصة أو العامة. ولأن نهاية مطاف التخمة، لن يكون سوى تهديد ضمني، باحتمال حدوث خراب داخلي، له حتما تداعياته الكارثية على راهن ومستقبل ذوات مفكرينا ومبدعينا، فإن الحكمة استدعت منا ولعدة عقود خلت، وجوب وضع الثقة الكاملة في المقومات التنظيرية والمعرفية، التي يحلم المثقف العربي عبثا بتحيينها، والارتقاء بها إلى مستواها الاعتباري، الذي يخول له، حظوة تحمل مسؤولياته الفكرية والحضارية المنوطة به، إقليميا، وكونيا.
وهو الحلم الذي طالما توهمنا أن تحققه، مشروط بتخلصنا الموضوعي من هيمنة الرموز الكونية، ومن تحكمها المتعالي في مرجعياتنا. غير أن هذا الوهم، لم يلبث أن جاهرنا بحقائق لا تحتمل ولو مقدار ذرة واحدة من الشك، بموازاة تأكدنا، على ضوء التجارب الملموسة – أولا – من خبرة المثقف العربي، في توظيف كل الأقنعة الأيديولوجية الملقاة على قارعة الطريق، للتكيف مع انتهازية السياق الذي يتواجد فيه. وثانيا، اقتناعنا القاطع بمعاناته المأساوية من ضراوة الجوع المادي، المتأصل تاريخيا في دواخله. والعاملان معا كافيان لتنشيط ملكاته ومهاراته، في التخطيط للفوز بما طاب وأمكن من ريع الغنائم المخزنية، خاصة منها، تلك التي يخطئ السذج والمغلوبون على أمرهم طريقهم إليها، حيث يمكن القول، بأن تظاهره في غير قليل من المواقف بالانتصار للمقولات والمنظومات المستقبلية، ليس في واقع الأمر، سوى مرحلة تمويهية، من مراحل بناء هوية، سيتضح لاحقا أنها ليست في واقع الأمر، سوى التجسيد الفعلي لحالة مرضية من الجشع الشخصي، والهوس الهستيري، الهادف إلى مراكمة ما أمكن من الامتيازات، تحت غطاء تبريرات ممعنة في الخسة، والمكر والدهاء.
إن المتتبع بهذا المعنى، سيجد نفسه أمام حالة مزمنة من الإحباط، ومن خيبة الأمل، التي ستجتاحه، بفعل وجوده القدري بين مخلوقات هجينة، غير مؤهلة للقيام بأي دور ثقافي أو مجتمعي، كفيل بدمجها في صيرورة الزمن التاريخي. إن الأمر يتعلق هنا بنماذج منحطة ثقافيا، ومن عينات قزمة، ترابط سرا وجهارا عند عتبات سلاطين الطوائف، في انتظار أن يجودوا عليها بسقط الهبات. أما خارج الامتيازات الذاتية والمآرب الشخصية، فما من خلل سياسي، فكري، أو مجتمعي يدعو للغضب، أو الإدانة، أو إلى مجرد التلويح باحتجاج نقدي أو تبرم أخلاقي. فثمة تواطؤ ضمني، مشترك وشامل، بين جميع الأطراف الوصية والمعنية، من أجل تعميم حالة مريبة من التهدئة. وأيضا، من أجل تفادي السير باتجاه الخطوط الحمراء. هناك، حيث تتربص أنياب السلطات الرسمية بخطوات المتهورين.
هكذا وفي ظل هذا الواقع البائس، ستتعدد مشاتل النهب وتتنوع، بتعدد وتنوع التطلعات الهيمنية، وطبعا، في غياب تام لأي إطار محتمل، يراعى فيه شرط ما يندرج عادة، ضمن سياق المصلحة العامة، أو هاجس تكريس القيم الإنسانية والحضارية، التي طالما قدمت الإنسانية شعوبا كاملة قرابين على مذابحها.
والخلاصة، ممارسات ثقافية غامضة ومريبة، تمتد من الماء إلى الماء، ومن المال إلى المال. يدير دواليب مؤسساتها السرية وسطاء محترفون، ودهاة مختصون في فقه تصنيع وتسويق الأباطيل، خلال مواسم كرنفالية، يتم الاحتفاء فيها بما جد من مسوخ. داخل طقس يراد له أن يكون طهرانيا، ورصينا ومنزها عن شوائب الشبهات، التي تخفق أعلامها بخبث خباياها.
هذا الطقس الموبوء الذي أصبح جد مألوف، ستقوم بتفجيره شرارة الاعتذار، التي طوح بها مؤخرا الفيلسوف الألماني يورغن هابرماس في ظلمة واقعنا الثقافي. اعتذار، جاء بصيغة رصاصة الرحمة في دماغ الجثة، إذ خلسة، وبدون سابق إنذار، انقلب السحر على ساحر المؤسسة الخليجية، حيث كان يتوهم – إلى حين – أن توريطه للفيلسوف في الفوز بالجائزة، سيؤدي إلى مضاعفة أسهم لشركته المعنية، بما يجعلها أكثر أهمية حتى من مؤسسة نوبل. بدون أن يتبادر لذهن الساحر ذاته، أن الفيلسوف التسعيني، كان بأمس الحاجة إلى هذا التتويج المضاد، الذي يليق بمسار من العيار الكوني الثقيل، الحافل بالعطاءات والسجالات.
والغريب في الأمر، أنه تتويج سيتحقق على رقعة خليجية، لم تكن أبدا طرفا في أي معادلة من معادلاته التنظيرية. علما بأن اعتذاره المنظم باحترافية حداثية، جد عالية، يتجاوز من حيث فعاليته التواصلية، مئات عرائض الإدانة في الموضوع ذاته، التي قد تضم أرتالا لا حصر ولا عد لها، من توقيعات أشقائنا في الفكر والإبداع، بدون أن يكون لها ولو ثقل جناح بعوضة بائسة، مقارنة بوزن الموقف التصحيحي – والله أعلم – الذي صدر عن عراب الحداثة الكونية هابرماس، الذي يحتاج فهمه واستيعابه – هو أيضا- إلى ترسانة من المفاهيم التأويلية، على قاعدة تساؤل غير بريء تماما. ما دام حسن النية المبالغ فيه، والسذاجة الممعنة في طيبوبتها، عملة فاسدة في أزمنة الحداثة وما بعدها، تلك التي يعيش المثقف العربي خارجها، شاء أم أبى.
وينتابنا في هذا السياق حنين أخرق لسنوات السبعينيات، المتعارف عليه مغربيا، بسنوات الجمر والرصاص، حين لم يكن في متناولنا بديل آخر لمواجهة الطغاة، سوى الاستجابة لنداء مقالاتنا الحارقة، التي تعاملنا معها آنذاك، بوصفها أداتنا الأثيرة لمطاردة لصوص السياسة، ولصوص الإبداع. أتذكر الآن، وبعد مرور كل هذه العقود، إلى أي مدى كانت تلك الكتابات ضرورية، للفصل جذريا بين طوابير القتلة، والدائرين في فلكهم، من مأجوري السياسة، ومرتزقة الإنشاءات التحريفية، ومعسكر الشرفاء، الذين أوقفوا حياتهم على مبدأ الانتصار لقيم الحرية والعدالة والجمال. وما أعنيه بالفصل هنا، ليس في واقع الأمر، سوى شعارات الطرد المهين الذي تعودنا على إنزاله بأعداء الحياة، عبر كيهم رمزيا، حتى لا تخطئهم العين، كلما ساورتهم فكرة التسلل إلى فضاءات القيم الحداثية، التي كانت منذورة لأنوارها المستقبلية. طبعا كان ذلك، قبل أن تصبح هذه الكتابات تدريجيا، موضوع سخرية من قبل الجميع، بعد تتالي انهيار كل شيء.
لذلك، ليس لنا الآن، سوى الاستمرار في تقديم ولاءاتنا لرواد الحداثة الكونية. على الأقل، بصفتهم فزاعات ردعية، جاهزة لكبح جماح الساهرين على إبقائنا تحت رحمة أزمنة الحجر ودياجير التيئيس.



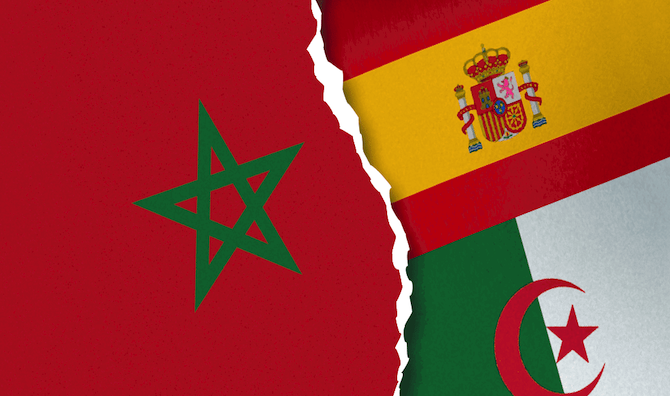











تعليقات الزوار ( 0 )