تحتاج تطورات الوضع في تونس أن تقرأ من منظار آخر غير منظار الديناميات السياسية وصراع التحالفات وإلى ماذا يمكن أن تفضي؟
فتونس منذ مدة، تعيش وضعية هشاشة ديمقراطية، كانت كلما جاءت أزمة تكشفها تضطر إلى أن تلتف القوى السياسية عليها، وتخرج مقولة «الوفاق السياسي» من أجل أن تثبت نجاح التجربة الديمقراطية وتجدرها واستثنائيتها في المنطقة وقدرتها على الخروج من الأزمات، وأن هذه الأزمات ما هي في المحصلة سوى صعوبات الانتقال الديمقراطي التي عاشتها كل التجارب الديمقراطية!
لا نريد أن نحصي عدد الحكومات التي مرت بتونس منذ ربيع الثورة، ولا نريد أن نحصي أيضا عدد الأزمات التي نشأت، فهناك أكثر من إيديولوجية تفسيرية، بعضها يستمسك بمحدد القوى المضادة للثورة، وبعضها الآخر يتمسك بمحدد حداثة التجربة وطبيعة الانتقالات إلى الديمقراطية، وبعضها الآخر يستند إلى مقولة ثمن الديمقراطية وضرورة تحمل زلازلها كما نجاحاتها.
والحقيقة أن المشكلة هي أعمق بكثير من مثل هذه التوصيفات الإيديولوجية التي تحاول أن تلتف على جوهر الأزمة وتغطي عليها، فثمة حالة فرز مجتمعي حاد نشأ منذ التجربة البورقيبية، وتعزز في مرحلة الجنرال بن علي، ولم تستطع الثورة وجيلها أن يعالجه بما يتطلبه الأمر من بعد ثقافي يعتبر من لوازم الثورة.
المعطيات التفصيلية تشير إلى نشوب خلاف داخل التحالف حول مسلكيات رئيس الحكومة، ونضج الموقف لدى حركة النهضة بضرورة استقالته أو إعفائه بسبب التداخل بين الحكومي والمصالحي في سلوك هذا الرئيس. لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فثمة سوء فهم بين الرئيس وبين رئيس البرلمان، يجعل بعض التعبيرات النهضوية تنسبه إلى القوى المضادة أو على الأقل ترقب تحولات موقفه، وتتخوف من أن يسقط في أجندة الخارج، فيعمد إلى إفساد ديمقراطية تونس، وفي الجهة المقابلة، ثمة أحزاب سياسية، لم تعد تقبل الوضع الديمقراطي في تونس، فبدأت تستعين ببعض ألوان البلطجة السياسية لتغييره، فيما النخب الأخرى تائهة في بحر التحالفات، تحاول أن تبحث عن موقعها داخل تحالف حكومي قادم. الحل الدستوري هو ما يجري اليوم على الأرض، فالرئيس التونسي دعا الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها بشأن رئيس الحكومة، وهي معنية بنسج تحالفات، وربما تقديم مرشح مشترك أو التوافق على شخصية وطنية اقتصادية حتى تثبت قدرتها على تشكيل الحكومة.
في الظاهر، كما في السابق، يبدو الحل الدستوري هو ما يعبر عن جوهر الديمقراطية التونسية، أي أنه يعبئ مكنة الأحزاب وقابليتها للتوافق، ويتم إنهاء الأزمة عبر هذه الآلية، فيظهر الوفاق بما يعنيه من تنازلات مؤلمة كصمام أمان للتجربة الديمقرطية، لكن في الجوهر، ما يعبر عن الواقع، هو المحاصصة الحزبية، وشكل اقتسام مقاعد الحكومة، وما ترمز له من رغبة كل حزب في أن ينعكس وزنه الانتخابي على حقائبه الوزارية، والتنازلات التي قد تقع، والتي تنسب للوفاق الوطني، هي في الواقع ثمن تشكيل الحكومة وكلفتها لا ثمن ترسيخ النموذج الديمقراطي في تونس.
الخارج حاضر بقوة، ولا يمكن استبعاده، فثمة محاور إقليمية تتصيد الفرصة، وتريد أن تحقق معلناتها بإزاحة الإسلاميين من أي تجربة حكومية، وهي تستفيد من تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، وترى أن هذه الأزمة تسمح لها بموطئ قدم في تدبير الصراع السياسي في تونس. لكن، في المقابل، ثمة حساسية شديدة من التدخل الخارجي لاسيما في صناعة الخارطة السياسية في تونس، ولا أحد من الأطراف ولا المؤسسات، يريد أن تكتب عليه هذه الخطيئة، وما يلاحظ من نزوع بعض القوى الحزبية إلى لعب الأطفال في حقل سياسي مأزوم، يعبر عن حدود تدخل الخارج، وأنه لم يتجاوز الرهان على بعض الشخصيات وربما بعض القوى السياسية المحدودة الأثر دون أن يصل إلى المؤسسات.
ولذلك، بعيدا عن حظوظ الإيديولوجيا في التحليل والتفسير، ثمة معضلة تحتاج إلى حل في تونس، فالعملية لم تنته بتأسيس قواعد الديمقرطية، ولا بإجراء العملية الانتخابية واحترام نتائجها وتحقيق مترتباتها، فهذه القضايا تم الحسم فيها، وأعطت إشعاعا عربيا ودوليا، ولكنها لم تخرج تونس من الأزمة، سواء في بعدها السياسي، ولا حتى في بعدها الاقتصادي، فلم تعرف تونس استقرارا حكوميا طويل المدى يسمح للحكومة بالتفرغ للمشكلات، ومحاولة معالجتها بشكل فوري، بنحو يضمن التوازنات المالية والاقتصادية لهذا البلد ويضعه في قاطرة التنمية، كما أن مؤشراته المالية والاقتصادية، تعرف تراجعا مخيفا يوشك أن يضع تونس في مربعات عدم الاستقرار الاقتصادي، مما يجعلها تفقد الرساميل الأجنبية.
المشكلة توجد في الثقافة المجتمعية، التي لم تؤسس للقبول بالآخر والتعايش معه، والقبول بالتداول السلمي على السلطة، فالثورة حينما نجحت في تونس، اهتمت بكل شروط الانتقال الديمقراطي ذات الطابع السياسي، لكنها افتقدت للروح الثقافية الصاهرة لمكونات المجتمع لخدمة قوة وتقدم تونس.
تقديري أن غياب هذه الروح الثقافية يرجع بالأساس إلى ضعف الكاريزمات السياسية في تونس، القادرة على إنتاج الخطاب السياسي الجماهيري، الذي يؤهلها لتغيير عقليات المجتمع وعقليات النخب.
المجتمع في تونس لا يزال يشعر بأن الثورة تجعله أقوى من الدولة، وأنه يستطيع أن يفعل ما يريد، لأن الدولة ما هي في الحقيقة سوى آلة من الآليات التي جاءت بها الثورة، وما الثورة إلا تطلعات المجتمع، ولهذا السبب، فشلت لحد الآن الدولة في تونس، لأنها لم تفعل ما ينبغي لقيامها وقوتها وهيبتها، وإنما فعلت ما تريده شرائح المجتمع تحت طائلة الضغط الشعبي، وذلك بسبب أن الدولة والنخب انصرفت إلى ما هو سياسي، وألغت في الحساب ما هو ثقافي، أي ما يراهن على إعادة تشكيل عقل الموطن، و صياغة السياسة ومعناها، والشكل الذي يتفاعل به المواطن مع السياسة.
ولذلك، يمكن أن تخرج تونس من أزمتها الحالية، لكن ليس مضمونا بالمرة أن تستقر التشكيلة الحكومية، ففي أي لحظة يمكن أن تندلع أزمة حكومية جديدة، وسيتم عندها التداعي للحل الدستوري، فتضيع تونس شهورا بدون استقرار حكومي وسياسي، وتضيع معها نقط مهمة في عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية، ولا تستطيع بذلك أن تهيئ الأرضية السياسية الصلبة التي تضمن قوة الدولة وتوازنها المالي، ولا أن تهيئ شروط الاستقرار الاقتصادي، وتجلب بذلك الرساميل الأجنبية، وتحيي الأمل في انتعاشة اقتصادية واعدة.


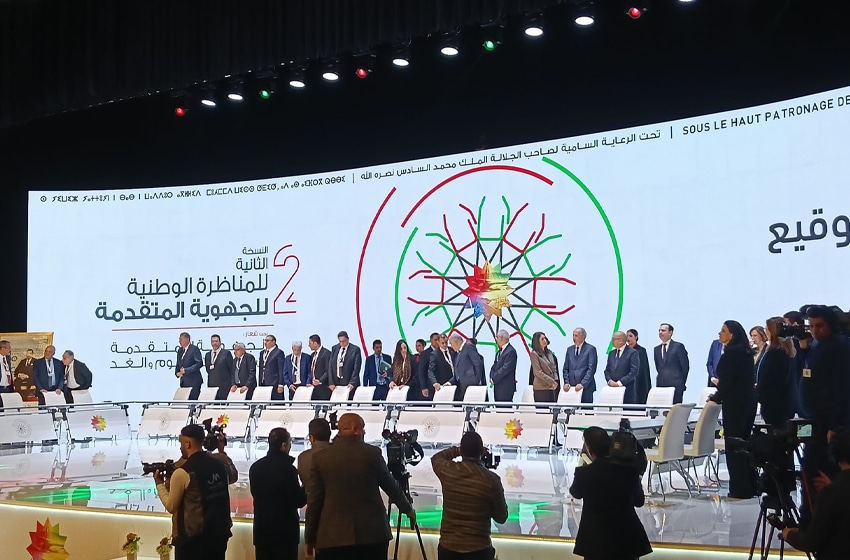












تعليقات الزوار ( 0 )