د. ياسمينة أبو الزهور*
في 26 دجنبر 2019، اعتقلت الشرطة المغربية الصحافي عمر الراضي بعد توجيه الاتّهام له. وأمضى الراضي ستة أيام في السجن قبل الإفراج عنه بكفالة. وحُدّد تاريخ محاكمته في 5 مارس 2020. وما هو الجرم الذي اقترفه بحسب السلطات؟ لقد غرّد منذ ستة أشهر منتقداً قاضياً منخرطاً في محاكمات الناشطين في حراك الريف.
وهذا السبب الرسمي محيّرٌ نظراً إلى توقيت توقيف الراضي. في الواقع، من الممكن أنّ اعتقال الراضي سببه ليس الزعم بأنّه “أهان قاضياً” قبل ستة أشهر، بل مقابلة أجراها مع قناة إذاعية جزائرية في 23 ديسمبر مناقشاً فيها مسألة استملاك النظام المغربي الأراضي التابعة للقبائل.
لقد أظهر النظام أسلوباً نمطياً بقمع الناشطين عبر الإجراءات القضائية، عن طريق تلفيق تهم كاذبة أحياناً. فبالفعل، سيق ناشطون مشهورون يعتبرهم النظام معارضين، مثل الراضي والصحافية هاجر الريسوني ومغنّي الراب الكناوي، إلى المحكمة لمسائل لا صلة لها، مثل إجهاض افتراضي في قضية الريسوني أو فيديو زُعم بأنّه يُحرّض على العنف ضدّ الشرطة في قضية الكناوي.
في الواقع، لم يكن الراضي المغربي الوحيد الذي يواجه ملاحقة قضائية بسبب حرّية التعبير في 26 دجنبر 2019. ففي اليوم ذاته، حُكم على الناشط على موقع يوتيوب محمد السكاكي (المعروف بلقب مول الكاسكيطة) بالسجن لمدة أربع سنوات وبدفع غرامة 40 ألف درهم (أي قرابة أربعة آلاف دولار أمريكي)، وذلك بتهمة “إهانة الملك” في عدة فيديوهات على يوتيوب. وفي قضية مماثلة، أُلقي القبض على محمد بن بودوح (المعروف بلقب مول الحانوت) في وقت سابق من ديسمبر في مدينة تيفلت لانتقاده الملك على وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يزال مكانه مجهولاً.
وفي نفس الأسبوع الذي اعتُقل فيه الراضي وحُكم على السكاكي، امتثل عبد العالي باحماد، وهو شاب عاطل عن العمل وعضو سابق في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، أمام القضاء في 23 ديسمبر بسبب “إهانة علم البلاد ورموزها” و”انتهاك سلامتها الإقليمية” على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اعتُقل في السابق باحماد، الذي شارك في الكثير من الاحتجاجات في مدينتَي الحسيمة وجرادة، بسبب عمله الناشطي السياسي.
وواجه الناشطون والصحافيون الذين انتقدوا النظام قمعاً متزايداً منذ انتفاضات العام 2011، غير أنهم ليسوا الوحيدين الذين استهدفهم هذا النوع من القمع. فبشكل بارز، تمّت مواجهة احتجاجات حراك الريف، التي سرّعها مقتل محسن فكري وأطلقت شرارتها الصعوبات الاقتصادية والتباين الاجتماعي والفساد الحكومي، بقمع قاسٍ. فحُكم على مُنظّمي الاحتجاجات بالسجن لمدة 20 عاماً، وطَلب عدّة محتجين من حراك الريف من الفئة المتوسطة اللجوء في أوروبا بعد تلقّيهم استدعاءات للمثول أمام المحكمة. وفيما علّق عفو ملكي الكثير من العقوبات بحقّ المشاركين في حراك الريف، يقبع ناشطون بارزون في السجن.
ولا يستهدف قمع النظام للأصوات المنتقدة عبر القضاء الناشطينَ فحسب بل الشباب غير المُسيّسين أيضاً. فعلى سبيل المثال، حُكم على طالب في المدرسة في الثامنة عشرة من عمره في مدينة مكناس في 19 دجنبر بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب نشره عبر فيسبوك منشوراً مستعيناً بكلمات الأغنية المثيرة للجدل “عاش الشعب”.
ويمضي الكناوي بذاته، أحد مغنّي الراب الذين ألّفوا كلمات الأغنية وأدّوها، عقوبة في السجن لمدة عام واحد نتيجة إهانته المزعومة للشرطة في فيديو نُشر في شهر أكتوبر. غير أنّ محاميه يصرّ أنّ الإجراءات القانونية التي تستهدف وكيله سببها هذه الأغنية.
وأُلقي القبض على طالب آخر في الثامنة عشرة من عمره قرب مدينة العيون في 29 دجنبر لنشره أغنية راب عبر يوتيوب تنتقد وضع المملكة الاقتصادي الاجتماعي وتصف النظام بأنه “دكتاتوري”. وقد أصدرت المحكمة قراراً بسجنه لمدة أربع سنوات في 31 دجنبر 2019.
وليست ممارسة إسكات الأصوات المنفلتة من خلال الإجراءات القانونية بظاهرة حديثة. ففي 17 أكتوبر 2018، حُكم على المقاول سفيان النكاد بالسجن لمدة سنتين وبدفع غرامة قدرها 20 ألف درهم (حوالي ألفَي دولار أمريكي) بتهمة “التحريض على العنف العام” و”إهانة علم البلاد ورموزها” و”نشر الكره”. فقد نشر النكاد منشوراً عبر فيسبوك دعا فيه الشعب إلى الاحتجاج بعد أن أطلقت البحرية المغربية النار على زورق ينقل مهاجرين في 25 شتنبر 2018، مما أدّى إلى مقتل ابنة العشرين عاماً حياة بلقاسم.
وفي 4 غشت من السنة السابقة، اعتُقل المدوّن محمد تغرى في مدينة أولاد تايمة وحُكم عليه بالسجن لمدة عشرة أشهر بسبب “التشهير الجنائي”. أما الشخص الذي صوّر التقرير واسمه بدر الدين سكوات، فقد نال عقوبة بالسجن لمدة أربعة أشهر. وخفّضت لاحقاً مدة عقوبة تغرى لتصل إلى أربعة أشهر فيما عُلّقت عقوبة سكوات.
أكذوبة الاستثناء المغربي
قد يأتي نمط القمع القضائي لدى النظام المغربي كمفاجأة بالنسبة إلى المراقبين الخارجيين الذين أشادوا بردّ فعل النظام إزاء انتفاضات العام 2011 وما أطلق عليه بعضهم تسمية “الاستثناء المغربي”. وتشير هذه التسمية إلى أنّ المملكة قد احتوت بنجاح الانتفاضة من خلال التصرّف بطريقة استثنائية عبر اللجوء إلى إصلاحات وقائية وبسبب شرعية متأصلة (قبلية أو دينية أو تاريخية). وفيما كان المغرب منخرطاً مع الأنظمة الملكية العربية الأخرى في تغطية “الانقسام الملكي-الجمهوري” للانتفاضات، يرتبط التبرير الأشيع المُستخدم لتفسير صمود النظام المغربي بما عُرف بسلوكها الإصلاحي. ويغضّ هذا التبرير النظر عن تقارير العنف ضدّ ناشطي 20 فبراير وحركة الاحتجاج الأوسع ويركّز على التغيرات الإيجابية التي أُدخلت في النص الدستوري في العام 2011.
لكن بعد مرور قرابة عشر سنوات على انتفاضات العام 2011، دُحض هذا التبرير جرّاء (1) غياب التغيير الحقيقي في النظام السياسي و(2) المضايقات القضائية المتكرّرة للسلطات بحقّ الناشطين و(3) قمع النظام المستمرّ للمحتجين في مدينتَي الحسيمة وجرادة ومدن أخرى و(4) قمع الشرطة القاسي للاحتجاجات المنتشرة في المراكز المدنية.
النظرة المستقبلية: وداعاً يا حقوق الإنسان!
قد يُحكم على الراضي بالسجن، وفي هذه الحال قد ينال عفواً أو تُسقط التهم ضدّه بسبب ردّ الفعل الشعبي القوي نتيجة توجيه الاتهام له بشكلٍ ظالم. لكن بعيداً عن هذه القضية الفردية، يدعو انحلال حقوق الإنسان في المغرب إلى القلق.
فمع عدم اكتراث النظام المغربي بمنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية، لن يكون للنظام أي دافع لوقف قمع المحتجّين والناشطين مع استمرار الأزمة الاجتماعية الاقتصادية التي آلت إلى الاضطراب الشعبي. بالفعل، بحسب البنك الدولي، ربع المواطنين المغربيين فقير أو عرضة ليصبح فقيراً، والهوة بين الطبقتَين الاجتماعية الاقتصادية العليا والدنيا واسعة. ويساوي معامل الجيني (أي مؤشر التفاوت) في المغرب 40,9 في المئة، مما يعني أنّه لم يتحسّن منذ العام 1999. وهذا المعدل هو الأعلى في شمال أفريقيا، باستثناء ليبيا التي تتخبّط في نيران حرب أهلية.
ويأتي المغرب أيضاً في درجة أدنى من الدول المجاورة له في ما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيّما في ما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والحصول على الكهرباء والمياه النظيفة. علاوة على ذلك، يعاني المغرب ارتفاعاً في معدلات بطالة الشباب، التي وصلت إلى 22 في المئة على المستوى الوطني و43 في المئة في المناطق المدنية في العام 2017.
وستحفّز هذه المشاكل الاجتماعية الاقتصادية القائمة المزيد من الاضطراب، الأمر الذي يولّد تهديداً للنظام. وسيؤدّي على الأرجح هذا التهديد، المقرون بجهاز تنفيذي غير شفاف وثِقة ضعيفة من الشعب تجاه الحكومة والأحزاب السياسية، إلى قمع غير منظّم. لكن من المستبعد أن يضع القمع المتزايد حدّاً للاحتجاجات التي من المحتّم أن تتضاعف مع استمرار التفاوت الاجتماعي. ولن يُسهم أيّ قمع إضافي إلا في تزايد خيبة أمل الشعب الكامنة.
وسيشكّل العمل حقاً على التحرير خطوة ذكية من ناحية النظام، في وقت يعاني فيه للعثور على خطة إنمائية تستهدف بفعالية التفاوتات الإقليمية والديمغرافية. فقد يؤدّي فتح المجال السياسي وتمكين الجهاز التشريعي وتعزيز الحقوق السياسية والمدنية وحمايتها إلى التخفيف كثيراً من استياء الشعب من ديناميات المغرب السياسية. لكن من المستبعد أن يتّخذ النظام هذا المسار نظراً إلى قمعه مؤخراً للمحتجين والناشطين. بدلاً من ذلك، فيما يحرّض الوضع الاجتماعي الاقتصادي إلى المزيد من الاستياء، من المرجّح أن يستمرّ النظام باستهداف الناشطين والمحتجين عن طريق المحاكمات والمراقبة المتزايدة.
ففي النهاية، لقد مرّت عشر سنوات على انتهاء الربيع العربي، ومرّت معها الفوضى في أنحاء المنطقة والتي دفعت في السابق بالنظام إلى الوعد بإحداث تغيير حقيقي.
وفي العام 2020، لن يجد النظام على الأرجح سبباً ليبدأ بالإصلاحات التي قد تفتح المجال السياسي وربما تخفّف من سلطات النظام.
في الواقع، من المرجّح أكثر أن يعزّز النظام نمطه القمعي للحفاظ على الوضع الراهن على حساب حقوق الإنسان.
*باحثة في المعهد المغربي لتحليل السياسات وباحثة زائرة في مركز بروكنجز الدوحة بقطر







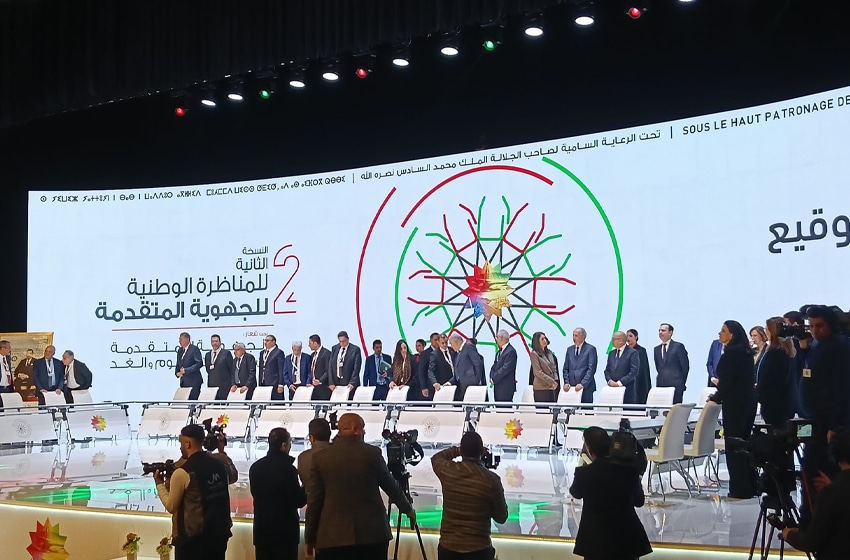







تعليقات الزوار ( 0 )