“حلمت ذات يوم بأن أصير مخترعاً كبيراً يذيع صيته في كل البلاد”، كلام جاء على لسان عبد الله، البالغ من العمر 26 سنة، والذي يشتغل حاليا ميكانيكيّاً ضواحي الناظور، مع أحد الأشخاص، منّى النفس بأن يكون عالماً يصنع أجهزة إلكترونية فريدةً، فقد كان مهووساً بالآلات في صغره.
قال عبد الله، إنه يرفض أن يلقي باللوم على غيره، ولكن “الواقع مرّ، ومهمَا قلت، أنكرت أو تغاضيت، إلا أن الحقيقة هي أن الفقر ينهي كل الأحلام، فكيف لطفل نشأ وسط عائلة بالكاد تجد ما تأكله في يومها، أن يفكر في تحقيق شيء غير توفير قوت اليوم؟”.
لا يمكن حسب عبد الله، لشخص يفكر في الأكل، أن يستطيع الإبداع، أو تنمية مواهبه، أو حتى الدراسة، والحالات التي تمكنت من الاستمرار رغم الظروف، نادرةٌ جدّاً، “الفوارق الاجتماعية لا تضع الجميع أمام فرص متكافئة، هناك من توفر له كل شيء، من الكماليات، وهناك من لم يتمكن حتى من اقتناء الضروريات”.
من جانبه، أعرب سعيد، الذي ساعفه الحظ، وتمكن من الدراسة وعثر على وظيفة، إلى جانب أنه مسجّل في الدكتورة، عن أسفه للواقع، بالرغم من نجاته، إلا أنه متحسر على ضياع مواهب في عدة مجالاتٍ، كان بإمكانها تقديم الإضافة النوعية لسوق الشغل وللبلادِ عموما، مسترسلا:”بين 40 تلميذا في الابتدائي، كنت الوحيد منهم الذي وصل للمرحلة الجامعية”.
ونبه سعيد إلى أنه لم يكن في قرية نائية ولا في بادية بعيدة، ولكنه عاش قريباً من مدينة الحسيمة، ولكنه “العامل الأساسي الذي حال دون تمكن باقي الزملاء من الاستمرار في الدراسة، كان الفقرَ، لأن حوالي 4 أشخاص ودعوا المدرسة في الابتدائي، من أصل 40، قبل أن يتبعهم حوالي 10 في المرحلة الإعدادية، وفي التأهيلي رحلَ 25، 10 منهم ركبوا قوارب الموت”.
“كنت أدرس، وأذكر أنه سألني أستاذي ذات يوم، عن هدفي من التعّلم، أخبرته بأني أتمنى أن أكون طبيباً”، يقول شابٌ لم يلبغ الـ 18 عاما من عمره، وهو يحمل فأساً، يضرب به الأرض، يحفر أساساً في ورشة بناءٍ.
ملامح علي توحي بأنه فقير، يكاد يكون عمله اليومي مخصّصاً لتوفير المأكل والمشرب للأسرة فقط، يرتدي ملابساً ممزقة من تحت الإبط، شعره أسود تحوّل لبنيّ بسبب الغبار، لا تُغيّبُ الابتسامة عن وجهه، سوى أشعة الشمس القوية، التي يجبر معها على خفض رأسه.
اسمه علي، هكذا قال، كان المستوى السادس من التعليم الابتدائي، آخر مراحله في المدرسة، بعد أن أُجبر على المغادرةِ. ينظر للسماء، فجأة، وكأنه يشكو حاله لها، يدير وجهه صوب زميله في العمل، يخبره بأن “دنيا هي هادي”، قبل أن يسترسل:”ملي كنت فالسادسة، مات الوالد ديالي، وكان ضروري نخرج باش نخدم، وداكشي لي كان”، لم يطل في الكلام ليعود لعمله من جديد.
بعد لإنهائه لأشغال اليوم، وبالرغم من تعبه، أعرب علي لـ”بناصا”، بأن “كاع كنا صغار وكنحلموا نكبروا، نتوظفوا، ونديروا لاباس، ونخدموا على والدينا، ونعيشوا مزيانين، ولكن الله غالب، الأحلام كيموتوا فالواقع، كون مخدمتش الواليدة غادي تخرج تخدم، وفين تخدم؟ معندها لا ديبلوم لا شهادة لا والو؟ فديور ناس؟ لا، ما دمت حي أنا نخدم عليها”.
القرى النائية في المغرب، شبيهة بمقبرةٍ للأحلام، تكاد وأنت تدخلها، وتمر بين شجيراتها، ومنازلها الترابية المهترئة، أن تسمع أصوات بكاء الطموحات التي لم تتحقق، سكانها حين يشاهدون زائراً من المدينة، يفرحون، ليس لأنه قد يجلب معه شيئا يمنحهم إياه، ولكن لأنهم يرون فيه حلماً تحقّق، مستقبلاً صار واقعاً، يمنحهم شحنةَ أملٍ مؤقتةً.
حسن، شاب ينحدر من قرية صغيرة في جبال الريف، ضواحي جماعة زرقت، يبلغ من العمر عشرين سنةً، رؤيته لا توحي أبداً بأنه في هذا السّن، يبدو في الثلاثينيات، وجهه بدأ يتجعد، يداه تضخمتا من عمله المستمر في الفلاحة والرعي، يحكي لـ”بناصا”، بأن والده أدخله إلى المدرسة فقط لكي يتمكن من القراءة والكتابة، ومباشرة بعد إتقانها أخرجه منها ليعمل.
يروي حسن، بأن رؤية شخص قادم من المدينة إلى قريتنا الصغيرة، بمثابة يوم عيد بالنسبة لنا، “ماشي حيت كيدور معانا، ولكن إحساس ميمكنش نصوفو ليك، كنشوفوا بلي جاي من بلاصة مزيانة علينا، وهو أفضل منا، كنشوفوه حلم تحقق، وكنتمناو نحققوه حتى حنا”.



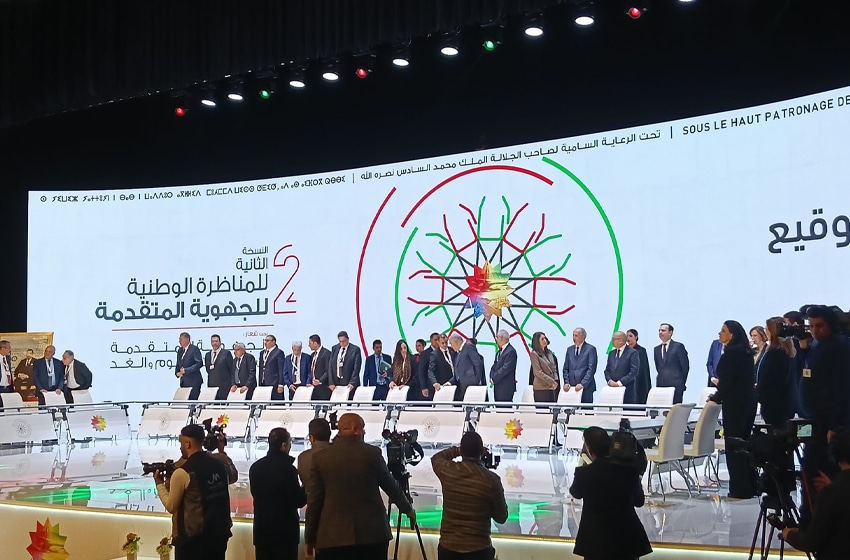











تعليقات الزوار ( 0 )