تحدّثت في مقال سابق عن سبب الأزمة التاريخية التي قادت إلى ما سميته غرق سفينة العرب، وتهافت مواقعهم في مقابل صعود القوى الإقليمية والدولية الأخرى. وقلت إنه نابع من إخفاقهم في إنجاز الثورات الثلاث التي كانت تنتظرهم للخروج من الهامشية والتبعية والتخلف والدخول في دورة الحضارة والمدنية الحديثة: الثورة الصناعية المنتجة للثروة وفرص العمل، والثورة السياسية البانية لدولة أمة على أنقاض الطائفة والعشيرة، والثورة العلمية والتقنية التي هي اليوم المحرّك والمحفز للتقدم المادي والأخلاقي معا.
وفي مركز هذه الإخفاقات الثلاثة، تكمن، في نظري، خسارة مشروع الدولة التي كانت، في جميع الحقب وبقاع الأرض، الأداة أو بالأحرى المؤسسة الأرقى والأبرز في تنظيم شؤون الجماعات وقيادتها في صراعاتها التاريخية. لماذا لم ينجح العرب في بناء دولة، ولا أقول دولة ديمقراطية؟ فحتى الديكتاتوريات كان لها دور كبير في تطوير مجتمعاتٍ مرّت بأوضاع أسوأ من أوضاع المجتمعات العربية، وشهدت ديكتاتورياتٍ دمويةً، مثل الصين وإسبانيا الفرنكية وألمانيا في المرحلة النازية وإيطاليا الفاشية وأغلب الدول قبل الحرب العالمية الثانية.
لوجود الدولة استقلال نسبي عن النظم السياسية والثقافية والاقتصادية، ويستند غالبا إلى تجربة تاريخية عميقة وممتدة الجذور، قد تخبو وتعود، ولها مواطن تميزت بحضورها القوي منذ القدم، في حين بقيت في مواطن أخرى هشّة وقابلة للانتكاس، كما هو الحال في معظم المناطق التي يغطيها اليوم العالم العربي. ولو دققنا النظر، لرأينا أن الدولة عادت دائما في المناطق التي شهدت، في الماضي، وجود نماذج للدول القوية، كما في مصرالتي استقلت نسبيا بنفسها، على الرغم من الهيمنة العثمانية منذ دولة المماليك ثم دولة محمد علي التحديثية.
وعرفت تونس، منذ خير الدين، بداية تكوين نواة دولة حديثة أيضا، بينما تميز المغرب بسيطرة مديدة لأسرة ملكية جعلت من التجربة المخزنية منطلقا لبناء دولة مؤسسية. ولكن في معظم البلدان العربية الأخرى، وخصوصا في مصر والعراق وسورية، تعرّضت تجارب بناء الدولة الحديثة إلى امتحان كبير، وأحيانا إلى تدمير منظم، من قوى أجنبية استعمارية أو تسلطية، ومحت الحروب أو الكوارث آثار الدولة وروح السيادة وحكم القانون الذي يميّزها، كما حطمت روحها المؤسسية وبيرقراطيتها، وفتحت المجال أمام عودة حكم القبيلة والعشيرة والطائفة وشبكات المصالح الخاصة الذي لا يزال سائدا، من وراء هياكل الدولة الحديثة الشكلية. ولم يخف الأميركيون الذين خططوا لغزو العراق عام 2003 هدفهم في تحطيم دولته المركزية من أجل إعادته، كما جاء بالحرف على لسان أحد قادة الحرب، إلى عهد ما قبل الثورة الصناعية، وفي الحقيقة إلى عهد ما قبل الدولة أيضا.
تكاد النظرية السياسية تجمع على أن ترسخ جذور الدولة وتطور مؤسستها ارتبط في كل “لا تقوم سلطة مستقرة ودولة راسخة من دون اجتماع عاملي القوة والقانون” المناطق بظهور فكرة القانون الذي يشير إلى قواعد ثابتة في تنظيم علاقات البشر فيما بينهم، وبينهم والسلطة القائمة، يحرّرها، إلى حد أو آخر، من الخضوع لأهواء الحاكم أو إرادته المتقلبة أو لمزاجه الشخصي. وشكل اجتماعهما الشرط الأساسي لنشوء سلطة مركزية وبيرقراطية ثابتة ومستمرة عبر الزمن، ففي هذا الاجتماع اكتسبت القوة التي لا غنى عنها لتأسيس السلطة، وما يرتبط بها من ممارسة العنف، سمة الشرعية، كما اكتسب القانون صدقيّته نتيجة وجود قوة قادرة على تطبيقه.
وهكذا أصبح من الممكن التمييز بين السلطتين، الشرعية وغير الشرعية، والتعامل معها على حقيقتها، ومن ثم الخروج من فوضى استخدام القوة وعشوائيتها إلى نظام الدولة وقانون السياسية. لقد رسّخ نشوء القانون فكرة الدولة، بمقدار ما أعطى للسلطة التي تحتضنها رسالة أو وظيفة اجتماعية إيجابية، فلم يعد هدف السلطة خدمة السلطة ومراكمة القوة لتعظيمها وتوسيع دائرة سيطرتها، وإنما أصبح وجودها جزءا من مشروع اجتماعي مرتبط بغاية وأهداف وقيم ومبادئ أخلاقية، فتحولت قوة الغزو من مشروعٍ للنهب والسلب إلى قوة عمران وإعمار بشري، أي تأسيس جماعة سياسية مستقرّة، فأعيد تأهيل القوة، وتبدل دورها، وصارت قوة سياسية تؤسس شرعيتها على ما تنشئه من سلام وتفاهم وتعاون بين أفراد الجماعة، وما تؤمنه من وسائل الدفاع عن استقلال هذه الجماعة ومصالحها ضد الغزوات والاعتداءات الخارجية.
وكان من الطبيعي أن يساهم ذلك في تعزيز الاستقرار، ومن ورائه ازدهار أحوال المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، وتطور شروط المدنية. لا تقوم سلطة مستقرة ودولة راسخة من دون اجتماع عاملي القوة والقانون، فالقوة من دون قانون تصبح قانون ذاتها، وتفرض مبدأ الحق للأقوى، وهذا ما شاع التعبير عنه بعبارة قانون الغاب الذي يحكم فيه القوي الضعيف من دون توسط ولا حدود. وهو ما ينفي وجود الدولة والجماعة السياسية بالتعريف.
وإذا طبق في إطار دولةٍ قائمةٍ فسيكون لا محالة من أهم أسباب تقويضها ونشر الفوضى وإطلاق حرب الجميع ضد الجميع، والتسابق على استخدام العنف لفرض إرادة الأفراد بعضهم على بعض، فالقانون الذي لا يملك القوة التي تحمي تطبيقه يتحول إلى كلماتٍ فارغة من المعنى، تماما كما هي فارغة من المعنى الدساتير التي تضعها لنفسها الحكومات الاستبدادية، والتي تعدّلها كما تشاء وتخرقها بانتظام، ولا تعيرها أدنى اهتمام.
والقانون المفروض بالقوة كما يحصل عادة في بلادنا هو تجسيد لمبدأ القوة والإكراه، وليس فيه شيء من معنى القانون وروحه. ولهذا السبب، ارتبط نشوء النظم الديمقراطية بالثورات الشعبية بمقدار ما قادت هذه الثورات إلى ايجاد قوة موازية، أو موازنة لقوة الطبقة الحاكمة، وفتحت ساحة السياسة والصراع بين القوى على أسس ومبادئ فرضتها توازنات القوة.
وهذا هو السياق الذي نشأت فيه الحريات الفردية والجماعية، حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، التي تجسّد الاعتراف بوجود الشعب بوصفه قوة سياسية. وهو أيضا السياق الذي ألهم الفكر الديمقراطي مبدأ فصل السلطات الذي يهدف إلى منع فريق واحد من احتكار السلطة، حتى في إطار جمهوريةٍ حرةٍ يشكل فيها الشعب قوة منظمة وقادرة على التدخل في الحياة السياسية في أي وقت.
حكم القوة والحكم بالقوة، سواء بفرض القانون من فوق، أو تزوير إرادة الشعب، أو تعطيل العمل بالقانون، كما تشير حالة الطوارئ، يعني ببساطة إلغاء السياسة، ومن ورائها إلغاء المجتمع المدني/ السياسي نفسه، والعودة إلى ما قبل السياسة والدولة في تنظيم العلاقات المجتمعية. ما يجمع بين النظم العربية التي تعرّضت، جميعها تقريبا، لموجات من الاحتجاج والتمرد “القوة من دون قانون تصبح قانون ذاتها، وتفرض مبدأ الحق للأقوى” الشعبيين منذ الخمسينيات، والتي تواجه، منذ بداية العقد الراهن، موجة جديدة من الثورات المتأججة، هو أنها نظم سلطة تستند في وجودها إلى القوة، وتفتقر إلى مرجعية قانونية ثابتة ومحترمة، حتى من الحكومات التي وضعتها.
والحال لا تصبح القوانين مطاعةً ومحترمةً إلا إذا انبثقت عن موافقة شعبية، كما هو الوضع في الدول الحديثة، أو إذا ارتبطت باعتقاداتٍ دينية شائعة وسائدة، كما كان عليه الوضع في السلطنات والامبرطوريات التي عرفتها الحقب التاريخية السابقة.
ولعل في عنصر من عناصر تفسير التعلق المتجدّد في مجتمعاتنا التي اعتقدت أنها تجاوزت الحقبة التي كانت السلطة فيها تستمد شرعيتها من المقدّس، الملكي أو الديني، بالشريعة الدينية بوصفها قانونا بديلا يمكن أن يضع حدا لانفلات حكم القوة، ففي غياب القانون المعبر، بشكل أو آخر، عن إرادةٍ حرّة أو قبول عام، يضمن التزام الأفراد، أو أغلبيتهم، بقواعده والخضوع لسلطته، لا يبقى هناك ناظم آخر لعلاقات الأفراد فيما بينهم ومع الدولة سوى العنف وعلاقة القوة أو توازن القوى.
ولا ينبغي أن نخدع بالنظام الظاهر الذي يفرضه حكم القوة، فوراء السلام الشكلي الذي يظهر على السطح تجري في هذا النمط من المجتمعات حرب خفيةٌ ودائمةٌ في الأعماق، بوسائل استثنائية أو ملتوية، فكما يصبح الاحتيال على القانون وخداع السلطة والفساد فنا قائما بذاته، وسياسة عامة للدفاع عما يبدو للأفراد مصالح خاصة شرعية، لا تجد الدولة سبيلا لإخفاء الوجه القبيح للقوة إلا بالاحتيال المقابل الذي يسعى إلى التعويض عن غياب الشرعية في النظام من خلال التعظيم الكاذب لشخص الحاكم ووسمه بالعبقرية والاستثنائية بل بالعصمة والقدسية، فيصبح بشخصه هو الضامن للاستقرار والسلم الأهلي المعرّض في كل وقت للانهيار.
ولكن على الرغم من هذا الخداع المتبادل للذات والآخر، لا يستطيع أحد أن يخفي أن ما يسود بالفعل هو الفوضى الناجمة عن صراع القوة وغياب القانون. فشل العرب عموما في بناء الدولة وإرساء نظم سياسية قانونية مستقرة يساعد ربما في فهم ما “نظمنا العربية هي نظم سلطة تستند في وجودها إلى القوة، وتفتقر إلى مرجعية قانونية ثابتة ومحترمة” جرى في المواجهة التاريخية التي شهدتها المجتمعات العربية في العشرية الماضية، والتي وضعت وجها لوجه نظم حكم منحطّة سياسيا وقانونيا وأخلاقيا، بالمعنى الحرفي للكلمة، وشعوبا مزعزعة الاستقرار، قلقة ومتوترة وخائفة على مصيرها من مستقبل مظلم، والحالة الصعبة من الفراغ والانتظار التي تعيشها شعوبٌ تجد نفسها اليوم معلقةً في الفراغ، لا تستطيع أن تعود إلى الوراء، بعد أن انهارت مقومات النظم الاستبدادية، المادية والمعنوية، ولا تزال تفتقر للقدرة على التقدم إلى الأمام، بعد أن اغتالت الثورات المضادّة حلمها التاريخي بإقامة نظم جديدة تتيح لها التأثير في القرار، وتفتح لها أفق المستقبل. ومهما كان الحال، لن تجد الدولة، في نظري، مكانها وتستقر في بلادنا قبل أن ننجح، كما صاغها أحد أبرز الوجوه المثقفة السورية، أنطون مقدسي، في رسالته المفتوحة إلى بشار الأسد، محذّرا، عام 2001، الانتقال من “حكم البداوة والعشيرة إلى حكم القانون”.






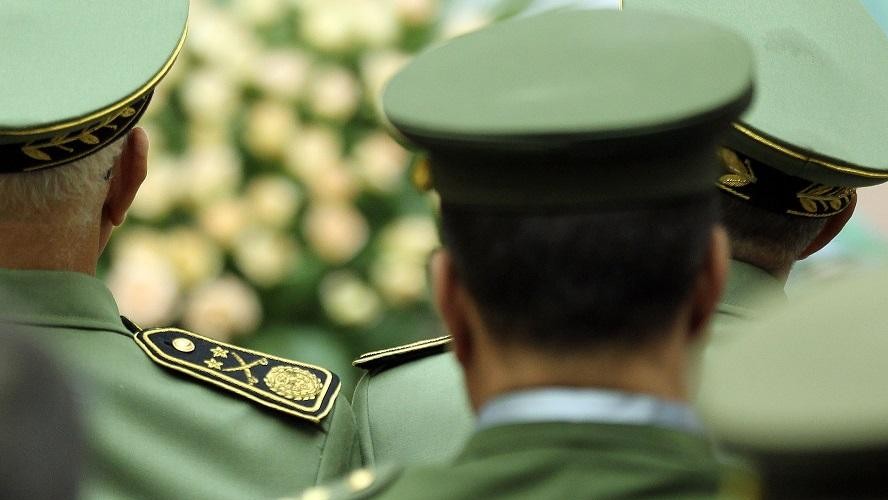








تعليقات الزوار ( 0 )