في خضم هذا اللغط الذي سرى مؤخرا إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية حول تطور ملف صحرائنا المغربية، وتزامن الاعتراف الأمريكي بحقوق المغرب في صحرائه مع اعتراف المغرب بإعادة ربط الاتصال مع الكيان الإسرائيلي (الذي يؤكد التاريخ المعاصر أنه استعمر أرض فلسطين بالقوة و قتّل و هجّر أهلها منذ اثنتين وسبعين سنة) مع فتح أبواب المغرب مشرّعة للتعاون أكثر مع ذلك الكيان في مختلف المجالات.
وبعيداً عن التجييش الذي قام به الإعلام الرسمي لتمجيد الاتفاق المغربي الإسرائيلي الأمريكي يوم 22/12/2020 واللّعب على قيمة التعايش أو التسامح لإقناع الرأي العام المغربي بصواب ما تمّ اتخاذه في هذا المجال من “قرارات سيادية” تخص إشكالية الاعتراف الرسمي والعلني بـ “دولة إسرائيل”؛ نودّ من جهتنا كمفكرين ومتابعين لهذا الحدث ومستشرفين لأبعاده، ومتجاوزين أيضاً تقييم المسؤولية الأخلاقية المباشرة “للانقسام الفلسطيني” العبثي في تفسير وتبرير هذه الهرولات نحو “التطبيع” مع ذلك الكيان؛ نودّ أن ننأى بأنفسنا عن كل ذلك اللّغط ونتجاوز الجدل حول طبيعة ذلك الاعتراف متعدد الأطراف، أصُدفةً هو أم مقصود، أقديما هو أم حديث، محاولين بخلاف كل ذلك وضع النقط على الحروف ومعالجة المشكل المطروح من أساسه، مبدين ملاحظات أوّلية تخصّ جوهر التبرير الذي طرحه كل أنصار الاعتراف أو ما سموه “بالتطبيع” في العالم العربي بالأمس واليوم، و الذين أقدموا على مثل هذه الخطوة ذات الآثار السياسية القريبة، ولكنها أيضاً ذات آثار فكرية وأخلاقية وتربوية وتعليمية بعيدة وعميقة ![1]
أولا: لنمتحن في البداية ذلك التبرير الرسمي لإقدام المغرب على قبول الاعتراف أو التطبيع، ومفاد هذا التبرير المذكور أن ذلك الاعتراف من جانب المغرب سوف يوظّف لصالح القضية الفلسطينية، إذ أنه سيمكّن المغرب من بذل محاولاته لحمل الإسرائيليين على قبول الحلّ القائم على إنشاء دولتين والاعتراف بحدود سنة 1967 و القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، بل إن باقي الدول العربية سوف تعتمد على المغرب تحديداً في الاضطلاع بمهمة الدفع بالقضية الفلسطينية نحو الحل النهائي… واعتقادنا الجازم أن هذا التبرير واهٍ من جهات ثلاث:
1- أولها أن من جملة المرشحين للقيام بهذه المهام لصالح الشعب الفلسطيني الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي المغربي الحالي، و هو حزب “العدالة والتنمية” الممثَّل في رئيس الحكومة؛ لكن كيف لهذا الأخير أن يضطلع بمهام التخابر والتواصل مع الجانب الإسرائيلي بهدف التأثير عليه و لمّا تمضي عليه إلا بضعة أشهر وهو يُشهد الملأ أن الاعتراف والتطبيع مع إسرائيل خيانة عظمى وخط أحمر؟ فكيف سيوفق يا ترى بين موقفه المبدئي هذا وموقفه الجديد؟ وهل ستمكنه وقفته الأخيرة هذه في “منزلة بين المنزلتين” لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، من لعب دور ما لصالح القضية الفلسطينية؟ وإذا كانت القضية الفلسطينية لدى المغاربة، بحسب تبريراته الأخيرة، هي بمنزلة الصحراء المغربية، وأن قضية الصحراء حسب تعبيره “كانت شوكة في رجل المغرب” وأننا بعد أن نزعنا تلك الشوكة سوف نتمكن من الدفاع بشكل أفضل عن القضية الفلسطينية… إنها وعود جميلة، إلا أن صاحبها ينسى أو يتناسى أن رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي لم ينتظر إلا ساعات قليلة بعد تطبيعه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ليفنّد بقوة وبكل وضوح ادعاء وزير خارجية الإمارات بكون التطبيع من شأنه أن يؤدي على الأقل إلى إيقاف توسيع كتلة المستوطنات الصهيونية في الأراضي المحتلة… فكيف يمنّينا السيد العثماني بما هو أهم من إيقاف المستوطنات وهو إلغاء وإيقاف ما عرف “بصفقة القرن” وإنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة؟.
2- من جهة ثانية، نحن نعلم أن المغرب حتى لو لم تكن لديه علاقة رسمية مع الكيان الإسرائيلي، فقد كانت اتصالاته به، مع ذلك، مستمرة ولقاءات رجاله مع الإسرائيليين قائمة، سواء فوق أرض المغرب أو في أماكن أخرى من العالم؛ فماذا جنت القضية الفلسطينية من تدخلات وحوارات وضغوطات المغرب القديمة مع الإسرائيليين؟ وماذا جنى المسجد الأقصى خاصة من ذلك، والحفريات الإسرائيلية من تحته لا تتوقف و تكاد تنسفه من قواعده؟ أما إذا كان الهدف من هذا “الاعتراف” هو اغتنامه وتوظيفه للضغط على “إسرائيل” وإرغامها على احترام وعودها والتزاماتها الدولية، فليعلم الجميع أن “المنطق” الإسرائيلي الثابت قائم على أساس أن ليس هناك تواريخ مقدسة ولا وعود ملزمة ! وأن الاستمرار في التوسع الصهيوني عقيدة ثابتة ومستمرة في الزمان والمكان؛ ومن يشكك في ذلك فليتابع مصير “خطة التقسيم الأممية” سنة 1948 والتي وهبت 55% من أرض فلسطين للأقلية اليهودية الغازية المهاجرة، و45% من فلسطين للأغلبية العربية؛ إذ سرعان ما أسقطت “إسرائيل” هذا التقسيم بعد حرب سنة 1948 فأصبحت 78% من فلسطين لليهود و 22% للفلسطينيين ! وبمجيء نكبة 1967 توسع النفوذ الإسرائيلي ليشمل الضفة الغربية وغزة والجولان؛ ومباشرة بعد أن عقدت إسرائيل “سلاماً” مع مصر صوّت الكنيست الإسرائيلي نهائياً على قرار بضم القدس الشرقية لإسرائيل؛ واليوم يلوّح رئيس حكومة هذا الكيان الإسرائيلي بضرورة الإسراع بضم “غور الأردن”. دون أن نتحدث في خضم كل هذا التمدّد الجغرافي عن سرطان انتشار المستوطنات التي تنبت بين الفلسطينيين كما ينبت الفطر… الأمر الذي يعني أن حدود دولة هذا الكيان الإسرائيلي كما قال مجرمهم القديم ومحتل القدس والضفة، مُوشِي دَايان، “هي حيث يضع آخر جندي إسرائيلي قدمه” ! بما يعني أن عقيدة الكيان الإسرائيلي قائمة دائماً على تكتيك “التوسع المستمر” والدائم و سحق الآخر المخالف… ولست أدري بعد كل هذا ما هو ردّ فعل الدول العربية المتفاخرة بالهرولة إلى الاعتراف بإسرائيل والمتشبثة في نفس الآن “بالمبادرة العربية للسلام”، ما هو رد فعلها من إصرار إسرائيل على القول أن المبادرة العربية المذكورة “لا تساوي الحبر الذي كتبت به” !!
3- من جهة ثالثة لو كان مجرد الاعتراف العلني بالكيان الإسرائيلي وإقامة علاقات “شرعية” معه كفيلان بإفادة القضية الفلسطينية، لكانت دولة مصر أولى من غيرها أن توظف ذلك الاعتراف وهذه العلاقات لصالح الفلسطينيين، بينما المشاهد أن إسرائيل لا يزيدها الاعتراف إلا غطرسة وظلما، ولا أذل على ذلك من المآلات الهزيلة والكارثية التي أعقبت كل الاتفاقيات التي أُبرمت بين مصر و”إسرائيل” والتي تمت تحت رعاية
ومباركة الأمم المتحدة! وهاهي آخر مآلات تلك الاتفاقيات والمتمثلة فيما بات يعرف “بصفقة القرن” ! فهي بالفعل “صفقة تجارية” للإقبار النهائي للدولة الفلسطينية والبدء بمرحلة جديدة ينتظرها متطرفو ومعتدلو الإسرائيليين على السواء، إنها حلم تحقيق “إسرائيل الكبرى” من النهر إلى النهر، وهو الشعار المكتوب إلى الآن على باب الكنيست الإسرائيلي، والذي يعدّون له عبر مراحل و يأملون تحقيقه ولو بعد ألف عام ! ذلك هو سلاح إسرائيل الأكبر، سلاح الزمن الكفيل بتغيير القيم و طمس التاريخ ومحو ذاكرة فلسطين من الوجود… !
وأخيرا، مهما يكن من أمر تلك القيمة التي يراد إضفاؤها على “إيمان” الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بمغربية الصحراء، فالذي نخشاه أي يكون إيمانه هذا “كإيمان فرعون” لا ينفعنا ولا ينفع صاحبه، لكونه إيماناً أتى متأخرا وقصده أن يكون المغرب “آخر عنقود” يقطفه لصالح الكيان الإسرائيلي. وقد دلت مواقف سابقة لهذا الرئيس “آمن” فيها بأشياء وسجلها في مراسيم، ولكن المجتمع الدولي نقضها من الأساس، كإيمانه وتصديقه بشرعية المستوطنات اليهودية و كإيمانه بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل وكإيمانه بحق إسرائيل في ضم الجولان السوري… فما الضامن أن يكون الإيمان الأخير لهذا الرئيس من جنس إيماناته هذه؟ !
أما إذا كان الموقف الأمريكي الأخير من الصحراء المغربية لا يخرج في جوهره عن قرارات مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، تلك القرارات التي تتبنى المشروع المغربي حول الحكم الذاتي لهذا الإقليم؛ فما الحاجة إذن إلى إقران ذلك الإعلان الأمريكي حول الصحراء المغربية بالاعتراف أو التطبيع مع إسرائيل، خاصة وهو تطبيع يندرج بالضرورة، وبحسب منطق توالي الأحداث، ضمن “الجوقة الخليجية” الأخيرة التي هرولت بشكل مجاني للارتماء في أحضان إسرائيل طلبا لرضاها دون قيد ولا شرط؟ ! ولا شك أن الكيان الإسرائيلي قد وجد في الموقف المغربي الأخير بلسما خفف من الصدمة الذي تلقاها مؤخرا في اجتماع المنامة في البحرين من المسؤول السابق في المخابرات السعودية الأمير تركي الفيصل الذي أظهر في ذلك الاجتماع الرسمي والعلني الوجه الحقيقي لإسرائيل “كقوة استعمارية غربية” حسب قوله ونبهها إلى أنه لا سلام ممكن خارج المبادرة العربية المعروفة والتي سبق لإسرائيل أن اعتبرتها أنها لا تساوي الحبر الذي كتبت به… ! وها هي دولة الكويت، لا شك أنها مدينة بالشيء الكثير لأمريكا و تجثم فوق أراضيها أو قريبا منها أكبر قاعدة عسكرية أمريكية بالخليج، ومع ذلك يقف الشعب الكويتي وتقف مؤسساته التشريعية سدا منيعا ضد التطبيع المجاني مع الدولة العبرية باعتبارها كيانا غاصبا، وأن كل محاولة لتناسي طبيعته هذه تعتبر خيانة وطنية…
ثانيا: لكن لنضع نحن، مؤقتا، كل هذه المعطيات وتلك التداعيات والاعتبارات والتأويلات السياسية، المقبولة أو المرفوضة، ولنعد بصفتنا كمفكرين لطرح الإشكال من أساسه الذي يدندن حوله المهرولون السائرون على خطى الجوقة الخليجية الرائدة في هذا المجال، ألا وهو “إشكالية الاعتراف” بالآخر كقيمة أخلاقية ومطلب عملي إنساني:وإذا كان المقام لا يسمح لنا هنا أن نفصل القول في تلك “الأصول الثقافية” التي ينهال منها الفكر اليهودي المعاصر عامة والفكر الصهيوني الإسرائيلي خاصة، تلك الأصول التي يحاول هذا الفكر دون كلل ترجمتها إلى الواقع كي يكون كيانا يهوديا خالصا، لا حقوق مساوية فيه “للأغيار” وهي الأصول التي قمنا بتشريحها في بحث مستقل لنا … في انتظار نشر ذلك التفصيل نبادر اليوم بالتأكيد إلى أننا إذا ما تعمدنا إدراج مثل هذه القضايا السياسية والعملية ضمن مشكلة القيم فذلك لكون الحديث عن القيم هو حديث عن أخص خصائص الوجود الإنساني، فالإنسان كائن “أخلاقي” بقدر ما هو “كائن اجتماعي”؛ و لا قيام للأخلاق بمعزل عن “قيم مشتركة” تسمح بالتواصل مثلما تسمح بالاعتراف المتبادل. لكن “الاعتراف” بالآخر في حد ذاته ليس مجرد قرار سياسي ! وإنما هو بالأساس “فعل وجودي” (ontologique) بكل ما في الكلمة من معنى فلسفي ودلالة إنسانية؛ اعتبارا لكون “الآخر” الذي هو موضوع الاعتراف يمثل عنصرا أساسا لإثبات الذات ككائن في العالم؛ فلولا ذلك الآخر لما أمكنني أن أثبت ذاتي أمامه كذات نظيرة له ومختلفة عنه في نفس الآن ! من ثم صار هذا الآخر المختلف والنظير كذلك عنصرا ومكونا أساسا من مكونات وجودي الخاص…
1 – وحيث ذلك، وبسبب هذه العلاقة الجدلية بين مفهوم الذات ومفهوم النظير كانت العلاقة بين الطرفين تحقق على المستوى الوجودي قيمة الاعتراف، مثلما تحقق على المستوى العملي والأخلاقي فعل التعارف؛ فالاعتراف مؤدي إلى التعارف وسبيل ضروري إليه، مثلما أن التعارف هو أيضا فعل متبادل بين ذاتين، يتم من خلاله تبادل الخبرات و التجارب، ولكن قبل ذلك يتم تبادل شبكة من المعارف والقيم المشتركة التي تسمح بشرعية التبادل وتسهل ذلك التعارف. وفي ضوء هذا يجب القول إن الاعتراف إذا كان يتضمن الإقرار بحق الاختلاف بين الطرفين، فإنه يتضمن بذات الوقت الإقرار بوجود قيم مشتركة بينهما، من حيث أن الاعتراف هو من الناحية الأخلاقية أو السياسية، هو في آخر التحليل، اعتراف “بإنسانية” ذلك الإنسان المخالف، لا بمجرد وجود جسده البشري؛ بل يجب أن ينصب الاعتراف على ما يشكل جوهر إنسانية الإنسان المتمثلة فيما يحمله من “قيم مشتركة” تصير هي ذاته موضوعا “للتعارف” وسببا “للتفاهم” ودافعا “للتبادل”. ومن ثم كانت تلك القيم المشتركة هي التي تسمح بالتواصل و يلتزم الطرفان باحترامها.
هكذا نستطيع أن نستخلص أن فلسفة الاعتراف بالآخر تقتضي ضرورة إضفاء الشرعية على وجوده، وعلى قيمه ومبادئه التي يعيش عليها ويلقنها لأبنائه، واعتراف بالحاجة إليه ووجوب التعاون معه. وذلك يترجم عمليا على المستوى السياسي وفي العلاقة بين المجتمعات والشعوب والدول، التي بقدر تمسكها بحدودها وخصوصياتها الثقافية والاجتماعية، تتشوف في نفس الآن إلى ضرورة ربط علاقات بينها وبين غيرها من الشعوب والدول طلبا للتعارف والتعاون؛ غير أنه لا سبيل لإقامة هذا الأمر الأخير إلا عبر إيجاد قاسم مشترك ليس فحسب من المصالح المادية و لكن قبل ذلك لابد من إيجاد أرضية مشتركة من المفاهيم و القيم الإنسانية التي يتم اعتمادها كمراجع أو ضوابط لإقامة تلك العلاقات بين الدول والشعوب والأمم بهدف ضمان احترام الحياة وتحقيق السلام بين الناس وحمايتهم من كل اعتداء وتحقيق العدل والإنصاف…
2- غير أننا نلاحظ أن هذا العدل والإنصاف وباقي القيم المطلوب احترامها وتنزيلها على أرض واقع الناس، تصطدم اليوم بعودة تفعيل تلك القيم “الإبراهيمية” في سفر التكوين على أرض فلسطين، خاصة بعد قيام كيان إسرائيلي فوقها خطط مسبقا لطرد أحفاد الكنعانيين منها، ويدبر اليوم لمنع عودة من هُجر منهم من أرضه ضدا على كل القيم الإنسانية.
3- والسؤال المهم بالنسبة إلينا اليوم: كيف يجوز الاعتراف “بشرعية” دولة لا تشاركنا قيمنا الإنسانية؟ إذ هي تؤمن بشرعية اغتصاب أرض الأغيار ولا تقيم وزنا لحياة الآخرين المطرودين، فضلا أن تقيم وزنا لحياة نفس واحدة ! بل كيف يجوز لنا أخلاقيا أن نعترف بقيم تلك “الدولة” وقد عرفنا أصولها التوراثية، وهي قيم دينية وأخلاقية وسياسية قائمة على “فلسفة عنصرية” لا تقيم وزنا لما هو “مشترك” بين الناس من قيم.
لقد أصبحت عنصرية الكيان الإسرائيلي واضحة للعيان اليوم؛ فالأديولوجية الصهيونية التي طالما أراد هذا الكيان نفيها عن نفسه صارت أكثر بروزا، سواء في مشاريع توسيع كتلة “الاستيطان” الذي هو أبشع مظاهر الاستعمار أو في الحرب الإبادية التي يخوضها ذلك الكيان أو في القوانين التي يشرعها فوق كل أرض فلسطين، وآخرها مشروع “يهودية” دولة إسرائيل و قرينه “صفقة القرن” وهو مشروع يكفي لوحده أن يمنع العالم من الاعتراف بهذا الكيان، لأنه بذاته يكرس نظاما عنصريا يعتبر “اليهودي” وحده من يملك الحقوق السياسية والاقتصادية كاملة، وغير اليهودي، إن وجد، يظل دوما محاصرا في انتظار سحقه و”تطهير” أرض إسرائيل منه ! [2] ولذا من حقنا أن نتساءل إذا كان هذا الكيان الذي زرع بالقوة فوق أرض فلسطين يتغذى بالفعل من قيم خاصة به نجدها محفورة في ذاكرته الدينية المعتمدة وتروج لها خصوصا بعض الأوساط النافذة فيه، كما نجد صداها مثلا في تلك “الفتوى” ذات النفحة التلمودية التي أوصت الجنود الصهاينة أثناء حرب غزة، الأخيرة قائلة: “لا تتركوا لهم طفلا ولا شجرا ولا حيوانا”[3] ! نقول متسائلين: هل يجوز “الاعتراف” بكيان، تلك هي أصول ثقافته وقيمه وهذه هي تجلياتها اليومية؟ ألا يؤدي بنا الاعتراف بهذا الكيان الذي لا يحترم القيم الإنسانية إلى خيانة هذه القيم؟ إن الاعتراف بهذا الواقع الظالم الذي فرضه ذلك الكيان معناه اعتراف بإمكانية تجدد نفس الظلم سواء من قبله أو من قبل غيره وإضفاء “الشرعية الأخلاقية” عليه و على أفعاله، وذلك هو عين العبث !
من جهتنا نحن المغاربة فإننا لا نقبل من أحد أن يلقننا “دروسا” في التسامح و التعايش، وليعلم الجميع أننا نحن الذين حمونا اليهود من الاضطهاد الكنسي في العصور الوسطى للغرب المسيحي، ونحن الذين شملناهم بحق المواطنة حينما تطاولت إليهم أيادي الفرنسيين النازيين، وأن للمغرب الفضل في أن صارت المرجعية الدينية اليهودية بالمغرب هي المرجعية المعتمدة لأغلب يهود العالم؛ فلم ننتظر نحن حتى سنة 1905 كما حصل في فرنسا حتى نُقرّ بالحقوق الطبيعية للجالية اليهودية ووجوب الالتزام بالتسامح والتعايش معها… ولذا لا معنى لتبرير التطورات السياسية لقضية فلسطين بتذكير المغاربة بقيم التسامح والتعايش كي يغضّوا الطرف عما ترتكبه “إسرائيل” من أعمال التهجير والقتل لأصحاب الأرض من الفلسطينيين، رجالا ونساء وأطفالا ورضعا كذلك… ومن ثم لا قيمة لاعتراض بعض قصيري النظر بما يبدو لهم أنه اعتراض أخلاقي معقول، و هو كوننا نرفض “حق” إسرائيل في الوجود؛ و إنه لاعتراض ساقط أخلاقيا أيضا، لكوننا نعلن دوما تشبثنا بمبدإ إنساني هو رفضنا للظلم بكل أشكاله ورفضنا لكل ما قد يترتب و يتأسس على ذلك الظلم؛ فالسارقمطالب بإرجاع ما سرقه لأصحابه قبل أن يطالبنا بالحفاظ على نفسه و إضفاء الشرعية على وجوده. و المستعمر الذي احتلنا و احتل أرضنا طالبناه بالرحيل عن أرضنا قبل أن نقيم معه علاقة شرعية… وماذا يمثل الكيان الإسرائيلي غير كونه فلولا ركبت ظهر الاستعمار فأنابها عنه وتمادت في تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وفي الاستمرار في تقتيله ومطاردته منذ ما يزيد عن السبعين سنة؟!
وعليه بات مؤكدا أن كل محاولة لإضفاء “الشرعية الأخلاقية والقانونية” على ذلك الكيان يلزم عنه إمكانية إضفاء نفس “الشرعية” على كل الأنظمة الفاسدة والكيانات الاستبدادية، بل إنها شرعية العودة إلى حقبة الاستعمار البائدة! فهل أضفينا نحن شرعية على حق الاستعمار الذي جثم على أرضنا أم ألزمناه بالعودة من حيث أتى كشرط لإقامة علاقة شرعية و قانونية وإنسانية معه؟
أخيرا ومهما تكن طبيعة وحقيقة “الحسابات الجيوسياسية” التي فرضت ربما على المغرب قبوله الاعتراف أو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فإن تلك الحسابات بحسب طبيعتها السياسية تلك، لا يمكن أن تكون إلا حسابات ظرفية ووقتية، قد تفرض على رجل السياسة تجاهلا مؤقتا لمبادئ كلية وقيم أخلاقية تابثة؛ في حين أن مهمة المفكر وبحكم عمله التنظيري ورؤيته الأخلاقية القائمة على احترام قيم إنسانية كلية، عليه أن يبرز دائما تلك القيم ويذكّر بها ويبعث الأمل في إمكانية تنزيلها وتحقيقها على أرض الواقع، مهما كانت هنالك من عراقيل تمنع من تصور تلك الإمكانية حالاً؛ وقد دلّنا التاريخ أنه كلما استطاع المجتمع الصبر على الأذى وعلى دفع الظلم الواقع به، فإن منطق التاريخ وقدره حتماً سيستجيب له، ولا بد أن ينجح يوما في تكسير القيود وإحقاق الحق. وتاريخ المغرب الطويل شاهد على مبلغ ما تعرض له من تقطيع لأوصاله من طرف الغزاة منذ القرن الخامس عشر الميلادي، وشاهد على طول الزمن الذي جثمت على صدر أبنائه فلول المعمرين… ومع ذلك ظل المغاربة يحلمون بوجوب تحرير أراضيهم كاملة حتى تحقق لهم ذلك “الحلم”. فهل نمنع الفلسطينيين أيضا من حقهم في مثل ذلك الحلم؟!
*مفكر مغربي
[1] جوهر مقالتنا هذه مستل من دراسة شاملة لنا حول جدلية العلاقة بين الثقافة الدينية التوراتية القديمة و الممارسات الإسرائيلية الحديثة، سيُنشر لاحقاً؛ و هي محاولة تلتقي و تتقاطع مع الدراسة الممتازة للمفكر الإسرائيلي ISRAEL SHAHAK : Histoire Juive, Religion Juive, le poids des trois millénaires.
[2] ترجمة النشيد الإسرائيلي “الوطني”
[3] و ليس غريبا بعد هذا أن تقدم مجموعة من المستوطنين الصهاينة بتاريخ 31.7.2015 على حرق الطفل الفلسطيني الرضيع (علي دوابشة) لم يتجاوز عمره السنة و النصف داخل منزل والده ب”نابلس”…





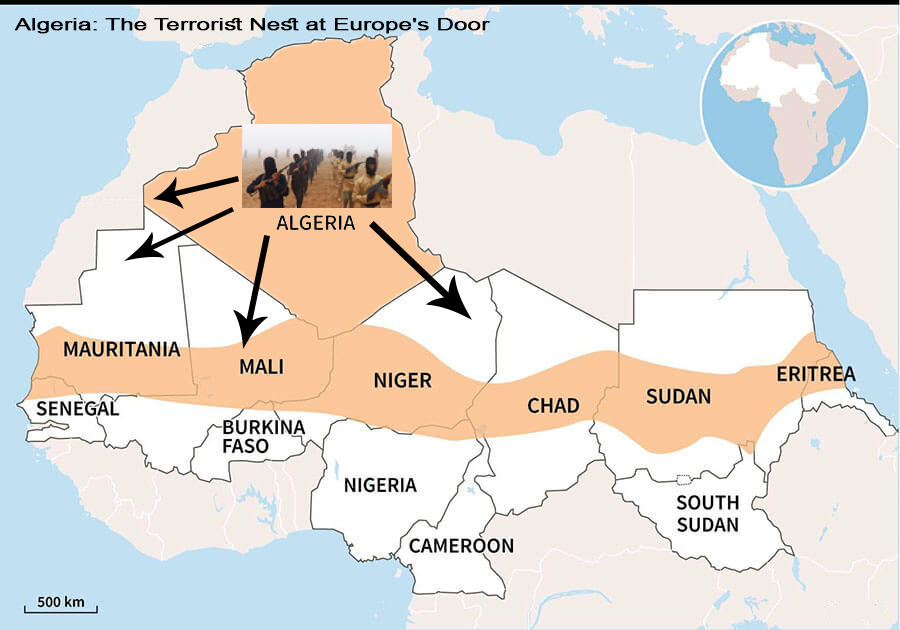









موقف شجاع في زمن قل فيه الشجعان…